مشاهدُ مثيرة في رواية الحياة
استهلال:
من الغبن الظنّ أنّ الرقصَ من علامات الفرح فقط، وإن كان قد ارتبط عبر الممارسة والتراكم، بالفرح واللهو والمجون، ذلك أنّ الرقص كالطرب تماماً، يمكن أن يدلّ على الفرح والبهجة واللذّة، كما يمكن أن يعبّر عن الحزن والأسى والقهر، ولأنّه متعدّي المفعول، متناقض التأثير، مشتمل على العتمة والضياء، على السواد والبياض معاً، فإنّه يحظى باهتمام خاصّ من قبل الأدباء والفنّانين، كما من قبل المتصوّفة والمتديّنين، وإن كان ذلك تحت مسمّيات وتبويبات متباينة..
وليس من باب المصادفة أن تغدو أسماء بعض الرقصات الشهيرة هويّات بارزة وعلامات فارقة لبعض الدول في المحافل الدوليّة، وفي مناسبات كبرى، كالإشارة إلى المنتخب الأرجنتينيّ بمنتخب التانغو، في إشارة إلى الرقصة الشهيرة في الأرجنتين، وتعريف المنتخب البرازيليّ بمنتخب السامبا، والإسبانيّ بالفلامنغو.. في مثل هذه الحالات يتقدّم الرقص ليفرض هويّته على الدول، ويتقدّم على أهمّ الصناعات وأعرق المدن وأعظم التواريخ..
حين كتب المفكّر الراحل إدوارد سعيد مقاله عن الراقصة الشهيرة تحية كاريوكا، بعد أن قابلها في القاهرة 1989، تباينت المواقف والرؤى حيال ذلك، استهجن البعض أن يكتب مفكّر بثقل وحجم إدوارد سعيد عن راقصة شعبية مثل تحية كاريوكا، لا دور لها في الثقافة. صنّف آخرون اهتمام سعيد بالإرضاء، وهو البعيد عن ذلك البعد كلّه. لكنّ إدوارد سعيد كان يعلم ويدرك أبعاد الدور الحقيقيّ الذي تقوم به راقصة شهيرة، وما يمكن أن تقوم به، وقال بأنّه يكتب عن رمز من رموز الفنّ والتسلية الشعبية التي كان لها دور في الحياة الفنية العربيّة، إذ أنّه ركّز من خلال تأكيده على لغة الجسد على أنّ للجسد المغوي سطوة، وسلطة، لا تقلّ عن أيّة سلطة أحياناً، ولاسيّما بعد معرفة التأثير الذي كانت تخلّفه رقصات تحيّة كاريوكا في النفوس، وتشعّب دورها من مسرح الرقص إلى مسرح الحياة، ولم يكن اهتمام سعيد الصادم براقصة شرقيّة وليد مصادفة، لأنّه كان من مُعجبيها في مراهقته، ولأنّ الرقص الشرقيّ يعدّ وسيلة ذات مفعول مزدوج، من الوسائل التي يمكن النيل بها من الشرق وتقزيمه، أو من الوسائل التي يمكن عبرها تعظيم الشرق، وذلك عندما ينظر إليه على أنّه وسيلة للترفيه فقط، لا يمتّ إلى الفنّ بصلة، ولا يشكّل إرثاً حضاريّاً، يمكن الاستفادة منه..
الرقص فاصل روائيّ وحياتيّ منشّط:
الرقصّ مفتاح من مفاتيح المتعة الروائيّة، سرّ من أسرار الفنّ الروائيّ؛ سرّ مضمونيّ مستبطن، عنصر وآليّة، شكل ومضمون، مغرٍ مستفزّ، ينير الدواخل باشتغاله على الحركة، يروم الهدوء في بحر الصخب. وبقدر ما يشكّل الرقص مبعث بهجة ومتعة وغواية وإلهام، فإنّه قد يشكّل شرارة للرواية..
ركّز الروائيّ الشهير نيكوس كازنتزاكيس في روايته البديعة ذائعة الصيت «زوربا»1، على الرقص باعتباره محوراً بارزاً من محاور الحياة، كانت شخصيّته الاستثنائيّة زوربا تلوذ بالرقص في الحالات كلّها، وقد برع الفنّان أنطوني كوين بتجسيد دوره في الفيلم الذي حمل الاسم نفسه، وظلّ من العلامات الفارقة في تاريخه. وقد ظهر روائيّون كثر، حاولوا محاكاة كازنتزاكيس في روايته «زوربا»، عنونوا رواياتهم بعناوين قريبة، أو ضمّنوا أعمالهم تقاطعات وتناصّات مع زوربا، الرابط فيما بينها ارتكازها واشتغالها على الرقص. أو استعملوا كلمة الرقص، أو رقص، بطريقة مباشرة، منكّرة أو مضافة أو مكرّرة.. كهاروكي موراكامي في روايته «رقص.. رقص.. رقص»، أو ميلان كونديرا في «رقصة الوداع»، أو معجب الزهراني في «رقص»..
وممّن قارب الرقص بطريقة مختلفة، الروائيّ الإسبانيّ آنطونيو صولير الذي حاول إلغاء الفواصل بين الواقعيّ والمتخيَّل، يدمجهما معاً ليبتدع حياة روائيّة تكون مزيجاً منهما معاً، في روايته «موت الراقصات»2، يحكي راويه عن رحلة أخيه رامون الطويلة من البلدة النائية إلى مدينة برشلونة ليعمل في ملهى ليليّ أبهره، إذ عمل راقصاً غفلاً من الاسم في البداية، ثمّ بعد ظروف وتطوّرات معيّنة، يترقّى إلى مغنٍّ في الملهى نفسه، يتعرّف إلى أناس كثيرين، يغيّر اسمه، يختار اسماً فنّيّاً كغيره من العاملين في الملهى، لأنّه يكتشف أنّ لكلّ منهم اسماً آخر وهويّة أخرى غير تلك التي يتعاملون ويشتهرون بها، لأنّ عالم الملهى الصاخب الغريب يفرض عليهم الانقسام ليكون بمقدورهم المواءمة بين حياتهم الخاصّة وحياتهم في الملهى. يكون هناك عالم متخيَّل منشود، وآخر حقيقيّ مرعب بقدر جاذبيّته الممغنطة لا مفرّ من التكيّف معه. عالم مُفترَض وآخر مفروض.
يتحدّث صولير عن موت الراقصات في الملهى، وعن مظاهر الحداد المصاحبة. يروي قصّة ميتتين على المسرح، إحداهما للراقصة ليلي التي قتلها عاشقها البائس كوسمه بعد انقطاع الأمل والرجاء منها. وكيف كان موتها مُمسرحاً ومخرجاً بصيغة دراميّة رائعة، حتّى بدا كأنّه كان مدبّراً ومدروساً لزيادة جرعة التسلية والمتعة. ثمّ عن ميتة الراقصة كومبادوس التي كانت تتجرّع الكثير من الأدوية التي تكفّلت بقتلها بالتراكم. سمّمتها الحبوب التي عكست تسميمها المتتالي لقلوب عشّاقها حين كانت في أوج فتنتها. ذاك الموت الذي كان يتحوّل إلى ولادة جديدة كلّ مرّة، وكان من شأنه أن ينعش العمل، حيث كان يدفع الكثير من الزبائن إلى التردّد على الملهى لذيوع صيته، واشتهاره براقصاته اللاتي يمتن على المسرح. كان الموت يجلب فرحاً صاخباً ونشاطاً فائضاً إلى الملهى، لأنّ الناس في برشلونة كان يحكون أنّ الراقصات في ذاك الملهى يمتن على خشبة المسرح. أصبح الناس يقصدون الملهى، لا يلتفتون إلى الرقص بل ينتظرون دائماً موت أحد ما. كما أنّ موت الراقصة منح فرصة الظهور كمغنٍّ لرامون الذي سمّاه صديقه المصوّر باسم كارلوس دي ريّو.
لا يحصر الحديث عن الموت البيولوجيّ فقط، بل نراه يسهب في الحديث عن الموت الداخليّ، حين تموت المشاعر والأحاسيس، ويفقد المرء أيّ أمل بالحياة، ذاك التموّت البطيء الذي يعكس وجهاً من وجوه المازوشيّة عبر جلد الذات وتأنيبها على ما أتته وما لم تؤته. ومن أولئك الذين ماتت فيهم نزعة الحياة، بعد أن غافلتهم السعادة وهربت منهم إثر استئثار رغبات محدّدة أو استحواذ أشخاص بعينهم على كيانهم كلّه، يحضر كيد باديّا الذي يسبيه حلمه بالملاكمة، والذي يوجب المقارنة بين حلبة الملاكمة وما يتناهبها من صراع واقتتال وتلاكم وحركات راقصة، والمسرح وما يجري فيه من رقصات ومؤامرات وتمثيليّات. الكلّ يلاكم ويصارع ويرقص بطريقة أو أخرى. كما يحضر المصوّر روبيرا الذي يجبَر على ترك الملهى الذي أمضى فيه الشطر الأكبر من عمره، ويبقى رهين عشقه للراقصة صوليداد التي تستولي عليه بجمالها اللامألوف، وصدّها الحقيقيّ غير المتكلّف، يكون روبيرا أحد ضحايا المسرح، أحد الموتى الأحياء، يعيد تركيب الصور الكثيرة التي التقطها عبر مسيرته الطويلة، ينال ممّن ألقوا به في طيّات الإهمال والنسيان، يجعلهم مسوخاً، يتسلّى بالتلاعب بصورهم وتشويهها. يقوّض الصور، ينتقم بتقويضه لها ممّن غدروا به وآذوه. يرقص على طريقته وفي وحشته الكئيبة المظلمة مذبوحاً من الألم.
لا يَعْنى آنطونيو صولير في روايته «موت الراقصات» بتقديم الموت فقط، بل يروي كيفيّة عيش الراقصات أيضاً، بالموازاة مع المحيطين بهنّ من عشّاق وسماسرة وحسّاد، ما يتناهب أجواءهنّ من غيرة قاتلة وحسد مميت. عن الأقنعة والضياع والهجرات والفراديس المزعومة والمستنقعات المبيدة.
أمّا الكرديّ لالش قاسو فيقدّم صوراً مختلفة للرقص في روايته «أيّام حسّو الثلاثة»3، منها صورة الدبّيك هوتو الذي يرأس حلقة الدبكة ويثير حميّة الدبّيكة، يهيج جنونهم، هوتو المهمّش من جهة دوره في الحياة، يغدو الأوّلَ الفعّال برقصه الفريد، يتزعّم جماعة الراقصين ويبدع في حركاته الباعثة على الفرح والحميّة، وهو يعمل راقصاً في درْسه القمح في حين يسعد القرويّون لمرآه.. ومن صور الرقص الأخرى الواردة عند قاسو، تصويره للكيفيّة التي يعلّم بها العازف الشعبيّ ميرزو دجاجاته/ صيصانه على الرقص، إذ يضعها على الصاج المُحمَّى فتضطرّ الدجاجات إلى رفع أرجلها بوتائر متصاعدة، تنتظم بالتقادم والتراكم والتدريب، حينذاك يعزف لها ألحانه، فيزرع بذلك لديها فعلاً شرطيّاً بالاستجابة للعزف بالرقص. ويكون صنيعه مصدر فخر وإعجاب.
يمثّل الرقص فاصلاً منشّطاً من فصول الحياة الرتيبة، فاصلاً قد يتحوّل إلى نقيضه حين يتمّ التعامل معه من باب التحريم والتشويه، ووضعه في غير موضعه، كما يمثّل حالة لامتناهية من الانسجام بين المرء وعالمه، يكفل الرقص بخلق عوالم تتناغم مع روحه المتوثّبة المسكونة بالرقص، ولربّما يكون الرقص نوعاً من أنواع العبادة، أو فسحة للتوحّد مع الطبيعة، بحيث يعود الإنسان إلى جذوره، يسوح مع تخيّلاته المتجاوز الحدود، العابرة للقيود الموضوعة.
تصف السوريّة منهل السرّاج حالة مختلفة من حالات الرقص التي تنتاب المرء، حين تصوّر مشهداً بليغاً عن رقص شخصيّتها مي في روايتها «جورة حوّا»4، مي الرسّامة، تصل إلى درجة من الاندغام مع روحها ولوحاتها، ترسم وترقص، تستجيب لنداءات ألوانها وشخوصها ولوحاتها، تستجيب لهدهدة الطبيعة لها، فتمارس طقسها راقصة في حوشها، خالعة أثوابها، هائمة في بحر الكسوف، وفي كهوف الرقص المبجّلة، متّخذة من رقصها وتعرّيها فضيلة عودة إلى الجذر الأوّل، ومتصالحة مع عملها الفنّيّ، فتبلغ الكمال الإنسانيّ المنشود، ذاك الذي يتسبّب لها بالإهانة والإدانة من قبل المتشدّدين الذين ينعتونها بأشنع النعوت. تغيّر رقصة منفردة في حوش مغلَق حياتها، ترسم مصيرها المجحف بحقّها، تؤدّي إلى إقصائها وتحقيرها. صدى أصوات ألوانها أثارت جنونها وكوامنها إلى الرقص، وأفقدتها وزنها، لتتطاير مع الموسيقى وهي تطيّر أشياءها، وتخلع لباسها.. «أخذت ترقص. ألف حاسّة اخترقتها. أمواج موسيقا مخلوقاتها، وشوشاتهم، طاعتهم، كانت تعلو، تهبط، تمتدّ، تتقلّص، تنحني، تنكسر، تنفرج، عندما تعالى تصفيقهم. أخذوا يعيدون مقطعاً واحداً، مرّات ومرّات، فتستجيب وتتلوّى، تمتلئ، وتفيض»5.
وقد يكون الرقص سبيلاً من سبل الاستعراض النسائيّ، ولاسيّما في مجتمع منغلق، كالمجتمع الذي صوّرته منهل السراج في «جورة حوّا»، التي حضر الرقص فيها بأشكال شتّى، فنجدها تصوّر حفلة نسائيّة، وطريقة تدافع النسوة والفتيات إلى حلبة الرقص، ليكون الرقص مهرباً ومعرضاً، وفي الوقت ذاته دواء للاستطباب ومنفذاً للاستشفاء، يعكس حالة من الرضى والبهجة والاطمئنان والثقة بالنفس، كحالة إحدى بطلات السراج التي تصفها بعد نكبة شخصيّة تعرّضت لها.. «كانت مصمّمة على التماسك والتجاهل. أرسلت ابنتها أوّل الفتيات إلى ساحة الرقص، وسرعان ما اندمجت البنت مع خالاتها برقصة جماعيّة ناجحة جعلت ريمة الجالسة مع أمّها برزانة، كانت قد أنجدتها من مواجهات قد يفتعلها بعض النسوة اللئيمات، تتخفّف من ثقل المشوار. بذكاء مدهش تداهت إلى ساحة الرقص. رقصت راضية عن عملها الذي أنجزته خلال النهار في شقّة طبيب الأسنان، راضية عن أوّل قسط تدفعه لمدرسة ابنتها من عملها في الهندسة…»6.
ومن جميل ما وُصف به الرقص في الرواية، ما ورد على لسان مارية المصريّة؛ بطلة يوسف زيدان في روايته الهامّة «النبطيّ»7، حين تسترسل بشاعريّة وهي تصف الرقصَ أبلغَ وصف، وهي تتحدّث عن ليلة خطبتها لخطيبها العربيّ، تنسحر بالرقص، إذ تؤكّد أنّ مفعول الرقص ساحر، وتأثيره أكثر سحراً. يبعث نشوة في الجسد، يفوق أيّة نشوة أخرى، ويهب الجسد والروح الكثير من اللذائذ. تقول:
«الرقص مفرحٌ.. يدير الرأس.. يُسكِر. لو عرفه الذين يشربون الخمر ليسكروا، لسكروا بالرقص بدلاً ممّا يشربون. سُكْر الرقصِ أحسن، ودواره أرقّ دَوَار. سكرتُ من النبيذ خِفية، فدار رأسي حتّى نمتُ، ثمّ انقبض بطني بعد صحوي وصدع دماغي. الرقصُ لا يصدّع ولا يقبضُ، بل يطرح عنّا الأحزان ويكسو الخدود حُمرةً مُشتهاة، ويمنح الراقصات مِفتاح المرح. والأهمّ، أنّه يترك للصبايا فسحة لتبيان المفاتن»8.
من مفاعيل الرقص في رواية الحياة والفنون:
إن كانت الرواية تعنى بالرقص، فإنّ الفنّ السابع لا يُضاهَى في تركيزه على الرقص، لا يكاد السينمائيّون يتركون شيئاً أو زاوية إلاّ ويتطرّقون إليها ويقاربونها، وقد قدّموا الكثير من الروايات التي تستعرض الرقص من مختلف زواياه، ذلك أنّ الصورة المتحرّكة تساهم بشكل كبيرٍ في التأثير على المتلقّي، وتمنح فسحة واسعة للتعبير عن الطاقات الجسديّة. فمن راقص مع الذئاب، مكتشف عوالمها، ككيفن كوستنر، إلى الكثيرين ممّن أغرقوا أنفسهم في الرقص مع الطبيعة والأصدقاء. حتّى عدّ الرقص ثيمة سينمائيّة لافتة، وكلمة مؤثّرة ذات رنين جاذب مُمغنط.
لا يخفى ما يلعبه الرقص من دور هامّ في الحياة، في حياة مَن يتجاهلون تأثيره، ومَن يفصحون عنه، في الوقت نفسه. وقد جرت العادة أن يكون الرقص الشرقيّ إكسسواراً في الحفلات، مُتغاضىً عن دوره، على الرغم من تهافت العيون على نهش جسد الراقصة، وتفحّص كلّ ثنياته وتمايلاته. ومع انتشاره في العالم، لم يعد شرقيّاً خالصاً، بل ظلّ ملتصقاً بالشرق كميزة، ما يدفع الكثيرات إلى اللجوء إلى الشرق رغبة في تعلّم الرقص الشرقيّ في موطنه، والاستفادة من خبرة الراقصات الشرقيّات..
إذ قد يُتّخذ الرقص وسيلة للتصالح، أو تحفيزاً للتصالح المنشود، عبر التركيز على هذه العلاقة، التي تتضمّن رغبة الغرب في التلاقح مع الشرق، وإن كان عن طريق وسيلة فنّيّة، ينطلق فيلم «ما تريده لولا» للمخرج المغربيّ نبيل عيّوش، بطولة «لورا رامسي، كارمن لبّس»، محاولاً أن يقدّم الاستشراق بصورته المعكوسة الإيجابيّة، الشرق الجاذب لفضول الغربيّين، الشرق الساحر، الشرق المَركز، الشرق المؤثّر، لا ذلك الشرق المتخلّف الذي ينتظر الغرب لينقذه من كوارثه، ولا لاتّخاذ الاستشراق وسيلة للسيطرة والتغلغل..
تنجح لولا نجاحاً منقطع النظير في إحياء الحفلة، يحتلّ اسمها الصفحات الأولى من الصحف، تغدو الراقصة الشرقيّة الأشهر في مصر، ترقص في أشهر الفنادق، تحقّق حلمها في تعلّم الرقص الشرقيّ وإجادته، ثمّ تقرّر، بعد تحقيقها لحلمها، أن تعود إلى ديارها، وفي الحفلة الأخيرة لها، توجّه تحيّة خاصّة إلى مَن تعتبرها رمزاً من رموز مصر، الراقصة الشرقيّة أسمهان، لكنّ تحيّتها تقابَل بداية بالصمت الذي يقطعه تصفيق ناصر راضي الذي يعشق أسمهان، ولا يكلّ من إرسال الرسائل إليها، لتتبعه موجة من التصفيق.. تكون أسمهان حاضرة في الحفلة، تراقب من علٍ، تسارع بالخروج بعدما تهديها لولا نجاحها، يتبعها ناصر لكنّه لا يتمكّن من اللحاق بها، لينجح فيما بعد بالتقرّب منها، بعدما تفتح رسائله الكثيرة، وبعدما تفتح له باب بيتها، وباب قلبها الذي أوصدته في وجه الحبّ، ردّاً على العنف الذي واجهها به العالم عندما أحبّت..
يحاول الفيلم أن يرصد العلاقات المتشابكة التي تربط الولايات المتّحدة بالعالم العربيّ، من خلال وسيلة فنّيّة، تكون نقطة اتّفاق وتلاقٍ بين الجميع، لا خلاف عليها، يُؤثر عدم الخوض في القضايا الإشكاليّة الكثيرة، وعلى الرغم من أنّه يقع في مطبّ البحث عن مصالحة واجبة، لا تكون بتلك البساطة التي يقترحها، لكنّه يبقى مقترحاً جماليّاً، واجتهاداً سينمائيّاً..
يخرج فيلم «ما تريده لولا» الرقص الشرقيّ من تلك الغرف المغلقة، ومن تلك الأقبية التي تحتكره من خلال الاعتماد على الأضواء الخافتة، التي تفضح الأجواء، وتفصح عن النيّات، وتوحي بأنّ هناك ما يقترف في «أتونها»، وفي غضون تلك الفترة التي يختلسها الساهر من نفسه، أو يتحايل بها على بعضٍ ممّن قد يلومونه في ذلك، ليعمّم المستور، ويكشف عن المخبوء.. يأتي الفيلم، ليزيح النقاب عن بعض تلك الأسرار التي تغلّف الرقص الشرقيّ، وتبقيه طيّ الكتمان، بحيث تضفي عليه هالة من الاستجنان، وعلى الأجواء المصاحبة له حالاتٍ وهالاتٍ من الصخب الممتع الذي يُتغزَّل به.. أي يعلن حديث السرّ، ولا يتكتّم عليه، مع بعض المبالغة في ردود الفعل إزاء الراقصة «أسمهان»، وهذا يعتبر في العرف المتّبَع خروجاً على المألوف، خاصّة، أنّ الثقافة العربيّة تحاول في كثير من الأحيان الالتفاف على التسميات بعدم التصريح بها، بل الاكتفاء بالإيماء إليها أو الإيحاء بها..
يبتعد الفيلم عن فكرة تسويق الجسد أو تسليعه، بل يحاول ردّ الاعتبار إليه، يوصل رسالة تقول إنّه لا بدّ من الإقرار أنّ الرقص الشرقيّ يسكن كلّ بيت، ويستصدر القرار في كثير من الأماكن. كما يمكن القول إنّ الفيلم يخاطب الدواخل، يثير المكنونات، يثوّر الرغبات التي يستحيل إشباعها، لا بالنظر من دون حذر، ولا بالجهر من دون تكتّم.. حيث الانثناء والانحناء والتطاير يغزو العيون ويدخل المستقرّ.. لم يأبه صنّاع الفيلم، لتلك المقولات التي تبقي الشرق رهينَ الرقص ومجالس الأنس، ولا أسير عوالم ألف ليلة وليلة، بل خالفوا القول، خلطوا الشرقيّات بالغربيّات، فكانت اللوحات الساحرة المؤدّاة، التي تصرّح أنّ الرقصَ امتياز شرقيّ مفتخَر به، كما يغدو الرقصُ الشرقيّ وسيلة استشراقيّة معاصرة، تقرّب، وتحبّب، لا تنفّر أو تكرّه.. ولولا الدور الهامّ الذي يلعبه الرقص في حيواتنا، لما توقّف إدوارد سعيد عند تحية كاريوكا وكتب عنها ما كتبه.. ناقداً وكاسراً الادّعاءات الاستشراقيّة التي حاولت أن تبقي الشرق بتلك الصورة المقوْلَبة التي يريدها الآخرون عنه..
كما قد يُتّخذ الرقص سبيلاً للتعرّف إلى الذات والتحرّر من القيود النفسيّة والجسديّة، كما في فيلم «البجعة السوداء» إخراج دارين أرنوفسكي، وبطولة ناتالي بورتمان… حيث تفتح الستارة، تظهر راقصة باليه بثياب بيضاء في عتمة المسرح، ترقص على الخشبة رقصة منفردة، يشاركها بعد دقائق راقص ينضمّ إليها. تتغيّر الأشكال، تؤدّي المؤثّرات السمعيّة والبصريّة المرافقة أدواراً بارزة في جذب المشاهد إلى خشبة المسرح التي تكون مسرحاً لأحداث الفيلم. ثمّ تظهر الراقصة نينا «ناتالي بورتمان» في سريرها، تفيق من النوم، تقوم ببضعة تمرينات، تخبر والدتها أنّها حلمت حلماً غريباً، حلمت أنّها تؤدّي رقصة مختلفة عن تلك التي تتعلّمها، رأت أنّها ترقص كبجعة بيضاء في قصّة روائيّة، ثمّ حين تذهب إلى التمرين تتفاجأ بالمخرج يخبر الفريق أنّه سيفتتح الموسم بتمثيل بحيرة البجع، وأنّه بصدد إنتاج جديد يحتاج إلى ملكة بجع جديدة، حيث يفترَض أنّ هناك فتاة صغيرة عذراء، محاصَرة في جسد بجعة، تسعى إلى الحرّيّة، والحبّ الحقيقيّ وحده يستطيع كسر التعويذة، تتحقّق أمنيتها بواسطة أمير، لكن قبل أن يعترف لها بحبّه، تأتي أختها البجعة السوداء وتقوم بإغوائه، تغادر البجعة البيضاء وهي محطّمة، تقوم بقتل نفسها، وفي الموت تعثر على الحرّيّة. ينتقي المخرج عدداً من الفتيات، يقرّر أنّ تكون الملكة واحدة منهنّ، يبحث عن واحدة تستطيع تجسيد البجعتين معاً. يختار بشكل مبدئيّ نينا، الفتاة المتفانية التي يرى أنّها تصلح للدور لكن تنقصها بعض الأمور، تصرّ نينا أنّها تسعى إلى أن تكون كاملة، يخبرها المخرج أنّ الكمال لا يتعلّق بالسيطرة فقط، بل هناك أمور أخرى هامّة، منها إمكانيّة قلب الأحداث والمقدرة على مفاجأة الجمهور. ثمّ وسط غيرة الراقصات وحسدهنّ ومكائدهنّ لاستجرار المخرج إلى تغيير رأيه، يسعى المخرج إلى تحريك البرود الذي يبدو أنّه يتحكّم بمشاعرها وجسدها، إذ أنّ دور البجعة السوداء يحتاج إلى المقدرة على الإغواء والتلاعب بالمشاعر عبر تثويرها لاستثارة الرغبات، لكنّ نينا تبدو متحفّظة، ترعبها فكرة التحرّر، كاملة من الناحية الخارجيّة، لكنّها مأسورة من داخلها، مقيّدة بقيود كثيرة تمنعها من التحرّر وإطلاق طاقاتها كلّها.
يعتمد الفيلم على الخلط بين العوالم الفانتازيّة والواقعيّة، يخلط بين الأحلام والكوابيس والوقائع، يُجري تداخلاً بين المسرح والباليه والرقص والغناء ليبني عوالمه السينمائيّة اللافتة، كما أنّه يعتمد على التعمّق والتدبّر في الحالات النفسيّة للشخصيّات التي يقدّمها، كأنّه يعنى بدراسة حالات نفسيّة متباينة، يقدّمها بألوانها الحقيقيّة، يقدّم البياض والسواد والمناطق المتداخلة فيما بينهما. تتبدّى كلّ شخصيّة انعكاساً لأخرى، وجهاً من وجوهها العديدة. يُبدي البياض وجهاً مُمرأى من وجوه السواد، أو أحد مكوّناته الأساسيّة. يدرس التشظّي الموجود في النفس البشريّة، يبحث عن الانقسام والتناقض ليعيد ترميم الرأب الحاصل بعد تقويم المعوجّ ومعالجته.
وسط الأجواء الصاخبة، في ظلّ التقييد والفرض والمنع، يكون الرقص وسيلة فضلى للتطهير والاستشفاء، تتداوى نينا بالرقص، تتّخذه درباً للوصول إلى حقيقتها المحجوبة عنها بأحجبة كثيرة تبعدها عن نفسها، تستكنه بالرقص أغوار روحها، تستكشف أسرارها وطاقاتها الكامنة، تتخلّص به من عذاباتها، تثبت عبره كينونتها المفقودة، وهويّتها الضبابيّة التائهة. تحدّد انتماءها، وتختار طريقها. تسدل الستارة بعد أن تختتم المسرحيّة بالحرّيّة المنشودة. يكون الرقص أداتها الثوريّة للتغيير. كما يكون أداؤها اللافت، من العوامل الرئيسة في إنجاح العمل.
ولربّما يُتّخَذُ الرقص وسيلة للتعبير عن الرثاء، خاصّة حين يكون الراحل أحد أعلام الرقص أو الغناء، كحالة مايكل جاكسون مثلاً، إذ درجت العادة أن يودّع الموتى بالبكاء ويُرثَوا بالدموع والصمت المَهيب، لكنّ رثاء مايكل جاكسون، الغريب في حياته ومماته، كان مختلفاً عن الآخرين، كأنّ الصمت لا يليق بملك الپوپ المستمرّ بضجيجه هنا وهناك، فقد رأينا عشّاقه المصدومون بموته يلهجون بأغانيه، يرقصون على نغماتها، مقلّدين حركاته الغرائبيّة المبتكرة الفذّة، محاكين صورته المتقلّبة، التي صار التقلّب سمة ثابتة لها، ولا شكّ أنّ ذلك يعود إلى الاضطراب الذي عاشه، والحرمان الذي حاول تعويضه، فدأب على البحث عن صورة يستقرّ عليها، وما استطاع إلى ذلك سبيلاً، لأنّه ظلّ مسكوناً بالتوتّر، وما عرف إلى الاستقرار دليلاً، ولربّما الفرار من صورته التي تضغط عليه. صورة ذاك الأسود الذي ينكر سواده وينكره الآخرون لسواده.. هكذا كان جاكسون اللامألوف.. تجلّى تفريغ شحنات الحزن من قبل عشّاقه على رحيله المؤسف لهم، عبر عقد حلقات الرقص في الساحات العامّة، لتكون مجالس عزاء تليق بجاكسون الذي نقل عدوى استجنانه إلى معجبيه الذين اعتادوا مفاجآته، لكنّهم لم يتصوّرا فجيعة رحيله مبكّراً.. إنّه حقّاً الرثاء الأكثر مُلاءَمة لجاكسون؛ الرثاء بالرقص والغناء..
ونظراً للسحريّة التي يتجلّل بها الرقص الذي يلوّن الوجود بلونه الأخّاذ، فلا غروَ أنّ يظلّ المشهدَ الأكثر إثارة وإنارة وتكراراً في رواية الحياة، وفي قلب الفنون، ليشكّل ذروة من ذراها البهيجة الساحرة..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
1 – كازنتزاكيس، نيكوس، زوربا، رواية، أسامة، دمشق، 1990.
2 – صولير، آنطونيو، ترجمة: علي إبراهيم أشقر، موت الراقصات، رواية، وزارة الثقافة، دمشق، 2010.
3 – قاسو، لالش، ترجمة: إبراهيم محمود، أيّام حسّو الثلاثة، پَلدا، أوغندا، 2001.
4 – السراج، منهل، جورة حوّا، رواية، المدى، دمشق، 2005.
5 – المرجع السابق. ص 99
6- المرجع نفسه. ص 285 – 286.
7 – زيدان، يوسف، النبطيّ، رواية، الشروق، القاهرة، 2010. ط3.
8 – المرجع السابق. ص48

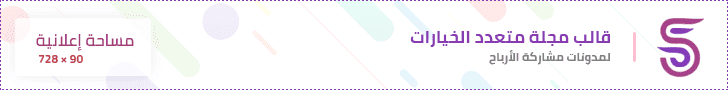

إرسال تعليق