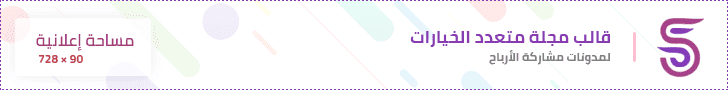الشرح المختصر على موطأة الفصيح لابن المرحل
[الحلقة 17]
[بَابُ فُعِلَ بِضَمِّ الْفَاءِ]
[الحلقة 17]
[بَابُ فُعِلَ بِضَمِّ الْفَاءِ]
المقصود من هذا الباب بيان الأفعال التي وردت عن العرب بصيغة المبني للمجهول، ولا يقصد ثعلب ما ورد على صيغة (فُعِل) بخصوصها؛ لأنه ذكر صيغا أخرى من باب المبني للمجهول؛ مثل (أُفْعِلَ) و(استُفْعِل) وغيرها.
وطالب العلم الذي حصَّل مبادئ (علم الصرف) من قبل، لن يجد صعوبةً في معرفة جميع تصاريف الأفعال في هذا الباب؛ لأنها كلها جارية على القياس، وهذه نماذج منها:
- فُعِلَ يُفْعَل فهو مَفعول: مثل كُسِر يُكسَر فهو مَكسور
- أُفْعِلَ يُفْعَل فهو مُفْعَل: مثل أُكرِم يُكرَم فهو مُكرَم
- افْتُعِلَ يُفتَعَلُ فهو مُفتَعَل: مثل امتُحِن يُمتحَن فهو مُمتحَن
- استُفعِلَ يُستفعَلُ فهو مُستَفعَل: مثل استُخرِج يُستخرَج فهو مُستخرَج
[175- وَقَدْ عُنِيتُ بِكَذَا شُغِلْتُ ..... أُعْنَى بِهِ فَعَنْهُ مَا عَدَلْتُ]
لفظ ثعلب في الفصيح (عُنِيتُ بحاجتك) فغيرها الناظمُ ليستقيم له الوزن، وليكون أعم.
تقول (عُنِيَ فلانٌ بالشيء) بضم العين وكسر النون؛ كما تقول (قُتِلَ) و(ضُرِبَ)، فهو فعل مبني للمجهول، ويقولون أيضا (مبني للمفعول) أو (مبني لما لم يُسَمَّ فاعلُه).
والجادة في كلام العرب أن الفعل المبني للمجهول لا بد أن يكون متفرعا عن الفعل المبني للمعلوم؛ فتقول (كَسَرته فكُسِر، وصَنَعتُه فصُنِع، وأَكَلتُه فأُكِل)، إلخ.
ولا يلزم أن يكون من الأفعال المتعدية، بل قد يكون لازما؛ كما تقول: (ذُهِبَ إلى المسجد، ونِيمَ في البيت، وجُلِسَ على الكرسي)، ومنه قوله تعالى: {يُسبَّح له فيها} على قراءة من فتح الباء.
ويرِدُ هنا سؤال: ما دامت صيغةُ المبني للمجهول قياسيةً مطردة في كلام العرب، فلماذا ذكر ثعلب هذه الأفعالَ دون غيرها في هذا الباب؟ والجواب: أنه لا يقصد جميع ما ورد عن العرب مبنيا للمجهول قياسا؛ لأن هذا مطرد لا ينحصر، وإنما يقصد ما استُعمِل بهذه الصيغة على غير القياس من جهة المعنى، بأن يكون بمعنى المبني للمعلوم، وأيضا قد يورد ثعلب بعض الأفعال القياسية المطردة لأمر عارض، وذلك إذا كانت العامة تخطئ فيها أو تستعمل خلاف الأفصح لتمام الفائدة.
وهذا الفعل (عُنِي) عند التأمل ليس من الشواذ؛ لأنك تقول (عَنَاني الشيءُ، وعَنَاني الأمرُ، فعُنِيتُ به) كما تقول (كفاني الشيء، فكُفِيت به)، و(هداني الرجل، فهُدِيت به)، وهكذا.
ويدل على هذا أنهم فسروا (عُنِيتُ) بقولهم (شُغِلتُ) وهو مبني للمجهول قياسا مطردا بلا خلاف، وبهذا التقرير يظهر أنه لا يصح انتقادُ ثعلب على ذكر بعض الأفعال القياسية في هذا الباب.
[176- وَأَنَا مَعْنِيٌّ بِهِ، وَمُولَعُ ..... بِالشَّيْءِ مِنْ أُولِعَ فَهْوَ يُولَعُ]
هذا تمام بيان للفعل السابق بذكر بعض تصاريفه المستعملة في كلام الناس؛ لأن الخطأ (أو خلاف الأفصح) لا يقتصر على الفعل، بل قد يقع في المشتقات أيضا؛ فكما تقول (شُغِلت فأنا مشغول) تقول (عُنِيت فأنا مَعنِيٌّ)، وإنما اشتبه ذلك على العامة لأنه فعلٌ معتل، لكنه يسهلُ فهمُه برَدِّه إلى نظائره؛ كما تقول (رُمِيت فأنا مَرميّ)، و(كُفِيتُ فأنا مَكفيّ)، هذا في الأفعال اليائية، وأما الأفعال الواوية فتقول: (دُعِيتُ فأنا مَدعوّ)، و(بُليتُ فأنا مَبلوّ)، و(تُلِي الكتاب فهو مَتلوّ)، وهكذا.
وهذه قاعدة عامة تستفيد منها في كثير من مسائل العلم وفي معظم العلوم، وهي تفهُّم المسألة وتدبرها بجمع نظائرها وأشباهها وما يقرب منها ويكون منها بسبب، ولذلك تجد العلماء يؤلفون في (الأشباه والنظائر) أو (الوجوه والنظائر) في علم الفقه، وفي علم التفسير، وفي علم النحو، وغير ذلك.
وفي هذا البيت أيضا فعلٌ آخر قريب من معنى (عُني) ويستعمل استعمالَه كذلك، وهو (أُولِعَ بالشيء) بضم الهمزة وكسر اللام، والمضارع: (يُولَع) بضم الياء وفتح اللام، ومعناه (شُغِف)، وبهذا التفسير يتضح أنه جارٍ على القياس أيضا؛ لأنه مبني للمفعول، ولذلك تقول: (أَوْلَعْتُ فلانا بالشيء فأُولِع به) مثل (أَغرَيتُه بالشيء فأُغرِي به).
هذا في الفعل الرباعي، أما الثلاثي فتقول: (ولِع وَلوعًا) بفتح الواو في المصدر شذوذا؛ لأن المصادر في مثل هذا تأتي بضم الأول؛ مثل (خرج خُروجا، وخضع خُضوعا، وقعد قُعودا)، وقد شذ عن هذه القاعدة مصادر قليلة ورد منها في القرآن (قَبول) في قوله تعالى: {فتقبلها ربها بقَبول حسن}، ومنها أيضا (وَزوع)، وأما (الوضوء والطهور والوقود) ففيها خلاف قديم معروف بين العلماء، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في باب المفتوح أوله من الأسماء.
[177- وَبُهِتَ الْإِنْسَانُ فَهْوَ يُبْهَتُ ..... يَشْخَصُ مِنْ تَعَجُّبٍ وَيَسْكُتُ]
في بعض النسخ (وبهت الرجلُ) وهو الموافق لكلام ثعلب في الفصيح.
تقول (بُهِتَ) بضم الباء وكسر الهاء، ومنه قوله تعالى: {فبهت الذي كفر}، وسبب الشذوذ في هذا الفعل أنه لا يجري على المبني للمعلوم منه؛ لأنك تقول (بَهَتَ) بمعنى كذب أو افترى أو نحو ذلك كما في حديث أبي هريرة عند مسلم (إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بَهَتَّه)، والمبني للمجهول من هذا المعنى أن تقول (بُهِتَ فلانٌ) أي افتُرِي عليه، وهذا المعنى مخالف لمعنى الفعل الذي هنا.
ويدل على شذوذه أيضا أن الناظم فسره بفعلين مبنيين للمعلوم بقوله (يَشخَص من تعجب ويَسكت).
ومنه قول أبي صخر الهذلي:
فما هو إلا أن أراها فجاءة .... فأُبْهَت لا عرف لدي ولا نكر
[178- وَوُثِئَتْ يَدُ الْفَتَى فَيَدُهُ ..... مَوْثُوءَةٌ لِأَلَمٍ يَجِدُهُ]
تقول (وُثِئَت اليد) بضم الواو وكسر الثاء، والمضارع (تُوثَأ) بضم التاء وفتح الثاء؛ كما تقول (وُضِع يُوضَع)، و(وُتِر يُوتَر) كما في الحديث (من فاتته صلاة العصر فكأنما وُتِرَ أهلَه ومالَه).
هذا من جهة التصريف، وأما المعنى فسيأتي تمامه في البيت الذي بعده.
[179- مِنْ ضَرْبَةٍ يَأْلَمُ مِنْهَا الْعَظْمُ ..... وَقِيلَ بَلْ يُوصَمُ مِنْهَا اللَّحْمُ]
يقول الناظم إن معنى (وثئت اليد) هو أن تصاب بضربة موجعة، لكن اختلف العلماء في تحديد ذلك أو في قدر ما تصل إليه الضربة، فقيل: (يبلغ الوجع إلى العظم من غير أن ينكسر) وقيل: (يصاب منها اللحم دون العظم)، وقوله (يوصم) معناه يألم، أو يعاب من الوَصْمَة.
[180- وَشُغِلَ الْإِنْسَانُ عَنَّا، وَشُهِرْ ..... أَيْ أَمْرُهُ فِي النَّاسِ بَادٍ قَدْ ظَهَرْ]
تقول (شُغِل فلان يُشغَل) ومعناه معروف، وتقول في تفسيره: (انشغل) وهذا من الأدلة على أنه مبني للمفعول قياسا؛ لأن وزن (انفعل) من صيغ المطاوعة؛ كما تقول (كسرته فكُسِر، وانكسر)، و(قطعته فقُطِع، وانقطع)، و(فتحته ففُتِح، وانفتح)، و(فصلته ففُصِل وانفصل)، وهكذا.
وقد سبق ذكرُ هذا الفعل في الباب السابق (باب فعلت بغير ألف) عند قول الناظم:
149- وحزن الأمر وأمرٌ شَغَلَا .... وقد شفى الرحمن هذا الرجلا
وهذا دليل واضح على أن ثعلبا لا يقصد بذكر هذا الفعل في باب فُعِل أنه ملازم لصيغة المبني للمجهول، وإلا لما ذكر المبني للمعلوم فيما سبق.
وقد سبق أيضا ذكر هذا الفعل عرضا عند قول الناظم:
32- وقد ذَهَلت عنك أي شُغِلت .... وقيل قد نسيت أو غفلت
ولعل مراد ثعلب بذكر هذا الفعل (شغل) في هذا الباب أن العرب تتعجب منه على صيغة ما لم يسم فاعله فيقولون: (ما أَشْغَلَه) أي ما أكثر شغله، وهذا شاذ؛ لأن من شروط التعجب أن يكون الفعل المتعجب منه مبنيا للمعلوم؛ كما قال ابن مالك:
وصُغهما من ذي ثلاث صُرفا .... قابلِ فضل تم غيرِ ذي انتفا
وغيرِ ذي وصف يضاهي أشهلا .... وغيرِ سالكٍ سبيلَ فُعِلا
وتقول (شُهِرَ فلانٌ) بضم الشين وكسر الهاء، (يُشْهَر) بضم الياء وفتح الهاء، فهو (مشهور)، وهذا الفعل قياسي؛ لأنك تقول في المبني للمعلوم (شَهَرْتُ فلانا فشُهِر) أي جعلته مشهورا، والمطاوع منه تقول (اشْتَهَر) بفتح التاء والهاء على صيغة الفاعل؛ لأنه فعل مطاوع، ويجوز أيضا أن تقول (اشتُهِر) بالبناء للمفعول سماعا عن العرب؛ لأن الفعل (اشتهر) يستعمل لازما ومتعديا، لكن الأكثر استعمالا في كلام العرب استعماله لازما بمعنى (شُهِر)، وهو أيضا الموافق للقياس؛ لأنه مطاوع (شَهَر).
ووقع في بعض نسخ الفصيح زيادة الفعل (ذُعِرَ)، وهو قياسي؛ لأنك تقول (ذَعَرتُ فلانا أذعَرُه) أي أخفته، وذُعِر يُذعَر فهو مذعور.
[181- وَدَمُ زَيْدٍ طُلَّ أَيْ لَمْ يُقْتَلِ ..... قَاتِلُهُ وَلاَ وُدِيْ بِجَمَلِ]
هذا من المواضع القليلة التي فسرها ثعلب؛ إذ قال كما ورد في بعض النسخ: (وقد طُلَّ دمه فهو مطلول: إذا لم يُدرَك بثأره)، ويحتمل أن يكون ثعلب قد قاله في أثناء قراءة الفصيح عليه فأضافه بعضهم للنسخة؛ لأنه لا يوجد في أكثر النسخ.
وقوله (وُدِيْ) بسكون الياء لضرورة الشعر، وحقه أن يبنى على الفتح لأنه فعل ماض غير متصل بشيء، وهذه الضرورة مستساغة كثيرة في الشعر، لا تستقبح.
وقوله (وُدِي) مشتق من الدية التي عادة تكون بالجِمال كما أشار الناظم، فقوله (بجمل) من باب التمثيل، ومن باب التوضيح كذلك؛ كي لا يقع في الكلام تصحيف.
وتفسير (طُل) بـ(لم يُقتل قاتله) و(لا وُدِي) يدل على أنه فعل قياسي في بنائه للمجهول، ولذلك تقول (طَلَلْتُ دم فلان فطُلَّ) أي أهدرته، وأضعته، ولم أجعل فيه دية، وإنما ذكره ثعلب لأن بعض الناس يقول (طَلَّ دمُه) أو (أُطِل دمه)، والفصيح هو (طُل) كما ذكر.
وقد ورد هذا الفعل في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن دية الجنين غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة: (كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يُطَلّ) أي يهدر ولا تكون له دية.
وقال الحارث بن حلزة في معلقته:
ثم خيلٌ من بعد ذاك مع الغَلَّـ ..... ـاق لا رأفةٌ ولا إبقاءُ
ما أصابوا من تَغلَبي فمطلو .......... لٌ عليه إذا أُصِيبَ العفاءُ
أي أن كل من أصابوا من بني تغلب فقد طل دمه، أي أهدر ليس له من ينتصر له، ولا من يأخذ بثأره.
[182- وَمِثْلُهُ أُهْدِرَ، لَكِنْ فُرِّقَا ..... بَيْنَهُمَا فِي الشَّرْحِ لَمَّا حُقِّقَا]
قوله (ومثله أُهدِر) أي ومثل الفعل السابق (طُل) فكلاهما بمعنى واحد كما سبقت الإشارة.
وقد ذكر ثعلب اسم المفعول (مُهدَر) لأن كتابه موضوع للتعليم، ولم يذكره الناظم لوضوحه.
والعرب عندها كثير من الألفاظ في هذا المعنى؛ لأن القتال كان كثيرا بين القبائل، ومن لوازمه أمرُ الديات وتحصيلها أو إهدارها، ومن هذه الألفاظ (جُبَار) بضم الجيم وفتح الباء المخففة، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم (العجماءُ جبار، والبئرُ جبار، والمعدِنُ جبار، وفي الركاز الخمس)، أي أن ذلك مُهدَر شرعا، ولا تجب الديةُ فيه.
ومن ذلك حديث يعلى بن أمية عند البخاري ومسلم (كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فسقطت ثنيته، فانطلق إلى النبي فأَهْدَرَ ثَنِيَّتَه)
وبعضُ العلماء فرق بين (طُل) و(أهدر) كما سيأتي في البيت الذي بعده.
[183- فَقِيلَ فِي طُلَّ مَقَالٌ وَاحِدُ ..... وَقِيلَ فِي أُهْدِرَ أَمْرٌ زَائِدُ]
القائل هو ابن درستويه كما سيأتي، وقوله (مقال واحد) أي أنه هو المعنى نفسه المذكور سابقا في البيت (181)، وأما (أهدر) ففيه زيادة معنى ستأتي.
[184- فَإِنَّهُ الْمُبَاحُ مِنْ سُلْطَانِ ..... أَوْ غَيْرِهِ فَالْقَتْلُ فِي أَمَانِ]
في بعض النسخ (بأنه) وهو أوضح في المعنى، والمقصود (فإن أهدر تقال في المباح ...) إلخ.
قال ابن درستويه: (إلا أن بين طُل وأُهدِر فرقا؛ وهو أن الإهدار إنما هو الإباحة من سلطان أو غيره لدم إنسان ليقتل بغير مخافة من قود أو دية أو طلب به).
يقصد أن (طُل) تكون بعد حصول القتل بإسقاط الدية، و(أُهدِر) تكون قبل حصوله، فلا يخشى القاتل المطالبة بالدية أو القصاص.
تقدم معنا في الحلقة السابقة أن هذا الباب كله (باب فُعِل) جار في تصريفه على القياس؛ فتقول (فُعِلَ يُفْعَلُ) في الثلاثي، و(أُفْعِلَ يُفْعَلُ) في الرباعي، ونحو ذلك.
[185- وَوُقِصَ الْإِنْسَانُ وَقْصًا أَيْ صُرِعْ ..... فَانْكَسَرَتْ عُنُقُهُ لَمَّا وَقَعَ]
نص كلام ثعلب (وُقِص الرجلُ إذا سقط عن دابته فاندقَّت عنقُه فهو موقوصٌ)، ففسر الفعل بقوله (سَقَط) المبني للمعلوم، وفسره الناظم بقوله (صُرِع) المبني للمجهول، والمعنى فيهما قريب، لكن نستفيد من ذلك أن هذا الفعل جارٍ على القياس؛ لأنك تقول (وَقَصَ الشيءُ العنقَ يَقِصُها) أي كسرها (فوُقِصَت العنقُ) أي انكسرت، وفي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقفٌ بعرفة إذ وقع عن راحلته فوَقَصَتْه ناقتُه؛ أي كسَرت عنقَه، وفي حديث أنس رضي الله عنه أن ابنة ملحان ركبت دابتها فوَقَصَت بها؛ أي رَمَت بها. وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم (أُتِي بفرس فركبه رجلٌ فجعل يتَوَقَّص به) أي يتحرك ويتوثب، كأنه يريد أن يلقيه ليَقِصَه.
وربما يكونُ ثعلب قد وضع هذا الفعل في هذا الباب لأن الناس تقول (وَقِص الإنسانُ) أو (وَقِصت العنقُ) بفتح الواو، وهناك احتمال ثانٍ؛ أن يكون وضعه بسبب أن هذا الفعل خالف جادةَ القياس؛ لأن فيه نسبة الوَقْص للإنسان بدلا من العنق؛ فكأنك قلت (وُقِصَ الإنسانُ عُنُقَه) كما تقول (سَفِه نَفْسَه) و(غَبِنَ رأيَه) كما سيأتي، وهناك احتمال ثالث، وهو أنه قد سُمع عن العرب (واقصة) بمعنى موقوصة؛ كما في أثرٍ عن علي رضي الله عنه أنه قضى في الواقصة والقامصة والقارصة بالدية أثلاثًا، ولكن هذا الوجه الأخير فيه نظر؛ لأن ثعلبا قد نص على أن الفصيح هو (موقوص).
ومن العجيب أن أكثر الشراح في هذا الموضع تكلموا باختصار عن (الوقص) الذي هو المقصود من السياق، وأطالوا في الكلام عن (العنق) مع ورودها عرضا في كلام ثعلب!
[186- وَوُضِعَ الْإِنْسَانُ فِي الْبَيْعِ خَسِرْ ..... وَمِثْلُهُ وُكِسَ أَيْضًا؛ فَاعْتَبِرْ]
تقول (ذهبت إلى السوق متاجرا فوُضِعْتُ مائةَ دينار)، وتقول (لم أوفَّق في هذه الصفقة إذ وُكِستُ فيها) ومعناهما جميعا خسرت كما ذكر الناظم.
وقوله (فاعتبر) فيه إيجاز وبلاغة لأنه مناسب للمقام من جهتين: من جهة تفسير اللفظين وتقارب معنييهما، فكأنه يقول: اعتبر كلا منهما بالآخر في التفسير والتصريف، ومن جهة المعنى والتطبيق، فكأنه يقول: اعتبر ذلك في حياتك، فلا تقع في مثل هذه الخسارة.
وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له فارتفعت أصواتهما في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (ضَعِ الشطر)، فقد يكون اشتقاق (وُضِعَ في البيع) من هذا؛ لأنك تقول (اشتريتُ هذا الشيء بمائة وبعته بخمسين، فوَضَعتُ من سعره الشطرَ).
وقد يكون ثعلب وضع هذا الفعل في هذا الباب لأن بعض الناس يقول (وَضِع) بفتح الواو، ويحتمل أن يكون قد وضعه لسبب آخر، وهو أنه لا يتصرف؛ فلا يقال (فلان موضوع في تجارته) كما يقال (سُقِط في يده) ولا يقال (مسقوط في يده).
وتقول (وكَسه) بفتح الكاف في الماضي، (يَكِسُه) بكسر الكاف في المضارع، أي نقصه في السعر، ومن الشائع في كلام الناس (باعه بأوكس الأسعار) أي أدناها، وفي حديث ابن عمر عند مسلم (من أعتق عبدا بينه وبين آخر، قوم عليه قيمة عدل، لا وَكْسَ ولا شطط)، أي لا يُنقص عن حقه فيخسر، ولا يُزاد فيه فيطغى.
وإنما ذكر ثعلب هذا الفعل في هذا الباب لأن العامة تقول (أُوكِست) بالهمزة من الرباعي، وهي لغة حكاها بعض العلماء، لكن الفصيح (وُكِس).
[187- وَغُبِنَ الْإِنْسَانُ فِيهِ خُدِعَا ..... غَبْنًا، وَفِي الرَّأْيِ بِفَتْحٍ سُمِعَا]
قوله (فيه) أي في البيع السابق ذكره في البيت الذي قبله، فالحاصل أنك تقول (وُضِع، ووُكِس، وغُبِن) كله بمعنى خسر في البيع، أو خُدع في البيع، أو انتقص في قيمة السلعة عن رأس المال.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما (نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)، أي مخدوع عن عقله، كما يخدع التاجر في البيع.
ولكن الفعل (غبن) يستعمل في غير البيع، ولذلك قال (وفي الرأي بفتح سمعا) أي ويستعمل هذا الفعل (غبن) في باب الرأي، لكنه يكون في هذا المعنى بفتح الغين (غَبِنَ)، وسيأتي توضيح ذلك في البيت بعده.
[188- تَقُولُ: قَدْ غَبِنَ زَيْدٌ رَأْيَهُ ..... وَالْمَصْدَرُ الْغَبَنُ، حَسِّنْ وَعْيَهُ]
وقع في المطبوع (غُبِن) بضم الغين، والصواب الفتح؛ لأن المراد من هذا البيت إيضاح استعمال الفعل (غَبِن) الذي أشار في البيت قبله إلى أنه بفتح الغين في باب الرأي، بخلاف (غُبِن) المضموم العين في باب البيع؛ فتقول (غَبِنَ الرجلُ رأيَه) أي صار ضعيف الرأي، قليل الحكمة والتصرف في الأمور، ولذلك ختم الناظم البيت بقوله (حَسِّنْ وعيَه) أي لعلاج هذه الآفة التي أصابته.
وقوله (والمصدر الغبَن) أي بفتح الباء، بخلاف مصدر الفعل السابق فهو (الغبْن) بالسكون؛ كما في البيت (187).
وقول العرب (غبِن رأيَه) هو مثل (سفِه نفسَه) و(جهِل أمرَه) و(وجِع بطنَه)، وفي تفسير مثل هذه الأفعال أقوال عند العلماء:
القول الأول: أن معناها (غبن الشخصُ في رأيه)، و(سفِه هو في نفسه) و(جهل الإنسان في أمره)، و(ووجع المرء في بطنه). والعلماء يعبرون عن ذلك بقولهم (منصوب على نزاع الخافض) أو (منصوب على إسقاط الجار)؛ كما تقول (ذهبتُ الشامَ)، و(مررت الديارَ)، و(قعدتُ البيتَ) .. إلخ.
وجمهور العلماء على أن هذا مقصور على السماع، كما قال ابن مالك:
وعَدِّ لازمًا بحرف جر ........ وإن حُذف فالنصبُ للمُنجر
نقلا وفي أنَّ وأنْ يَطردُ ........ مع أمْنِ لبسٍ كعجبتُ أن يدوا
فقوله (نقلا) إشارة إلى قصر ذلك على السماع.نقلا وفي أنَّ وأنْ يَطردُ ........ مع أمْنِ لبسٍ كعجبتُ أن يدوا
القول الثاني: أن هذه الأفعال وإن كانت لازمة إلا أنها صارت متعدية في هذا الموضع، وما بعدها مفعول به، فيكون التقدير (غبِن رأيَه) أي (أضاعَ رأيَه)، وفي (سفِه نفسَه) جعل نفسه سفيهة، وهكذا.
القول الثالث: أن هذه المنصوبات كلها من باب التمييز؛ كأنك قلت (غبن رأيًا) و(سفه نفسًا).
وهذا الفعل (غَبِنَ) ليس له علاقة بباب (فُعِل)، وإنما أدرجه ثعلب في هذا الباب ليبين الفرق بينه وبين (غُبِن) حتى لا يختلط على طالب العلم.
[189- وَهُزِلَ الرَّجُلُ فَهْوَ يُهْزَلُ ..... وَغَيْرُهُ فَالْجِسْمُ مِنْهُ يَنْحَلُ]
قول الناظم (وغيرُه) له علاقةٌ بقول ثعلب (وهُزِل الرجلُ والدابة) لكن كلام ثعلب أدق؛ لأن الهزال لا يستعمل في الجمادات مثلا، وسيأتي تفسيره في البيت بعده.
وقد علم من كلام الناظم أن الصواب أن تقول (هُزِلَت الدابة)، والعامة تقول (هَزُلَت)، وهذا الفعل يستعار للدلالة على ابتذال الشيء وقلة قيمته عند الناس؛ مثل الدابة المهزولة التي لا يرغب أحد في شرائها؛ ومن ذلك الأبيات المشهورة:
تصدَّر للتدريس كلُّ مهوَّس ........ بليدٍ تَسمَّى بالفقيه المدرسِ
فحُقَّ لأهل العلم أن يتمثَّلوا ........ ببيتٍ قديم شاع في كل مجلسِ
لقد هُزِلَت حتى بدا من هُزالها ....... كُلاها وحتى سامها كل مُفلسِ
[190- مِنَ الْهُزَالِ وَهْوَ ضِدُّ السِّمَنِ ..... وَقَدْ نُكِبْتُ مَرَّةً فِي الزَّمَنِ]
فحُقَّ لأهل العلم أن يتمثَّلوا ........ ببيتٍ قديم شاع في كل مجلسِ
لقد هُزِلَت حتى بدا من هُزالها ....... كُلاها وحتى سامها كل مُفلسِ
[190- مِنَ الْهُزَالِ وَهْوَ ضِدُّ السِّمَنِ ..... وَقَدْ نُكِبْتُ مَرَّةً فِي الزَّمَنِ]
يقول الناظم إن الفعل السابق ذكره (هزل الرجل) هو من (الهُزَال) الذي هو ضد السمن، وهذا من تفسير الشيء بضده لوضوحه؛ كما تقول (الكبير ضد الصغير) و(الطويل ضد القصير) و(السمين ضد النحيف) و(العظيم ضد الضئيل) و(الكثير ضد القليل) وهكذا.
فالتفسير بالمضاد طريقة نافعة، ومنهج مسلوك عند أهل العلم، ولا يقال فيه (إنه من الدَّور بناءً على أن كلا منهما يفسر بالآخر)؛ لأن المقصود بيانُ الشيء بذكر لازمه أو بذكر مقتضاه، لأن تصور معنى (الكبير) يستلزم أو يقتضي تصور معنى (الصغير)، وتصور معنى (السمين) يستلزم تصور معنى (النحيف)، وهكذا.
وهذا النوع من اللوازم يسمى اللازم الذهني؛ لأن اللوازم ثلاثة أنواع: لازم خارجي فقط، ولازم ذهني فقط، ولازم ذهني وخارجي معا؛ كما قال عبد السلام في توشيحه على السلم:
في الذهن والخارجِ لازمٌ دُعي ..... مثالُه زوجيَّةٌ للأربعِ
ولازمُ الذهنِ فقط كالبصَرِ ...... له العمى مُستلزِم التصوُّر
ولازمُ الخارج كالسوادِ ........ للزنجِ والغرابِ أمرٌ بادِ
وقوله (نُكِبت) أي أصبت بنكبة، كما سيأتي.ولازمُ الذهنِ فقط كالبصَرِ ...... له العمى مُستلزِم التصوُّر
ولازمُ الخارج كالسوادِ ........ للزنجِ والغرابِ أمرٌ بادِ
[191- وَكَمْ تَرَى مِنْ رَجُلٍ مَنْكُوبِ ..... بِحَادِثٍ وَأَلَمٍ مُصِيبِ]
هذا البيت مثال على الفعل (نُكِبَ يُنْكَبُ نَكْبًا)، فهو (منكوب)، وأصابته (نَكْبة)، وهي المصيبة أو الحادث أو الألم كما هو ظاهر من تمثيل الناظم؛ ومن المترادفات أيضا في هذا الباب ما ذكره ابن نبهان الحضرمي في نظم المترادف بقوله:
كعَثْرةٍ تورُّطٌ ونكبةُ ...... بليَّةٌ ومِحنةٌ وسَقْطةُ
وزَلَّةٌ وهَفْوةٌ وكَبْوةُ ...... وفَلْتةٌ وفَرْطةٌ ونَبْوةُ
مصائبٌ ومثلُها الخُطوبُ ....... مُلِمَّة نوائبٌ تنوبُ
بَواتِرٌ جَوائِحٌ قَواصِمُ ....... بَوائقٌ قَوارِعٌ عَظائِمُ
فَجائِعٌ نَوازِلٌ رَزايا ....... عنَّا اصرِفَنَّ الكل يا مولايا
وذهب بعض العلماء إلى أن (نُكِبَ) مشتق من (المَنكِب) أي كأنه قد أصيب منكبُه، وقد تكرر ذكر المنكب في الحديث كثيرا؛ كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه.وزَلَّةٌ وهَفْوةٌ وكَبْوةُ ...... وفَلْتةٌ وفَرْطةٌ ونَبْوةُ
مصائبٌ ومثلُها الخُطوبُ ....... مُلِمَّة نوائبٌ تنوبُ
بَواتِرٌ جَوائِحٌ قَواصِمُ ....... بَوائقٌ قَوارِعٌ عَظائِمُ
فَجائِعٌ نَوازِلٌ رَزايا ....... عنَّا اصرِفَنَّ الكل يا مولايا
وبوَّب البخاري في صحيحه (باب من يُنكَب في سبيل الله)، وفي صحيح مسلم عن جندب بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم (نُكِبَت إصبعُه) أي أصيبت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
هل أنتِ إلا إصبَعٌ دَميتِ ........ وفي سبيل الله ما لَقِيتِ
وبعض الناس يخطئ في نطق هذا الحديث، فيقول: (هل أنتَ إلا إصبع دميتَ ..).وفي حديث أبي هريرة عند مسلم (في كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها).
[192- وَحُلِبَتْ نَاقَةُ زَيْدٍ تُحْلَبُ ..... وَقِيلَ فِي الْمَصْدَرِ مِنْهُ: الْحَلَبُ]
تقول (حَلَب الناقةَ) بفتح اللام في الماضي، (يحلُبها) بضم اللام في المضارع، وهو أشهر من كسرها.
ونص كلام ثعلب (حُلِبت ناقتُك وشاتُك)، فحذف الناظم (الشاة) واكتفى بالناقة، وصنيع الناظم أحسن وأقرب للفهم؛ لأن الحلب لا يقتصر على الناقة والشاة بل يشمل البقر، فالجادة أن يُكتفى في التمثيل بواحد، أو يحصر الجميع إن أريد الحصر، أما التمثيلُ باثنين فقد يوهم السامع أن الحلب يقتصر استعماله على الناقة والشاة.
وقياس المصدر أن يكون (حَلْبًا) بسكون اللام؛ كما قال ابن مالك:
فَعْلٌ قياس مصدر المعدى ....... من ذي ثلاثة كرد ردا
لكن المسموع في مصدر هذا الفعل هو الحَلْب بسكون اللام والحَلَب أيضًا بفتح اللام، وبعض العلماء قال: الصواب الفتح فقط ولا يجوز التسكين، وأشار إليه الناظمُ بقوله (وقيل في المصدر منه الحَلَب)، وفيه قول آخر سيأتي في البيت القادم.
[193- وَقِيلَ: إِنَّ الْحَلَبَ الْحَلِيبُ ..... مِنْ لَبَنٍ وَذَلِكَ الْمَحْلُوبُ]
هذا البيت تتمة للبيت السابق الذي أشار فيه الناظم إلى أن المصدر قيل فيه (حلَب) بفتح اللام، أي وقيل أيضًا إن هناك فرقًا بين (الحلْب والحلَب)؛ فالأول هو المصدر والثاني: هو الحَلِيب أي اللبن، وهو فعيل بمعنى مفعول، وإليه أشار الناظم بقوله (وذلك المحلوب).
[194- وَرُهِصَ الْحِمَارُ أَوْ سِوَاهُ ..... بِحَجَرٍ فِي حَافِرٍ آذَاهُ]
تقول (رهَص الحجرُ الحمارَ) بفتح الهاء في الماضي، (يرهَصه) بفتح الهاء في المضارع، هكذا مقتضى القياس لوجود حرف الحلق، ولم أقف على ضبط المضارع في كتب اللغة.
ونص ثعلب (رهصت الدابة) فغيرها الناظم إلى (الحمار) لأنه هو الدابة في العرف، ولأن المقصود التمثيل لا الحصر اتفاقا، ومراد ثعلب أن الأفصح بناء هذا الفعل للمجهول، لأنه قد يقال أيضا (رَهِصت الدابة) و(أرهصت)، وكله جائز لكن ما ذكره ثعلب أفصح.
[195- وَقِيلَ فِي الرَّهْصَةِ: مَاءٌ يَنْزِلُ ..... فِي رُسْغِهِ؛ كِلاَهُمَا يَحْتَمِلُ]
وقع في المطبوع (رصغه) بالصاد سهوًا، والصواب (رسغه) بالسين، وكذلك هو في النسخ المخطوطة وفي مخطوط الشرح أيضا. وإن كان (الرصغ) بالصاد لغة، لكنه بالسين أفصح وأشهر، وبعض العلماء جعل الصاد من كلام العامة.
وقد وقع هذا البيت في المطبوع بعد البيت الآتي، والأنسب فيما أرى أن يكون هذا موضعه؛ لأنه ما زال في تفسير اللفظ لم ينته منه، وكذلك وقع الترتيب في أضبط النسخ المخطوطة وفي مخطوط الشرح أيضا. وقد سقط البيتان جميعا من بعض النسخ.
والمقصود من البيت كما هو ظاهر ذكر تفسير آخر أو معنى آخر لـ(رُهِص الحمار) أو (رُهِصت الدابة)؛ لأن بعض العلماء قال إن (الرهصة) هي الإصابة بالحجر أو نحوه، وبعضهم قال: (بل هو مرض يصيب الدابة ينتج عنه ماء يوجد في رسغها، فيداوى باستخراجه).
[196- فَقُلْ: رَهِيصٌ مِنْهُ أَوْ مَرْهُوصُ ..... كِلاَهُمَا فِي وَصْفِهِ مَنْصُوصُ]
وقع هذا البيت في المطبوع قبل البيت السابق كما بينتُ فيه.
ونص كلام ثعلب (فهي –أي الدابة- مرهوصة أو رهيص) ومنه يظهر أن هذا الفعل جار على القياس في بنائه للمفعول، وليس فيه شذوذ من هذه الجهة، وقول الناظم (كلاهما في وصفه منصوص) أي أن ثعلبا قد نص عليها في الفصيح، فلا تعترض عليه بأن هذا البيت لا داعي له لأنه مجرد تصريف قياسي؛ كما تقول (جُرِح فهو مجروح وجريح)، و(قتل فهو مقتول وقتيل)، و(كُسِر فهو مكسور وكسير)، وقد استفدنا من كلام ثعلب فائدة زائدة على كلام الناظم، وهو أن وزن (فعيل) يستعمل بغير تاء للمذكر والمؤنث.