الوحدة السياسية التي ظهرت عند تتويج أوتو الأول في روما 962، واستمرت إلى أن تنازل فرانسيس الثاني عن اللقب الإمبراطوري 1806، وتذهب وجهة النظر الأوروبية الغربية إلى أن الإمبراطورية الرومانية التي أسسها أوغسطس لم تنته بل توقفت بتنازل آخر إمبراطور روماني 476، وأن شارلمان قد أحيا 800 ثم أعاد أوتو إحياءها 962، وأن كلا هذين الآخرين وريثا أوغسطس الشرعيان. وكانت هذه الدعوى تناقض دعوى الأباطرة الشرقيين (أنظر: الإمبراطورية البيزنطية) الذين ذهبوا إلى أنهم هم وحدهم أصبحوا 476 أصحاب اللقب الإمبراطوري الشرعيين، وما حدث في الواقع هو أن كلا من فريقي البيزنطيين والغربيين اعترف عموماً بالآخر في دائرة نفوذه، كما أن التزاوج بين الأسر الحاكمة الشرقية والغربية كان شيئاً مألوفاً. وكان اللقب الإمبراطوري قد انتقل من شارلمان إلى لويس الأول فلوثير الأول فلويس الثاني فشارل الثاني فشارل الثالث فآرنولوف (ت 889 )، أما لويس الثالث ( ت 924 ) ملك بروفانس، وبرنجار الأول ( ت 924 ) ملك إيطاليا فقد اتخذا اللقب الإمبراطوري دون أن يمارسا أية سلطة، وحلت الفوضى محل وحدة أوروبا الغربية المسيحية التي أقامها شارلمان. وكانت الذكرى الحية للإمبراطورية الرومانية العالمية، ولعظمة الكارولنجيين والحاجة التي أحس بها الناس عامة للوحدة المسيحية للوقوف في وجه هجمات الوثنيين والمسلمين، والانحطاط المتناهي الذي بلغته البابوية لعدم وجود مدافع قوى عنها – هذه كلها كانت من العوامل التي مكنت لبعث الفكرة الإمبراطورية، عندما ذهب أوتو الأول ملك الألمان إلى إيطاليا لمعاقبة برنجار الثاني وليتوجه البابا إمبراطوراً وهكذا اتحدت إيطاليا وألمانيا في ظل حاكم واحد، وأضيفت إليهما (1033 ) مملكة آرل وكانت النظرية تقول بأن الإمبراطور هو النائب الزمني لله على الأرض، والبابا هو النائب الروحي، وأن الإمبراطور هو الحاكم الزمني الأعلى للعالم المسيحي ويتسلم شارات منصبه، وهي التاج الإمبراطوري والصولجان والكرة ( الممثلة للعالم ) من البابا. والواقع أن سلطة الإمبراطور لم تبلغ قط مثل هذا الحد. فقد استمر الاعتراف بأن الأباطرة أعلى مرتبة من غيرهم من الحكام حتى القرن 18، لكن هذا أصبح من قبيل التقاليد الرسمية الدبلوماسية، وتوقف الاعتراف بسيادتهم في فرنسا وجنوبي إيطاليا والدنمارك وبولندا والمجر في وقت مبكر، أما في إنجلترا والسويد وإسبانيا فالأرجح ألا يكون قد حمل يوماً محمل جد. ومع هذا ظلت الإمبراطورية الرومانية المقدسة إلى القرن 16 على الأقل مجموعة دولأوروبية، وكان الأمراء الإنجليز والفرنسيون والأسبان يسعون في مختلف المناسبات إلى الحصول على التاج في الانتخابات الإمبراطورية، وكانت سلطة الأباطرة في ألمانيا وإيطاليا تختفي أحياناً أخرى. أما في مملكة آرل فقد اغتصبت فرنسا السلطة بالتدريج، واختلفت حدود الإمبراطورية الرومانية المقدسة خلال تاريخها فلم تدخل بعض الأقطار (مثل المجر) في نطاقها، بالرغم من أن تلك الأقطار كانت تحت حكم أباطرة الإمبراطورية وأمرائها. وبالعكس كانت أقطار أخرى (مثل الفلاندر وبوميرانيا وشلزويج وهولشتين)، تعتبر في حقب مختلفة في نطاق الإمبراطورية مع أنها كانت تحت حكم ملوك أجانب (على أن هؤلاء كانوا يشتركون في مجالس الديت الإمبراطورية ويتسلمون أراضيهم من الإمبراطور)، وكانت الإمبراطورية تضم ألمانيا والنمسا وبوهيميا ومورافيا وأجزاء من شمالي إيطاليا وبلجيكا الحديثة والأراضي المنخفضة (حتى 1648)، وسويسرا (حتى 1648)، وكان الأباطرة ينتخبون بحسب إجراء نظمه المنشور البابوي الذهبي 1356، وكان منصب الإمبراطور (شأن أكثر المناصب الأخرى حتى وقت قريب) ورائياً على العموم. إذ غالباً ما كان الناخبون ينتخبون وريث الإمبراطور المتوفى خلفاً له، وبقي التاج في آل هابسبرج منذ (1438). ونظرياً لم يكن صاحب المنصب يتمتع بالمقام الإمبراطوري حتى يتوجه البابا، ولهذا اعتاد الملوك الألمان أن يقصدوا روما بعد انتخابهم ليجري تتويجهم، وأن يفرضوا بهذه المناسبة سيطرتهم على إيطاليا، وقام كثير من الأباطرة، وهم أحياء، بانتخاب ورثتهم وتتويجهم ملوكاً على الرومان ( أي ملوكاً ألمانيين)، وذلك لضمان اعتلائهم العرش الإمبراطوري. وكان تتويج الشخص ملكاً ألمانياً يجري عادة في آخن. وقد توج أيضاً عدد من الأباطرة الأوائل ملوكاً عل إيطاليا بتاج اللومبارد الحديدي في مونزا أو ميلان، وثمة عدد كبير من الأباطرة المنتخبين لم يتوجهم البابا مطلقاً، بل لقد توقف هذا التقليد بعد تتويج شارل الخامس (1530)، واتخذ الأباطرة المتأخرون اللقب دون تصديق من البابا، وتوجوا في فرانكفورت. وقد أحاط بمنصب الإمبراطور منذ البداية إشكالات متعددة، فلقد قام بين الأباطرة بصفتهم ملوكاً كهنة وبين البابوية، نزاع لم ينشأ من مسألة تقليد السلطة (سويت هذه المسألة 1122) فحسب، بل من جميع العلاقات بين السلطتين الروحية والزمنية أيضاً. وبلغ النزاع أوجه في الكفاح الهائل الذي نشب بين الإمبراطورين فردريك الأول (1152 – 90)، وفردريك الثاني (1212 – 50) من جهة والباباوات الإسكندر الثالث وجريجوري التاسع وأنوسنت الرابع من جهة أخرى. وانتصرت البابوية وكف الأباطرة عن التدخل جدياً في شؤون البابوية إلا خلال الانشقاق الديني الكبير في القرن 15. وخلال الحروب الإيطالية في القرن 16. وثمة أشكال ثان مرتبط بالأول، وهو الثنائية الطبيعية في حكم قطرين – هما ألمانيا وإيطاليا – منفصلين انفصالاً عميقاًجغرافياً وثقافياً وسياسياً، فقد كان الإقطاع غالباً على ألمانيا، كان هذا القطر من زمن أوتو الأول إلى عهد فردريك الأول منقسماً إلى عدة دوقيات كبيرة، ( مثل بافاريا وسكسونيا وفرانكونيا وثرنجيا واللورين العليا والدنيا ) غالباً ما مارس أسيادها ( لورداتها ) سلطة أكبر من سلطة مقطعيهم، وتجزأت هذه الدوقيات بعد ثورة هنري الأسد، وانقسمت إلى وحدات أصغر بلغ عددها 300 (1648)، وبالرغم من أن الأباطرة كانوا يجدون مشقة كبيرة في حفظ وحدة ألمانيا وحمايتها من هجمات الأجانب، فقد حاولوا مراراً فرض سيطرتهم على إيطاليا في وجه مقاومة المدن، التي كادت تكون مستقلة تمام الاستقلال، ومطالب الباباوات الزمنية والنبلاء المتمردين. وهكذا فشل فردريك الأول في كسر شوكة عصبة اللومبارد التي كان البابا يؤيدها. وكان فردريك الثاني، الذي سبق أن ورث نابولي وصقلية حاكماً إيطاليا أكثر منه ألمانيا، فقد ترك ألمانيا وشأنها خلال إقامته في بالرمو. وقوض نزاعه مع البابوية وما قابله من صراع بين الجولفيين والجبللينيين السلطة الإمبراطورية في إيطاليا أيضاً. وعندما توفي وريثه كونراد الرابع ( 1254 ) خلا العرش مدة 19 سنة. فانقسمت الأحزاب واختار بعضها ريتشارد أيرل كورنول، واختار الآخرون ألفونسو العاشر ملكاً على ألمانيا، لكن لم يستطع أي منهما أن يحكم فعلاً. فعمت الفوضى، وعاد البارونات قطاع الطريق والنبلاء المتناصرون، الذين كان قد كبح جماحهم بعض الشيء منذ القرن 11، إلى نشر الإرهاب في البلاد. على أن انتخاب 1273 رودولف الأول، أول ملك ألماني من آل هابسبرج، أرجع بعض النظام إلى البلاد، لكن عاد الملوك بعد موته إلى التنافس في الانتخابات، وزادت الحروب الهوسية التي قامت في القرن 15 ولم تنته حتى القرن 16، من حدة الاضطراب الاجتماعي حين أخمدت ثورة صفار النبلاء، الذين تزعمهم فرانز فون سكنجن وأخضع المزارعون الثائرون في حرب الفلاحين، وفي هذه الأثناء كانت المدن الألمانية قد زادت غنى وسطوة، وقلدت المدن الإيطالية في الانتظام في قومونات وعصبات للدفاع عن نفسها. وشجع الأباطرة المدن ومنحوها براءات سخية الشروط، وذلك لخلق قوة توازن قوة النبلاء. وأدى هذا إلى أن كثيراً من المدن ( مثل فرانكفورت ونورمبرج وأوجسبرج ) أصبحت مدناً إمبراطورية حرة – أي جمهوريات تخضع لتشريع الإمبراطور مباشرة – وأخذت تمثل في مجلس الديت. وكان العامل الرئيسي الذي أدى إلى نجاح الأباطرة في الاحتفاظ ببعض السلطة هو مساعدة المدن التي كانت أغنى عناصر الإمبراطورية ومناصرة الأمراء الدينيين العظام (كرؤساء الأساقفة الناخبين لمينز وتربير وكولون وأساقفة وورزبرج وبامبرج وسالزبرج )، الذين كان يعينهم الإمبراطور. وكانت سلطة الأباطرة تعتمد أيضاً على سعة دوميناتهم الموروثة وثروتها، فكانت أسرة لوكسمبرج ( هنري السابع وشارل الرابع ونسسلاوس وسجسمند ) مثلاً تهتم في الأغلب ببوهيميا المملكة التي كانت تتوارثها الأسرة. أما آل مابسبرج فعنوا عناية مطردة بتوسيع إمبراطوريتهم الموروثة الكبيرة، والاحتفاظ بها على حساب وحدة الإمبراطورية الرومانية المقدسة. على أن شارل الرابع رفع كثيراً من المقام الإمبراطوري عندما صدر المنشور البابوي الذهبي، وأدخل مكسمليان الأول إصلاحات دستورية هامة بناء على طلب مجلس الديت، وشملت هذه الإصلاحات إنشاء مجلس وصاية كان يقوم مقام وزارة، وتأسيس محكمة عدل إمبراطورية، لكن هاتين المؤسستين كانتا في الواقع أقل أهمية من ديوان العدل النمساوي في ڤيينا (التي جرى الأباطرة على اتخاذها مقراً منذ 1438)، ومجلس البلاط (مجلس الإمبراطور الخاص)، وبعد اعتلاء شارل الخامس العرش (1519)، وبخاصة من بدء حكم فردناند الأول (1558) أصبحت شؤون الإمبراطورية مقصورة تقريباً على شئون البيت النمساوي الحاكم. وجاء الإصلاح الديني فقوى هذا الاتجاه، وذلك بتأليبه الأمراء البروتستانت الألمان على الأباطرة، الذين كانوا قد أخذوا على عاتقهم حماية الكاثوليكية، ومع أن شارل الخامس هزم حلف شمالكلد البروتستانتي (1547) فإن انتصاره لم يدم. وفي حرب الثلاثين (1618 – 48) ( انظر أيضاً: فردناند الثاني وفردناند الثالث ووالنشتاين والاتحاد البروتستانتي )، واجه الإمبراطور الذي كان قد حالف إسبانيا الأمراء البروتستانت وحلفاءهم الرئيسيين وهم السويديون والفرنسيون، وانتهت هذه الحرب بانحلال الإمبراطورية (انظر: وستفاليا، صلح) انحلالاً يكاد يكون تاماً. وحصل جميع أمراء المقاطعات في الإمبراطورية، وكانوا أكثر من 300 على سيادة إقليمية لم يكن يحد منها سوى شروط غامضة تمنعهم من الانضمام إلى محالفات موجهة ضد الإمبراطور. وأصبح مجلس الديت عاجزاً عن العمل، كما أصبح لقب الإمبراطور فخرياً في الأغلب. وبالرغم من هذا كله فقد حافظت الإمبراطورية على المظاهر الخارجية وظل الأباطرة بفضل أراضيهم المتوارثة حكاماً أقوياء. ولم يكن للصلح من أثر سوى إعطاء صبغة قانونية للأوضاع السائدة، منذ نجاح حركة الإصلاح الديني، التي حطمت حلم المتطلعين إلى تحقيق وحدة سياسية لأوروبا المسيحية، والتي شجعت مبدأ القومية، وهو مبدأ غريب بالكلية على الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وزادت مكانة الأباطرة تدنياً بسبب الحروب التي خاضوها ضد لويس الرابع (انظر: الحروب الهولندية، الحلف الأعظم، حرب الوراثة الإسبانية)، ولم تعوض عن هذا التدني استعادة المجر من الأتراك. وانكشفت تفاهة المفهوم الإمبراطوري في حرب الوراثة النمساوية (1740 – 48)، وحرب السنين السبع (1756 – 63) وضمت وفاة الإمبراطور شارل السادس (1740) سلسلة الذكور المنحدرين من آل هابسبرج، واختير ناخب باڤاريا (1742) إمبراطوراً باسم شارل السابع، بينما قامت ماريا تريزا التي كانت قد ورثت ممتلكات آل هابسبرج بموجب وثيقة اسمها « البراجماتك سانكشن » بالدفاع عن ميراثها في وجه مطالب البروسيين والبافاريين والسكسون، وفي وجه فرنسا وإسبانيا. وفي 1745 ترك ناخبو سكسونيا وبافاريا الحرب، وأيدوا انتخاب فرانسيس الأول زوج ماريا تريزا، إلا أن بروسيا عادت فدخلت مرة أخرى 1756 في حلف ضد النمسا، وخرجت من صلح هوبرثبرج (1763) أقوى دولة في الإمبراطورية، وكان جوزيف الثاني خليفة فرانسيس الأول حاكماً لامعاً، قام بشؤون منصبه خير قيام، وسعى إلى إعادة تنظيم بقايا الإدارة الإمبراطورية وجعلها مركزية، وقد فشل لأسباب منها اندفاعه ومنها – وهو الأهم – مقاومة بروسيا له. وبعد وفاته بسنتين بدأت حروب الثورة الفرنسية. وقد أدت معاهدة لونڤيل (1801) التي فرضتها فرنسا، إلى إعادة تنظيم الإمبراطورية من كل وجه، ومهدت إلى انحلالها بشكل نهائي. وخلع مجلس الديت أكثر الأمراء 1803، وعوضهم عما فقدوه. وبهذا قل عدد الولايات وازداد اتساعها، وانتهى الأمر بهذه الولايات أن انضمت (1806) إلى حلف الراين تحت حماية نابليون الأول. واتخذ الإمبراطور فرانسيس الثاني لقب فرانسيس الأول إمبراطور النمسا 1804، وتنازل عن تاج الإمبراطورية الرومانية المقدسة 1806. ولم يطل عمر إمبراطورية نابليون الأول الذي، قصد أن يكون خلفاً لشارلمان، ولا نستطيع أن نعد الإمبراطورية الألمانية بين سنتي (1871 – 1918) أو الرايخ الثالث (إمبراطورية الرايخ) خليفتين للإمبراطورية الرومانية المقدسة، لأنهما قامتا على أساس القومية لا العالمية. وفيما يلي قائمة بالأباطرة والملوك الألمان من 936 إلى 1806، وتشير التواريخ بين الأقواس إلى حكمهم كملوك ألمان: الأسرة السكسونية، أوتو الأول (936 – 73)، أوتو الثاني (973 – 83)، أوتو الثالث (983 – 1002)، هنري الثاني (1002 – 24). الأسرة السالية أو الفرنكونية، كونراد الثاني (1024 – 39)، هنري الثالث (1039 – 56)، هنري الرابع (1056 – 1105)، هنري الخامس (1105 – 25)، لوثير الثاني (1125 – 37) (دوك سكسونيا). أسرة هوهنشاوفن ومنافسوها، كونراد الثالث (1138 – 52)، فردريك الأول (1152 – 90)، هنري السادس (1190– 97)، فيليب السوابي (1198– 1208)، وأوتو الرابع ( ملك منافس، 1198 – 1208) ( ملك 1208 – 12) ( إمبراطور 1209 – 15)، جولفي فردريك الثاني (ملك 1212 – 37) ( إمبراطور 1220 – 50)، كونراد الرابع (1237 – 54) وملوك معاكسون، هنري راسب (1246 – 47)، ووليم كونت هولندا (1247 – 56) فترة خلو العرش (1254 – 73) ريتشارد إيرل كورنول وألفونسو العاشر (القشتالي) كانا متنافسين، هابسبرج لوكسمبورج وأسر حاكمة أخرى: رودولف الأول (1273 – 91 هابسبرج)، أدولف ناسو (1292 – 98)، ألبرت الأول (1298 – 308 هابسبرج)، هنري السابع (1308 – 13 لوكسمبورج)، لويس الرابع (1314 – 46 وتلسباخ)، شارل الرابع (1346 – 78 لوكسمبورج)، ونسلاوس (1378 – 1400 لوكسمبورج)، روبرت (1400 – 1410 وتلسباخ)، سجسمند (1410 – 37 لوكسمبورج). أسرة هابسبرج، ألبرت الثاني (1438 – 39)، فردريك الثالث (1440 – 93)، مكسمليان الأول (1493- 1519)، شارل الخامس (1519 – 58)، فردناند الأول (1558 – 64)، مكسمليان الثاني (1564 – 76)، رودولف الثاني (1576 – 1612)، ماتياس (1612 – 19)، فردناند الثاني (1619 – 37)، فردناند الثالث (1637 – 57)، ليوبولد الأول (1658 – 1705)، جوزيف الأول (1705 – 11)، شارل السادس (1711 – 40). فترة خلو العرش (1740 – 42)، شارل السابع (1742 – 45 وتلسباخ – هابسبرج)، فرانسيس الأول (1745 – 65)، لورين ( زوج ماريا تريزا ) أسرة هابسبرج: لورين جوزيف الثاني (1765 – 90)، ليوبولد الثاني (1790 – 92)، فرانسيس الثاني (1792 ـ 1806) انظر: هـ. أ. ل. فيشر: الإمبراطورية في العصور الوسطى (1898).
الإمبراطورية الرومانية:
الحجم

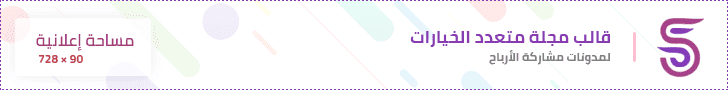

إرسال تعليق