1.3 - معنى التصوف :
من المعلوم في التاريخ الإسلامي أن الشريعة عند المسلمين قسمان أحدهما يختص بعلم الظاهر وهو علم الفقه والمشتغل به يدعى بالفقيه، والثاني يختص بعلم الباطن وهو ما يعرف بعلم الآخرة أو فقه القلوب أو علم التصوف والذي يمارس هذا العلم ويشتغل به يعرف بالصوفي هذا التقديم المنهجي يجعلنا نطرح مجموعة من الأسئلة البيانية الهادفة والمتمثلة فيما يلي ، ما معنى التصوف ومتى ظهر عند المسلمين وما هي أنواعه. وقبل البحث عن إجابة هذه الأسئلة والمتعلقة ببيان معنى التصوف وحقيقته وتعريفه في معطاه العلمي، لابد من الوقوف عند اشتقاق الكلمة كما هي واردة في كتب التاريخ والمؤلفات الأدبية ، والدينية ، فتواجد لفظة التصوف في هذه الكتب هيمن نقاش جدلي حام حوله اختلاف في الرؤى والنظر في محتوى جوهر هذه اللفظة فحمل مضمون اختلاف هذا النظر أربعة فروض :
1. الفرض الأول : تكون كلمة تصوف منسوبة إلى صوفة والثاني تكون منسوبة إلى الصوف، والثالث تكون مشتاقة من الصفا، والرابع تكون منسوبة إلى كلمة سوفيا " اليونانية "
الفرض الأول وهو المنسوب إلى صوفة ويقال الصوفي نسب إليه وهو الاسم الذي يطلق على الرجل الذي تميز عن أفراد قومه بالتفرد في خدمة الله سبحانه وتعالى وعند بيته الحرام وهذا الرجل اسمه غوث بن مر فأنتسب لفظ الصوفية إليه لمشابهتهم إياه في الفعل وسلك السلوك والمتمثل في الانقطاع إلى الله عبادة وتهجدا ، وتفردا وتنزها ، وشوقا ... يقول ابن الجوزي ( ت 597ه 1200م) في ذلك " أنبأنا محمد بن ناصر عن أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال قال : قالأبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ : سألت وليد بن القاسم : إلى أي شيء ينسب الصوفي ، فقال: كان قوم في الجاهلية يقال لهم صوفة ، انقطعوا إلى الله عز وجل وقطنوا الكعبة، فمن تشبه بهم فهم الصوفية ، فقال عبد الغني ، فهؤلاء المعرفون بصوفة، ولد الغوث بن مر بن أخي تميم بن مر. وبالإسناد إلى الزبير بن بكار قال ، كانت الإجازة بالحج للناس من عرفة إلى الغوث بن مر بن أود بن طانجة، ثم كانت في والده، وكان يقال لهم صوفة، وكان إذا حالت الإجازة قالت العرب : أجز صوفة ، قال أبو عبيدة وصوفة وصوفان ، يقال الكل من ولي البيت شيئا من غير أهله ، أو قام بشيء من أمر المناسك ، قال الزبير : حدثني أبو الحسن الأثرم عن هشام بن محمد السائب الكلبي قال: إنما سمي الغوث بن مر صوفة ، لأنه ما كان يعيش لامه ولد ، فنذرن لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة ، ولتجعله ربيط الكعبة، ففعلت فقيل له صوفة ، ولوده من بعده قال الزبير وحدثني إبراهيم بن المنذري، عن عبد العزيز بن عمران قال : اخبرني عقال ابن شبة قال : قالت أم تميم بن مر، فلما ربطته عند البيت اصابه الحر، فمرت به وقد سقط واسترخى ، فقالت : ما صار ابني إلى صوفة، فسمي صوفة، وكان الحج واجازة الناس من عرفة إلى منى، ومن منى إلى مكة للصوفة، فلم تزل الإجازة في عقب صوفة، حتى أخذتها عدوان، فلم تزل في عدوان حتى أخذنه قريش . " هذا الكلام السابق والهادف في موضوعه ، والمهم في نتيجته ، لم يكن نسيج خيال ابن الجوزي ، أو من اختراعه وإنما كان معروفا وأشار إليه الزمخشري في أساس البلاغة ، وكذلك الفيروز آبادي في كتابه القاموس المحيط . ، وما تخبرنا به كتب الأدب الجاهلي وتاريخه أن ظاهرة السلوك العرفاني والعبادة والتنسك كانت معروفة في الجاهلية ذكر ياقوت الحموي (ت 626ه1228م ) عن حنظلة بن آبى عفراء الذي بنى دير حنظلة قريبا من شاطئ الفرات " وكان قد نسك في الجاهلية وتنصر وبنى هذا الدير فعرف به " وقد كانت في الجاهلية لفظة الديان تقابل اليوم لفظة التصوف وهي لفظة تعني المتنسك في الدين ومثله الرباني وهي كلمة قديمة في التراث الإنساني إذ عرفت وجودا في اللسان العربي، واللسان السرياني، وظلت هذه اللفظة من ألفاظ التمجيد ، وقد وصف التصوف بالرهبنة والزهد حتى أنه روي عن النبي أنه قال " لا صام من صام (الأبد ) " فصيام الأبد نوع من التصوف وقد كان موجودا في عهد النبي لذلك نهى عنه والذين كانوا يصومون الأبد وكانوا يحيون سنة جاهلية يظنون أنها من كمال الدين ورقي الروح وتزيينها وابتعادها عن ملذات الدنيا وغرائزها الحيوانية فالتصوف قد عرف في الجاهلية ، وعرف له وجود متمثل في الممارسة لدى البعض في الإسلام وهذا ما تقول به كثير من المصادر الأدبية والدينية والاجتماعية .
2. الفرض الثاني : ينص على أن كلمة الصوفية والصوفي منسوبة إلى الصوف وقد نجد هذا الفرض أصح الفروض من حيث الاشتقاق، لأن أغلب المصادر التاريخية تذكره، فلباس الصوف كان غالبا على المتقدمين من سلف الصوفية لأنه أقرب إلى الخمول والتواضع والزهد، وأيضا أنه لباس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد قيل أن رسول الله كان يركب الحمار ويلبس الصوف، وعنه، أنه قال، مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبيا حفاة عليهم العباء يؤمون البيت الحرام وعنه ا،ه قال يوم كلم الله تعالى موسى عليه السلام كان عليه جبة من الصوف وسروال من الصوف ، وقبل أن عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف والشعر ويأكل من الشجر ويبيت حيث أمسى وقال الحسن البصري، رضي الله عنه لقد أدركت سبعين بدريا كان لباسهم الصوف هذا الكلام السابق يدل ويثبت على أن الأنبياء والصالحين كانوا يؤثرون لبس الصوف، وقد روي عن النبي (ص) أنه قال : " من لبس الصوف وأكل خبز الشعير، وركب الأتان ، فليس فيه شيء من الكبر " وروي عنه أيضا أنه قال : " البسوا الصوف وشمروا وكلوا في أنصاف البطون تدخلوا في ملكوت السماء " وقد جاء في مرثية عمر لرسول الله إذ قال : " بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، لقد اتبعك في قلة منك، وطول عمره ، ولقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا القليل، بأبي أنت وأمي، يا رسول الله، ولو لم تجالس كفؤا لك ما جالستنا ولو لم تنكح إلا كفؤا لك، ما نكحت إلينا، ولو لم تواكل كفؤا ما واكلتنا، فلقد والله جالستنا ونكحت إلينا ، وواكلتنا ، ولبست الصوف ، وركبت الحمار، وأردف خلفك، ووضعت طعامك على الأرض، ولعقت أصابعك، تواضعا منك " يمثل النص السابق قيمة معرفية تحمل الصدق لاعتبار أن الصوفية لبسوا الصوف في بادئ الأمر للإقتداء بالنبي في تواضعه ولا سيما إذا تذكرنا أن الرسول أقبل على أهل الصفة فواساهم ولم يكن عندهم غير جباب الصوف. ويمثل لبس الصوف مظهرا من مظاهر التخشن والتقشف بالإضافة إلى مظهر الذل والمهانة، فقد حدث المبرد أن محمد بن جعفر بن يحي بن خالد بن برمك قال : قال أبي لأبيه يحي بن خالد بن برمك _ وهم في القيود والحبس _ يا أبت بعد الأمر والنهي والأموال العظيمة، أصابنا الدهر إلى القيود ولبس الصوف والحبس " فليس الصوف هنا علامة الذل وسوء الحال ، وفي هذا المعنى قول أبي تمام في تقلب الزمان :
كانوا يرود زمانهم فتصدعوا فكأنما لبس الزمان الصوفا
وقول أبي فراس الحمداني يخاطب سيف الدولة بن حمدان قائلا:
يا واسع الدار كيف توسعها ونحن في صخرة نزلزلها
يا ناعم الثوب كيف تبدله ثيابنا الصوف ما نبدلها
وقول الشريف الرضي في وصف أباه بالوقار :
ما التذ لبس الصوف إلا من تعمم بالقتير
متخدد الخدين مغبر الذوائب والضفور
أسر الوقار طماحه والقد أملك بالأسير
وكتب على أحد جدران جوانب دير الهند هاته الأبيات الشعرية
إن بني المنذر عام انقضوا بحيث شاد البيعة الراهب
تنفح بالمسك ذفارتهم وعنبر يقطبه القاطب
والقز والكتان أثوابهم لم يجب الصوف لهم جائب .
ومعنى هذا أن لبس الصوف كان يعيب المياسير وقد ذكر ياقوت الحموي أن إبراهيم ابن أدهم كان من أبناء الملوك، فخرج يوما متصيدا فأثار ثعلبا أو أرنبا وهو في طلبه فهتف به هاتف يا إبراهيم ألهذا خلقت ؟ أم بهذا أمرت ؟ ثم هتف به أيضا من قر بوس سرجه والله ما لهذا خلقت، ولا بهذا أمرت فنزل عن دابته وصادف راعيا لأبيه فأخذ جبة الراعي من صوف ولبسها وأعطاه فرسه وما معه، ثم أنه دخل البادية، ثم دخل مكة، وصحب بها سفيان، والثوري،
و الفضيل بن عياض، ودخل الشام ومات بها، وكان يأكل من عمل يده مثل الحصاد وحقل البساتين وغير ذلك ..." فالصوف هو لباس لرعاة، وابن ادهم حين جاءه الهاتف ، ترك ما يملك ، وكان المتاع والفرس ، والإمارة وتصوف أي لبس الصوف ليلتحق بالزهاد وقيلت فيه قصص غريبة كلها تصب في زهده من الدنيا وزخرفها. وقال عبد الله ابن شداد : " أربع من كن فيه بريء من الكبر : من اعتقل البعير، وركب الحمار، ولبس الصوف، وأجاب دعوة الرجل الدون " إن هذا الكلام أثبته الجاحظ في كتابه البيان والتبين وأن هذا الكلام يبرهن على صحة ما نقلناه من رثاء عمر بن الخطاب للرسول فقد ثبت عن النبي ركب الحمار ولبس الصوف، ويذكر الإمام القشيري في رسالته في باب التصوف تعريفات لأهل التصوف منها التصوف نسبة للقوم آثروا الله عز وجل على كل شيء فآثرهم الله عز وجل على كل شيء " ، ومنها استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد، وسئل الجنيد عن التصوف فقال هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة " وأنشد أبو حيان في جاهل لبس صوفا وزها فيه :
أيا كاسيا من جيد الصوف نفسه ويا عريا من كل فضل ومن كيس
أتزهي بصوف بالأمس مصبح على نعجة واليوم أمسى على تيس
والحقيقة أن كلمة الصوف هي علامة سيمائية نعني بها الزهد وهو المراد
بزي الصوفية الذي وصف به المقري أحد الفقهاء وكذلك أن كلمة الصوف هي شعار الصالحين ، وتدل على الورع والخوف أيضتا فقد ذكر في أخبار أبي نواس أنه شغف بحب غلام نصراني وكلف به ولم يدري كيف يحتال في أمره فعمد إلى جبة صوف قصيرة وسروال من الصوف فلبسهما ولبس نعلا رقيقا فتزيا بزي الزهاد إلى آخر الحكاية فالفجرة والخارجين عن الدين بمكرهم وخبثهم وخداعهم كانوا يعرفون أن لبس الصوف يدفع عنهم الشبهات، ولقد كانت الجماهير التي لا تتمثل الصالحين والأخيار إلا إذا كانوا في ثياب الصوفية قال الزبيدي نقلا عن كتاب بهجة الناظرين وأنس العارفين ومما حدثنا به من أدركنا من المشيخة أن الإمام أبا حامد الغزالي لما حضرته الوفاة أوصى رجلا من أهل الفضل والدين كان يخدمه أن يحفر في موضع بيته ويستوصي أهل القرى التي كانت قريبة إلى موضعه ذلك بحضور جنازته وأن لا يباشره أحد حتى يصل ثلاثة من نفر من الفلاة لا يعرفون ببلاد العراق : يغسله اثنان منهما ويتقدم الثالث للصلاة عليه بغير أمر ولا مشورة ، فلما توفي، فعل الخادم كل ما أمره، وحضر الناس، فلما اجتمعوا الحضور جنازته رأوا ثلاثة رجال خرجوا من الفلاة، فعمد اثنان منهم إلى غسله، واختفى الثالث ولم يظهر، فلما غسل وأدرج في أكفانه وحملت جنازته على شفير قبره ظهر ثالث ملتفا في كسائه، وفي جانبه علم أسود معمما بعمامة من صوف وصلى عليه وصلى الله بصلانه ، ثم سلم وانصرف وتوارى عن الناس فالقصة هذه مصنوعة ربما من نسج الخيال فهي تمثل أسطورة أو خرافة ومع ذلك فإنها تمثل رأي الجماهير في لباس الصوف ، وهذا ويؤكد إلتزام الصزفية في لبس الصوف حرصهم على المرقعة أي الثوب الممزق ثم يرقع فيعرف بالثوب المرقع، وفي رأي الجوزي أن المتصوفة أو الذين يسلكون نهج الصوفية لما سمعوا أن النبي كان يرقع ثوبه وأنه قال : لعائشة لا تخلعي ثوبا حتى ترقعيه – أي إشارة إلى الزهد والتقشف – وقد ثبت لعمر ابن الخطاب كان في ثوبه رقاع ، اختاروا المرقعات فصارت المرقعة عنوانا دالا على أهل التصوف وروي عن الثوري أنه قال " كانت المرقعات غطاء على الدر فصارت جيفا على مز ابل " ونظر محمد بن محمد الكتاني إلى أصحاب المرقعات فقال إخواني إذا كان لباسكم موافقا لسرائركم فقد أحببتم أن يطلع الناس عليها ، وإن كان مخالفا لسرائركم، فقد هلكتم ورب الكعبة ، وقال محمد عبد الحق لبعض أصحابه " لا يعجبنك ما ترى من هذه اللبسة الظاهرة عليهم ، فما زينوا الظواهر إلا بعد أن خربوا البواطن " وقد ذكر صاحب تبليس إبليس ما وقع للنصر بن شميل مع الصوفية فقال قلت لبعض الصوفية : تبيع جبتك الصوف ؟ فقال : إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء يصطاد ؟ " هذا وكان في تصور، أهل التصوف والصوفية والجماهير أن نزع المرقعة هي علامة للاقبال على الدنيا وزخرفها والخروج من الحضرة الإلهية * كما يقال عنهم ويذكر الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين أن محمد بن أحمد بن موسى قدم بغداد أقام بها مدة يتكلم بلسان الوعظ ، ويشير إلى طريقة الزهد، ويلبس المرقعة ويبين ويظهر عزوف النفس عن طلب الدنيا وزخرفها ومباهجها، فافتتن به الناس لما رأوا من حسن طريقته في الوعظ وكان يحضر مجلس وعظه قوم لا يحصون فهم أعداد كثيرة ثم أنه قبل ماكان يوصل بعد امتناع شديد كان يظهرمن قبل، وحصل له ببغداد مال كثير ونزع المرقعة ولبس الثياب الناعمة الفاخرة وجرت له أقاصيص، وصار له تبع وأصحاب فخياطة الثياب وترقيعها في الأصل مكن علامات الفقر، والتقشف وأيضا سمة من سمات الحزن والعزوف عن الدنيا، فمنه أن عروة بن الزبير قال في عائشة :
" لقد تصدقت رضي الله عنها وإن درعها لمرقع وقد أنكر ابن الجوزي أن يكون للمرقعة أصل في السنة ويدل هذا على أن الصوفية كانوا يتسامون إلى جعل المرقعة من السنن النبوية ، وهذا دليل إيجابي في تشبثهم بالمرقعات ، وقد كانوا الصوفية يعرفون بنسبتهم إلى الصوف قال أبو سليمان الدراني لرجل لبس الصوف قد أظهرت آلة الزاهدين فماذا أورثك هذا الصوف ، فسكت الرجل فقال له ظاهرك قطنيا وباطنك صوفيا فلبس الصوف يؤكد الخشوع والورع والخوف سمن الله عز وجل والابتعاد عن كل ما يلذ في الدنيا وما يثر من شهوات ، ويجب أن نذكر في هذا البحث أن أهل النصرانية ومعتنقيها كانت من تقاليدهم لبس الصوف ويعني هذا الفعل عندهم تصوف وروحانية روى ابن قتيبة بسنده قال : " بلغني ألأن عيس خرج على أصحابه وعليه جبة من صوف وكساء وتبان حافيا مجزوز الرأس والشاربين، باكيا شعثا مصفر اللون من الجوع، يابس الشفتين من العطش طويل شعر الصدر والذراعين والساقين، فقال " السلام عليكم يا بني إسرائيل " أنا الذي أنزلت الدنيا منزلها، ولا عجب ولا فخر أتدرون أين بيتي ؟ قالوا أين بيتك يا روح الله ؟ قال بيتي المساجد، وطيبي الماء، وإدامي الجوع، ودابتي رجليً، وسراجي بليل القمر وصلاتي في الشتاء مشارق الشمس، وطعامي ما تيسر ، وفاكهتي وريحاني بقول الأرض ، ولباسي الصوف وشعاري الخوف وجلسائي الزمن والمساكين وأصبح وليس لي شيء وأنا طيب النفس غني مكثر فمن أغنى وأربح مني ؟ " إن هذا النص في ظاهر ألفاظه يحمل صراحة واضحة تعبر على إيثار المسيح بلبس الصوف وذكر ابن نسرين كان عيس يلبس الصوف ونبينا يلبس الكتان وهو أحب إلينا أن نقتدي به .
3. الفرض الثالث : الذي ينص على أن التصوف نسبة إلى الصفا فإن هذا الفرق ليس إلا حذلقة وغرور من بعض الصوفية وقد قال فيهم أبو الفتح البستي شعرا :
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا فيه وضنوه مشتقا من الصوفي
ولست هذا الاسم غير فتى صافي فصوفي حتى لقب الصوفي
وسخر منهم أبو العلا فقال :
صوفية ما رضوا للصوف نسبتهم حتى ادعوا انهم من طاعة صوفوا
4. الفرض الرابع : ينص هذا الفرض أن لفظة التصوف تعود نسبتها إلى سوفيا اليونانية ويعني أنه ليس إلا ضربا من الإغراب والتغليط والابتعاد عن جادة الصواب وقد قال به أبو الريحان البيروني المتوفى سنة 440هـ وقال به فون هامر مكن المستشرقين، وتعصب له الأديب عبد العزيز الاسلامبولي ، والأستاذ محمد لطفي جمعة ، في مقال كتبه في المعرفة ومقال كتبه في البلاغ وكلمة سوفيا اليونانية معناها الحكمة ومنها فيلسوف أي محب الحكمة التي تشتمل على العلوم النظرية والعلوم العملية ، ولا يفوتنا أن نذكر في هذا المقام أن العرب كانوا مولعين بحفظ ما يدخل لغتهم من الألفاظ الأجنبية ولو كان التصوف من صوفيا لنصوا عليها في كثير من مؤلفات ، ولكان لها وقع في أشعارهم ويبقى ورودها في كلام البيروني بابا في الإغراب، وفي نظري كلمة التصوف تدل على الزهد والعرفان والخوف، والخشية والخشوع إلى الله تعالى وأن حل بهذه اللفظة نوع من الرهبانية التي لا تمت على الإطلاق إلى الإسلام وأن الذي يمثل ظاهرة التصوف هو ذلك الإنسان المميز بسلوكه ظاهريا وباطنيا ويتحدد معنى التصوف من خلال ما ذكرناه آنفا على النحو الآتي :
و الفضيل بن عياض، ودخل الشام ومات بها، وكان يأكل من عمل يده مثل الحصاد وحقل البساتين وغير ذلك ..." فالصوف هو لباس لرعاة، وابن ادهم حين جاءه الهاتف ، ترك ما يملك ، وكان المتاع والفرس ، والإمارة وتصوف أي لبس الصوف ليلتحق بالزهاد وقيلت فيه قصص غريبة كلها تصب في زهده من الدنيا وزخرفها. وقال عبد الله ابن شداد : " أربع من كن فيه بريء من الكبر : من اعتقل البعير، وركب الحمار، ولبس الصوف، وأجاب دعوة الرجل الدون " إن هذا الكلام أثبته الجاحظ في كتابه البيان والتبين وأن هذا الكلام يبرهن على صحة ما نقلناه من رثاء عمر بن الخطاب للرسول فقد ثبت عن النبي ركب الحمار ولبس الصوف، ويذكر الإمام القشيري في رسالته في باب التصوف تعريفات لأهل التصوف منها التصوف نسبة للقوم آثروا الله عز وجل على كل شيء فآثرهم الله عز وجل على كل شيء " ، ومنها استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد، وسئل الجنيد عن التصوف فقال هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة " وأنشد أبو حيان في جاهل لبس صوفا وزها فيه :
أيا كاسيا من جيد الصوف نفسه ويا عريا من كل فضل ومن كيس
أتزهي بصوف بالأمس مصبح على نعجة واليوم أمسى على تيس
والحقيقة أن كلمة الصوف هي علامة سيمائية نعني بها الزهد وهو المراد
بزي الصوفية الذي وصف به المقري أحد الفقهاء وكذلك أن كلمة الصوف هي شعار الصالحين ، وتدل على الورع والخوف أيضتا فقد ذكر في أخبار أبي نواس أنه شغف بحب غلام نصراني وكلف به ولم يدري كيف يحتال في أمره فعمد إلى جبة صوف قصيرة وسروال من الصوف فلبسهما ولبس نعلا رقيقا فتزيا بزي الزهاد إلى آخر الحكاية فالفجرة والخارجين عن الدين بمكرهم وخبثهم وخداعهم كانوا يعرفون أن لبس الصوف يدفع عنهم الشبهات، ولقد كانت الجماهير التي لا تتمثل الصالحين والأخيار إلا إذا كانوا في ثياب الصوفية قال الزبيدي نقلا عن كتاب بهجة الناظرين وأنس العارفين ومما حدثنا به من أدركنا من المشيخة أن الإمام أبا حامد الغزالي لما حضرته الوفاة أوصى رجلا من أهل الفضل والدين كان يخدمه أن يحفر في موضع بيته ويستوصي أهل القرى التي كانت قريبة إلى موضعه ذلك بحضور جنازته وأن لا يباشره أحد حتى يصل ثلاثة من نفر من الفلاة لا يعرفون ببلاد العراق : يغسله اثنان منهما ويتقدم الثالث للصلاة عليه بغير أمر ولا مشورة ، فلما توفي، فعل الخادم كل ما أمره، وحضر الناس، فلما اجتمعوا الحضور جنازته رأوا ثلاثة رجال خرجوا من الفلاة، فعمد اثنان منهم إلى غسله، واختفى الثالث ولم يظهر، فلما غسل وأدرج في أكفانه وحملت جنازته على شفير قبره ظهر ثالث ملتفا في كسائه، وفي جانبه علم أسود معمما بعمامة من صوف وصلى عليه وصلى الله بصلانه ، ثم سلم وانصرف وتوارى عن الناس فالقصة هذه مصنوعة ربما من نسج الخيال فهي تمثل أسطورة أو خرافة ومع ذلك فإنها تمثل رأي الجماهير في لباس الصوف ، وهذا ويؤكد إلتزام الصزفية في لبس الصوف حرصهم على المرقعة أي الثوب الممزق ثم يرقع فيعرف بالثوب المرقع، وفي رأي الجوزي أن المتصوفة أو الذين يسلكون نهج الصوفية لما سمعوا أن النبي كان يرقع ثوبه وأنه قال : لعائشة لا تخلعي ثوبا حتى ترقعيه – أي إشارة إلى الزهد والتقشف – وقد ثبت لعمر ابن الخطاب كان في ثوبه رقاع ، اختاروا المرقعات فصارت المرقعة عنوانا دالا على أهل التصوف وروي عن الثوري أنه قال " كانت المرقعات غطاء على الدر فصارت جيفا على مز ابل " ونظر محمد بن محمد الكتاني إلى أصحاب المرقعات فقال إخواني إذا كان لباسكم موافقا لسرائركم فقد أحببتم أن يطلع الناس عليها ، وإن كان مخالفا لسرائركم، فقد هلكتم ورب الكعبة ، وقال محمد عبد الحق لبعض أصحابه " لا يعجبنك ما ترى من هذه اللبسة الظاهرة عليهم ، فما زينوا الظواهر إلا بعد أن خربوا البواطن " وقد ذكر صاحب تبليس إبليس ما وقع للنصر بن شميل مع الصوفية فقال قلت لبعض الصوفية : تبيع جبتك الصوف ؟ فقال : إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء يصطاد ؟ " هذا وكان في تصور، أهل التصوف والصوفية والجماهير أن نزع المرقعة هي علامة للاقبال على الدنيا وزخرفها والخروج من الحضرة الإلهية * كما يقال عنهم ويذكر الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين أن محمد بن أحمد بن موسى قدم بغداد أقام بها مدة يتكلم بلسان الوعظ ، ويشير إلى طريقة الزهد، ويلبس المرقعة ويبين ويظهر عزوف النفس عن طلب الدنيا وزخرفها ومباهجها، فافتتن به الناس لما رأوا من حسن طريقته في الوعظ وكان يحضر مجلس وعظه قوم لا يحصون فهم أعداد كثيرة ثم أنه قبل ماكان يوصل بعد امتناع شديد كان يظهرمن قبل، وحصل له ببغداد مال كثير ونزع المرقعة ولبس الثياب الناعمة الفاخرة وجرت له أقاصيص، وصار له تبع وأصحاب فخياطة الثياب وترقيعها في الأصل مكن علامات الفقر، والتقشف وأيضا سمة من سمات الحزن والعزوف عن الدنيا، فمنه أن عروة بن الزبير قال في عائشة :
" لقد تصدقت رضي الله عنها وإن درعها لمرقع وقد أنكر ابن الجوزي أن يكون للمرقعة أصل في السنة ويدل هذا على أن الصوفية كانوا يتسامون إلى جعل المرقعة من السنن النبوية ، وهذا دليل إيجابي في تشبثهم بالمرقعات ، وقد كانوا الصوفية يعرفون بنسبتهم إلى الصوف قال أبو سليمان الدراني لرجل لبس الصوف قد أظهرت آلة الزاهدين فماذا أورثك هذا الصوف ، فسكت الرجل فقال له ظاهرك قطنيا وباطنك صوفيا فلبس الصوف يؤكد الخشوع والورع والخوف سمن الله عز وجل والابتعاد عن كل ما يلذ في الدنيا وما يثر من شهوات ، ويجب أن نذكر في هذا البحث أن أهل النصرانية ومعتنقيها كانت من تقاليدهم لبس الصوف ويعني هذا الفعل عندهم تصوف وروحانية روى ابن قتيبة بسنده قال : " بلغني ألأن عيس خرج على أصحابه وعليه جبة من صوف وكساء وتبان حافيا مجزوز الرأس والشاربين، باكيا شعثا مصفر اللون من الجوع، يابس الشفتين من العطش طويل شعر الصدر والذراعين والساقين، فقال " السلام عليكم يا بني إسرائيل " أنا الذي أنزلت الدنيا منزلها، ولا عجب ولا فخر أتدرون أين بيتي ؟ قالوا أين بيتك يا روح الله ؟ قال بيتي المساجد، وطيبي الماء، وإدامي الجوع، ودابتي رجليً، وسراجي بليل القمر وصلاتي في الشتاء مشارق الشمس، وطعامي ما تيسر ، وفاكهتي وريحاني بقول الأرض ، ولباسي الصوف وشعاري الخوف وجلسائي الزمن والمساكين وأصبح وليس لي شيء وأنا طيب النفس غني مكثر فمن أغنى وأربح مني ؟ " إن هذا النص في ظاهر ألفاظه يحمل صراحة واضحة تعبر على إيثار المسيح بلبس الصوف وذكر ابن نسرين كان عيس يلبس الصوف ونبينا يلبس الكتان وهو أحب إلينا أن نقتدي به .
3. الفرض الثالث : الذي ينص على أن التصوف نسبة إلى الصفا فإن هذا الفرق ليس إلا حذلقة وغرور من بعض الصوفية وقد قال فيهم أبو الفتح البستي شعرا :
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا فيه وضنوه مشتقا من الصوفي
ولست هذا الاسم غير فتى صافي فصوفي حتى لقب الصوفي
وسخر منهم أبو العلا فقال :
صوفية ما رضوا للصوف نسبتهم حتى ادعوا انهم من طاعة صوفوا
4. الفرض الرابع : ينص هذا الفرض أن لفظة التصوف تعود نسبتها إلى سوفيا اليونانية ويعني أنه ليس إلا ضربا من الإغراب والتغليط والابتعاد عن جادة الصواب وقد قال به أبو الريحان البيروني المتوفى سنة 440هـ وقال به فون هامر مكن المستشرقين، وتعصب له الأديب عبد العزيز الاسلامبولي ، والأستاذ محمد لطفي جمعة ، في مقال كتبه في المعرفة ومقال كتبه في البلاغ وكلمة سوفيا اليونانية معناها الحكمة ومنها فيلسوف أي محب الحكمة التي تشتمل على العلوم النظرية والعلوم العملية ، ولا يفوتنا أن نذكر في هذا المقام أن العرب كانوا مولعين بحفظ ما يدخل لغتهم من الألفاظ الأجنبية ولو كان التصوف من صوفيا لنصوا عليها في كثير من مؤلفات ، ولكان لها وقع في أشعارهم ويبقى ورودها في كلام البيروني بابا في الإغراب، وفي نظري كلمة التصوف تدل على الزهد والعرفان والخوف، والخشية والخشوع إلى الله تعالى وأن حل بهذه اللفظة نوع من الرهبانية التي لا تمت على الإطلاق إلى الإسلام وأن الذي يمثل ظاهرة التصوف هو ذلك الإنسان المميز بسلوكه ظاهريا وباطنيا ويتحدد معنى التصوف من خلال ما ذكرناه آنفا على النحو الآتي :
نعني بالتصوف عزوف النفس عن الدنيا " والعكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد في ما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد على الخلق في الخلوة والعبادة " فالتصوف إذن طريقة " كان ابتداؤها الزهد الكلي ، ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع " الفناء والرقص...." ومن دون شك أن التصوف هو اتجاه ديني وهو من العلوم الشرعية الحادثة في الملة الإسلامية كما يذكر ابن خلدون وقد ذهب بالرأي المستشرق ( ينولد ألن نيكلسون ) وهو المختص في دراسة التصوف يقول بأن التصوف " فلسفة الإسلام الدينية " وتعرف بأنها إدراك الحقائق الإلهية ، لذلك كان المتصوفون مغرمين بأن يدعوا أنفسهم أهل الحق ولقد شاع التصوف في الأديان والأمم كلها في الوثنية والمجوسية واليهودية والنصرانية والإسلام ، ويذكر التاريخ أن الحضارات الأولى قد عرفت التصوف في بعض أشكاله أو صوره كالبابليين واليونان والرومان والهنود والصينيون والعرب والعجم وعرفته بعض الأمم الفطرية فتلون التصوف بألوان الدين وألوان هذه الحضارات التي نشأ فيها وبالتالي يستحيل على أي باحث أو دارس أن يفهم التصوف قبل أن يفهم تطور الدين الذي اتصل به وخصوصا في الإسلام . ومع أن المتصوفة من المسلمين قد ابتعدوا أحيانا عن الدين قليلا أو كثيرا فإنهم كانوا في حال اجتماعهم مع غيرهم يحافظون على ظاهر الدين الإسلامي وعلى فرائضه . أما في خلواتهم وفيما بينهم فلهم أشياء تصدر عنهم يستحي العاقل من ذكرها ولفظ الصوفية في الحقيقة " هو من جملة الزهاد " ، كما أن القرآن الكريم أراد أن ينفر الأعراب المنغمسين في اللذات اشد الانغماس عن الدنيا فقال لهم : وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تعالى : المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ومع ذلك لم يشأ أن يصرفهم عنها أبدا فقال الله تعالى : وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وقال الله تعالى :قل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ولم يكن من العجب أن يتقشف بعض المسلمين صدر الإسلام وأن يزهدوا في الدنيا ولكن لم تعرف المسلمون بالفتوحات الإسلامية في الأقطار واحتلوا بغيرهم م الأمم ، ودخل في الإسلام من الغرب والروم والهنود أن " فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني " فأحدث ذلك رد فعل ظاهر فأنقبض بعضهم عن الدنيا مرة واحدة " فحدث اسم زاهد وعابد ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا، وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها وأخلاق تخلقوا بها " هذا وأن المصادر التي بحثت في أصل ونشأة التصوف، ولفظة الصوفي نجدها تختلف في ضبط معناها ونحت اشتقاقها والبحث في مصدرها * حيث أكد آبو القاسم القشيري في رسالته التي وضعها في علم التصوف عدم وجود اشتقاق لها في اللغة العربية غير أن البعض من العلماء لم يلتزم بكلمتي التصوف والصوفي وإنما راحوا يطلقون على المتعبدين الزهاد ألقابا عديدة مثل الجوعية والسياحين والغرباء والنورية، وهذا ما يذكره الكلاباذي، أن أهل الشام كانوا يلقبونهم بالجوعية لاقتصار على القليل من الطعام وكانوا أيضا يلقبون بالسياحين والغرباء لسياحتهم وغربتهم عن الأوطان ولقبوا بالنورية، لأن الله نور قلوبهم بعد تركهم للدنيا وقد عرض الكلاباذي مجموعة آراء بحثت وتحققت من الاشتقاق لكلمة المتصوف، وأدى به هذا العرض في نظرنا إلى الوقوف عند أحسن الآراء رجحانا إذ يرى أن القول بصفاء أسرارهم ونقائها ولقبوا بالصوفية بالرغم من هذه النعوت الاشتقاقية ، للفظة التصوف، تبقى نعوت يهيمن عليها الظلام الذي يحجب النور على مصداقية معرفة حقيقة لفظة التصوف ، ويذهب بعض الباحثين المتخصصين في علم التصوف ورجاله إلى القول بأن " التصوف فلسفة حياة تهدف إلى الترقي بالنفس الإنسانية أخلاقيا وتتحقق بواسطة رياضات عملية معينة تؤدي إلى الشعور في بعض الأحيان بالفناء في الحقيقة الأسمى ، والعرفان بها ذوقا لا عقلا ، وثمرتها السعادة الروحية ويصعب التعبير عن حقائقها بألفاظ اللغة العادية لأنها وجدانية الطابع وذاتية " بالإضافة أنهم نظروا إلى أن التجربة الصوفية واحدة في جوهرها، ولكن الاختلاف بين صوفي وآخر راجع أساس إلى تغير التجربة ذاتها المتأثر بالحضارة التي ينتمي إليها كما أن التصوف نوعان أحدهما ديني والآخر فلسفي ، فالتصوف الديني ظاهرة مشتركة بين الأديان جميعا، سواء في ذلك الأديان السماوية ، أو الأديان الشرقية ، والتصوف الفلسفي قديم كذلك، وقد عرف في الشرق ، وفي التراث الفلسفي اليوناني ، وفي أوروبا في عصريها الوسيط والحديث ولم يخل العصر الحاضر من فلاسفة أوربين ذوي نزعة صوفية مثل برادلي في إنجلترا، وبرغسون في فرنسا وكان التصوف الديني يختلط أحيانا بالفلسفة كما هو حادث عند البعض من الصوفية في الديانة المسيحية، وحتى الديانة الإسلامية وحدث أن امتزجت النزعة العقلية، بالنزعة الصوفية عند الفلاسفة، ففد لاحظ برترندراسل في بحث له وضعه بعنوان " التصوف والمنطق " mysticisme and logic " فطرح فيه فكرته التي تنص من الفلاسفة من أمكنه الجمع بين النزعة الصوفية والنزعة العلمية، ورأى في ذلك الجمع أو التوفيق بين النزعتين سموا فكريا جعل من أصحابه فلاسفة بالمعنى الصحيح فيقول ما نصه " أن أعظم الرجال الذين كانوا فلاسفة شعروا بالحاجة إلى كل من العلم والتصوف " إذ " العاطفة الصوفية هي الملهم الأعظم ما يكون للإنسان " ويضرب " رسل" أمثلة لهؤلاء الفلاسفة ، فذكر هيرقليطس ، وبرميندس ، وأفلاطون، ويذهب ويليام جيمس " william james" أن أحوال التصوف تتميز بأربع خصائص وهي :
1- أنها أحوال إدراكية إذ تظهر لأصحابها كحالات معرفة وتكشف لهم في حقائق موضوعية فهي بمثابة الإلهامات النورانية وليس من مسالك المعرفة البرهانية.
2- إن هذه الأحوال المعرفة والتي صورتها إلهامات لا يمكن وصفها أو التعبير عنها لأنها أحوال وجدانية شعورية وبالتالي يصعب نقل هذه الأحوال إلى الغير أو الآخر في صورة لفظية دقيقة.
3- هذه الأحوال الوجدانية النفسية سريعة الزوال لا تثبت عن حال فلا تستمر مع الصوفي لمدة طويلة لكن آثارها ثابتة في ذاكرة صاحبها على نحو ما.
4- إن هذه الأحوال الوجدانية سالبة ليس موجبة لاعتبار أن الإنسان لا يحدثها بإرادته إذ هو في تجربته الصوفية يبدوا كما لوكان خاضعا لقوة خارجية تسيطر عليه وهناك باحث غربي آخر وهو بيوك " R.m Bueke" يحدد سبع خصائص لأحوال التصوف هي :
- النور الباطني الذاتي. - الشعور بالخلود .
- السمو الأخلاقي. - فقدان الخوف من الموت .
- الإشراف العقلي. - فقدان الشعور بالذنب .
- المفاجأة.
إلى جانب هذه الخصائص التي ذكرها كل من جيمس وبيوك للتصوف والتي هي موجودة في معظم أنواع التصوف، غير أنها ليس شاملة وعامة لأن هناك خصائص أخرى وهي في مستوى الخصائص المذكورة آنفا من حيث الأهمية منها سعادة النفس أو الرضا والشعور والإحساس بالطمأنينة الشعور بالفناء التام في الحقيقة المطلقة، الشعور بإيمان المعرفة النورانية، الشعور بالقدرة على تجاوز المكان والزمان وغير ذلك ما نجده لدى الصوفية، لكن هناك محاولة أخرى للفيلسوف برترندراسل تتمثل في حصر الحقائق الفلسفية للتصوف حيث أنتهى من خلال تحليله لأحوال التصوف في معطاها الخاص والعام إلى القول بأربعة خصائص تميز التصوف عن غيره من الفلسفات في العصور بأزمانها المختلفة في كل أنحاء العالم ببيئاته الثقافية والاجتماعية والحضارية وهي
أولا : الاعتقاد في الكشف أو البصيرة منهجا في المعرفة مقابلا للمعرفة التحليلية والاستدلالية .
ثانيا : الاعتقاد في وجدة الوجود وإطاره الكلي ورفض الكل ، ورفض كل التضاد والقسمة أيا كانت صورها .
ثالثا : إنكار الحقيقة الزمانية .
رابعا: الاعتقاد أن قيمة الشر المحض شيء ظاهري ووهم مترتب على القسمة والتضاد اللذين يحكم بهما العقل التحليلي
وما يلاحظ عن هذه الخصائص عند رسل أن الخاصية الأولى ، وهي الاعتقاد في الكشف أو الإدراك المباشر الوجداني هو المنهج الصحيح للمعرفة بصورة عامة بين أهل الصوفية على الرغم من اختلاف مذاهبهم وعصورهم أما الخصائص الثلاث الأخرى فهي تصدق على أهل الصوفية القائلين بوحدة الوجود فقط وليس كل المتصوفة يقول بهذا المذهب. وقد يذكر أبو الوفاء الغنيمي التفتازاني وجهة نظره الخاصة التي أثبت فيها أن للتصوف بصورة عامة خمسة خصائص نفسية وأخلاقية، وإبستمولوجية وتنطبق على مختلف 2. 2.3 أنواع التصوف :
1- الترقي الأخلاقي، في نظره أن كل تصوف يضم في جوهره قيم أخلاقية معينة الغرض منه تصفية النفس من أجل الوصول إلى تحقيق هذه القيم، ولا يكون هذا حاصل للصوفي إلا بشروط إلزامية تتجسد في مجاهدات بدنية، ورياضية نفسية معينة، وزهد في بهرج الحياة ومادياتها .
2- الفناء في الحقيقة المطلقة ، إن هذه الخاصية الصوفية تميز التصوف بمعناه الاصطلاحي الدقيق ويقصد بالفناء وصول الصوفي من رياضته ومجاهدته البدنية والروحية إلى حالة نفسية معينة لا يعود يشعر معها بأنيته كما يشعر ببقائه مع حقيقة أسمى مطلقة هي الله عند صوفية المسلمين ، أو الكلمة عند صوفية المسيحيين أو براهما في تصوف البرهمية " الهنود" وهكذا .. كما أن الصوفي يقصد من وراء الفناء أن تفنى إرادته في إرادة المطلق ، وقد عبر بعض الصوفية إلى القول بالاتحاد بهذه الحقيقة أو أنها حلت فيهم أو أن الوجود واحد لا كثرة فيه بوجه ما ، ولا يذهب بعضهم إلى القول بمثل هذه الآراء ف-ي الاتحاد أو الحلول ، أو وحدة الوجود وإنما يعودون من فنائهم إلى إثبات الإثنينية أو الكثرة في الوجود وعلى هذا تكون خاصية الفناء تتصف بها صوفية مذهب الوحدة في الوجود ، وتنطبق عليهم كما تنطبق على غيرهم من الصوفية الذين لم يقولوا بها .
3- العرفان الذوقي المباشر: يرى أبو الوفاء الغنيمي أن هذه الخاصية هي بمثابة قياس إبستمولوجي دقيق يميز التصوف عن غيره من الفلسفات فإذا كان الإنسان يعتمد علة مناهج الاستدلال العقلي في فلسفته لإدراك الحقيقة فهو فيلسوف ، أما إذا كان يؤمن أن وراء إدراكات الحس والاستدلالات العقلية منهجا آخر للمعرفة بالحقيقة يسميه كشفا أو ذوقا أو ما شابه ذلك من التسميات ، فهو في هذه الحالة صوفي ، وهذا الكشف الذي آل إليه الصوفي آن ويمكننا أن نقول أننا لا نستطيع أن نقيس زمانه فهو سريع الزوال أشبه شيء بالومضة السريعة المفاجئة
4- الطمأنينة أو السعادة : أنها الخاصية التي تجعل من الصوفي أن يقهر كل دواعي غرائز وشهوات البدن أو ضبطها ، ويحدث في ذاته نوع من التوازن النفسي، والتوافق النفسي، من شأنه أن يجعله متحررا من كل مخاوفه شاعرا براحة نفسية عميقة أو طمأنينة تتحقق معها سعادته مع العلم أن الصوفية قد أشاروا في كتاباتهم النثرية والشعرية أن الفناء في المطلق والمعرفة به يحدثان في نفس الإنسان سعادة لا توصف .
5- الرمزية في التعبير : إن هذه الخاصية تتمثل في وجود ألفاظ أو دلالات صوفية يهيمن عليها الرمز، ومن المعلوم أن عبارات الصوفية غالبا ما نجدها تحمل معنيين أحدهما يستفاد من ظاهر الألفاظ، والآخر بالتحليل والتعمق فالمعنى الأخير هو الذي يصعب فهمه بالنسبة لغير الصوفي، فصعوبة فهم كلام الصوفية، وصعوبة معرفة مقاصدهم وغايتهم وعلتها، حالات نفسية وجدانية خاصة يصعب التعبير عنها بألفاظ اللغة، وليست شيئا مشتركا بين الناس جمعيا. وأن كل صوفي له طريقة معينة تعبر عن حالاته، وبالتالي أن التصوف خبرة ذاتية وجدانية ذوقية مما يمكننا أن نقارن التصوف بالفن وأذواقه المختلفة لكون أن منطلقهما واحد يتمثل في الخبرة الذاتية لأن أهل الصوفية يعتمدون وصف حالاتهم الوجدانية على الاستنباط الذاتي أساسا وأي معرفة على هذا النحو يصعب فهمها على الغير ومن هنا توصف بأنها رمزية، مع العلم أن هذه الخصائص كما يذكرها " أبو الوفاء الغنيمي : تصدق على أي تصوف في صورته الناضج أو الكامل، وأن التصوف في أية حضارة يمر بمراحل مختلفة من التطور ، وعندئذ قد تنطبق بعض تلك الخصائص على بعض هذه المراحل دون البعض الآخر، كما هو الشأن في التصوف الإسلامي وفي ضوء هذه الخصائص الخمس كما يرى التفتازاني يمكن وضع تعريف للتصوف. إذ هو فلسفة حياة عملية تمسو بالإنسان إلى مستوى السعادة الروحية والرقي الأخلاقي ويبعده عن كل شرور الدنيا وملذاتها والعرفان بالتصوف ذوقا لا برهنة عقلية ويصعب التعبير على خلجات المتصوف والحالة المصاحبة للفعل التصوفي باللغة العادية لأنها وجدانية الطابع وذاتية بل أكثر من ذلك أنها عاطفية ذوقية.
3.3 اختلاف المقاصد والغايات من التصوف عند المتصوفة :
إن الخصائص المذكورة للتصوف تمثل مرحلة نضوجه الكاملة وبالتالي فإن القصد والغاية من التصوف يختلف باختلاف مراحل تطوره لذلك نجد المتصوفة يختلفون فيما بينهم من حيث السلوكات الوجدانية فهناك من المتصوفة يقف بسلوكه عند الغاية الأخلاقية وهي تهذيب النفس وضبط الإرادة وإلزام ،الإنسان بالأخلاق الفاضلة السامية ويتميز هذا التصوف بخاصية السلوك التربوي عند التربويون كما حدث في العصر الحديث ، أو ما كان يعرف في التربية القديمة بالمؤدب ، وعلى هذا الأساس يتصف التصوف بالصبغة العملية ومن المتصوفة من يذهب إلى أبعد من هذه الغاية الأخلاقية العملية في مسلكها ونهجها هادفا إلى معرفة غاية أسمى، وهي معرفة الله والمتصوف في طلبه لهذه المعرفة يضع في بداية المنطلق شروطا خاصة بهذا المنحى لبغلي السامي ذو البعد الماورائي أو الميتافيزيقي لهذا فإن من أصحاب هذا التصوف تجدهم يعتنون بالخصوص بمناهج للمعرفة وأدواتها ويؤثرن من بينها على الكشف، إضافة إلى هذا أن هناك أنواع من التصوف تصطبغ بالصبغة الفلسفية يهدف أصحاب هذه الأنواع إلى اتخاذ مواقف من الكون محاولين بذلك إيجاد تفسير له ، وتحديد صلته بخالقه وصلة الإنسان بالله_ وهذه المذاهب الصوفية قائمة على أساس الذوق فالصوفي يغيب في لحظات معينة عن شعوره بذاته فيشعر بأن العالم الخارجي، لا حقيقة له بالقياس إلى الله وملكوته ويترتب على هذا النهج الصوفي أو الذوقي مذاهب صوفية معينة كمذهب الوجود، ومذهب الحلول، والاتحاد ، ولكن هذه المذاهب الصوفية لا تخرج عن كونها في الأساس مذاقات خاصة تختلف كل الاختلاف عن تلك الأنسقة الفكرية والعلمية المبنية على الاستدلال العقلي والتجريبي فهي معرفة ذوقية ذاتية خاصة وهو بهذا يختلف عن الفلسفة التي بدورها تجربة خاصة وذاتية ولكنها تعتمد العقل في تقرير نتائجها وطرح أفكارها أما التصوف فهو تجربة ذاتية يعتمد الذوق الذاتي الوجداني الخاص الصادر عن الكشف أو المسلك النوراني فهو لا يعتمد البرهان وقد روي في علم التصوف أن جميع معارفه وعلومه ذوق إذ سئل الإمام محي الدين ابن عربي من أحد تلامذته قائلا : " أن الناس ينكرون علينا علومنا ويطالبوننا بالدليل عليها " فقال له ابن عربي ناصحا : " إذا طلبك أحد بالدليل والبرهان على علوم الأسرار الإلهية فقل: " ما الدليل على حلاوة العسل ، فلا بد أن يقول لك هذا علم لا يحصل إلا بالذوق فقل له : هذا مثل ذلك ." تمثل إجابة ابن عربي عن سعة إدراكه لعلم التصوف والقوة في قوة تحليل موضوعه باصدراه لحكم تقريري وتقييمي في الآن نفسه أن التصوف يتعلق بمجال العواطف الإنسانية التي يهيمن عليها طابع الكيفية فهي لا تخضع للقياس الكمي لأنها ظواهر لا مكان لها تجري في الزمان فهي خارج إطار الموضوع المكاني يتم معرفتها عن طريق المعاناة الشخصية كما أنها غير خاضعة لمنطق العقل واستدلالاته
4.3 التصوف وعلم النفس :
توجد دراسات كثيرة حول التصوف من طرف علماء النفس وخاصة المختصين في الجانب الديني منه -علم النفس الديني - ومن هؤلاء العلماء نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر عالم الأمريكي ويليام جيمس "James (w) ولوبا جيمس leuba (James) (H) وأندرهيل underhill Evelyn و ما لوحظ عن علماء النفس الذين درسوا التصوف دراسة موضوعية علمية، لم ينصفوا الصوفية، والسبب في ذلك تعود في نظر أبو الوفاء التفتازاني " معاصر " إلى بعض الأخطاء المنهجية التي وقعوا فيها ، حيث ضيقوا نطاق بحثهم في التجربة الحسية وحدها من دون أن يعتنوا بالتدقيق والتمحيص في فهم مصطلحات الصوفية التي عبروا بها عن أحوال وجدانية ذاتية خالصة، لا تتصف بصفة العمومية إنما هي تجارب ذاتية متمايزة من شخص للآخر تخضع للزمان النفسي الذاتي ويضيف التفتازاني قائل : " بأن الباحث لكي يحكم على هذا النوع من الحالات الصوفية حكما علميا فلابد له أن يقوم بتجريبه، أو يكون له استعداد معين لتذوقه ، أما أن يصطنع لماء النفس في بعض الأحيان منهج المماثلة في دراسة حالات التصوف، فهذا من الخطأ بعينه لتعذرمماثلتهم للصوفي في حالاته الوجدانية الخاصة مماثلة حقيقية، وهو ليسوا بصوفية. " ويضيف ناقدا علماء النفس في عدم التزامهم للموضوعية العلمية والمنهج التجريبي: أن أولئك العلماء لا يدرسون صوفية موجودة فعلا، وإنما يكتفون بتحليل ما خلفه الصوفية القدامى من آثار أدبية، وهذا يعني أن دراستهم ليست دراسة تجريبية بمعنى الكلمة. " و من الأخطاء الشائعة عند علماء النفس أن بعض السلوكيات الصوفية اعتبروها حالات مرضية عقلية. غير أن هذا الطرح عند هؤلاء ليس بحقيقة موضوعية إذ ما يشعر به الصوفي في لحظات معينة من الزمن النفسي الذاتي يغيب فيها عن ذانه مؤقتا ويدفع به أن يقول : أن عالم الظواهر لا حقيقة له وهذا لا يبرر الحكم على الصوفي بأنه شخص مريض أو صاحب شخصية غير سوية ، والمعلوم في علم النفس المرضي، وخاصة العقلي منه أن المريض العقلي هو الذي يصاحبه فقدان مستمر للشعوربالأنا. فينتقل من عالم الوعي إلى عالم اللاوعي، وسماه فرويد باللاشعور ، ويبقى يعيش في منطق هذا العالم مدة طويلة من الزمن في حين أن الصوفي يغيب للحظات زمنية دون أن يفقد الوعي بذاته ولو اعتبرنا الصوفي مريض لأمكننا أيضا أن نحكم بالقياس على كل من الشاعر ن والكاتب، والفنان والموسيقي، والقاص بأنهم مرضى لا شيء إلا أنهم يعانون من عواطف ومشاعر وأحاسيس خاصة لا يعانون منها غيرهم .
5.3 الحقل الزمني في ظهور التصوف :
إن الفعل الزمني الذي يحدد ظهور التصوف تضارب حوله الآراء وذلك من حيث بدايته فهناك روايات منها أن ظهور التصوف يرجع إلى العصر الجاهلي ونركز على روايتين بارزتين في هذا الحدث ، إحداها تمثلها رواية عن والدة الغوث بن مر، لما كان لم يعش لها أولاد دعت الله ونذرت لئن عاش لها ولد تربطه بالكعبة فلما أنجبت الغوث بن مر ربطته بالكعبة فاسترخى من شدة الحر فقالت : ما صار ابني إلا صوفة ، فسمي بهذا القول من أمه من أهل بلدته بصوفه ولما كبر صار خادما ببيت الله الحرام اقتدى به جمهور من الناس سكنوا الكعبة ، وانقطعوا للعبادة فسموا بالصوفية ونظرا لتعبده أصبح الحاج وإيجازة الناس من عرضه إلى منى ومن منى إلى الكعبة يتمان بأمره ، ثم صارت بعده تقليدا في عقبه ثم تطورت التسمية فأصبحت كلمة صوفي تطلق على كل من قام بشيء من أمر من المناسك
أما الرواية الثانية : ذكرها السراج الطوسي عن كتاب أخبار مكة خلاصتها أن مكة خلت في بعض الأزمان من الطوافين باستثناء رجل كان يطوف بالكعبة يدعى بصوفي هذا وقد أجمعت مصادر تاريخية وفكرية تناولت التصوف من الناحية الزمنية أن ظهوره كان قبل اكتمال المائة الثانية للهجرة وهؤلاء أبو القاسم القشيري والسراج الطوسي وعبد الرحمن بن خلدون بحجة أن صحابة النبي كانوا يعرفون باسم الصحابة ثم الذين نهجوا نهج الصاحبة ومسلكهم عرفوا بالتابعين ثم الذين أردفوا على سيرة التابعين عرفوا بتابعين التابعين وأن هؤلاء بدأ عندهم التصوف في شكل حركة زهدية والعلة في وجود هذه الحركة اعتكاف الصحة والتابعين وتابعي التابعين على فهم الاسلام والتوغل في مكنوناته وفقه غوامضه وذوق معانيه وتجلي انواره بأدوات معرفية أوجبها الاسلام في حد ذاته كتلاوة القرآن والتدبر فيه والحامل للكثير من الآيات الناصة والداعية إلى الزهد والتصوف منها قول الله تعالى : من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وأيضا يقول الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما منعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وكذلك التحلي بلبس السيرة النبوية وظهورها في السلوك عملا وقولا وفعلا إضافة إلى ذلك هناك الكثير من أقوال النبي في الزهد فقد ذكر الغزالي "ت 505هـ " في كتابه إحياء علوم الدين حديثا للنبي يدعو فيه إلى الزهد يقول : " من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه فأنطق بها لسانه وعرفه داء الدنيا ودوائها وأخرجه منها مسالما إلى دار السلام وقد ذكرت لنا مصادر التصوف الأصيلة أن ثمة تطورات تاريخانية كانت سببا في نقل بعض المسلمين من حياة الزهد إلى حياة التصوف فالإمام القشيري والعلامة ابن خلدون يؤكدان على ظهوره أنه مر بظروف صعبة تميزت بالبدع في المعتقدات، وكان سببا في نشأتها وتناميها وقوف الفرق الإسلامية بجانبها كالمعتزلة والرافضة والخوارج كل يدعي الزهد في الدنيا بالابتعاد عن زخرفها ومادياتها وكل ما يحيط بها من زينة وبهاء ناشدين بالعكوف عن الزهد من الدنيا بحب الآخرة والغوص في نشوة رحابها بغياب جسدي وحضور روحي ، فولعوا بطلب علوم الآخرة فشدوا عليها بالنواجذ ، وفي مقابل هؤلاء نجد الفقهاء اهتموا بعلوم الدنيا ألموا بكلياتها ووقفوا على دقائقها وجزئياتها منها أحكام المعاملات وفقه العبادات الظاهرة وعلة ذلك في نظر بعض المحققين كان لأجل الفوز بمناصب الفتوى ومنه تطور فقه الظاهر ، وكثرت العناية به في حين أهتم الأغلبية من المسلمين بالجانب الإقتصادي المالي منه بالخصوص في الكسب والامتلاك وهذا ما دفع بهم إلى النسيان والغفلة عن أعمال القلوب كما يذكر ابن خلدون مما جعل أهل السنة المهتمين بأعمال القلوب والمتأثرين بالسلف الصالح ، في سيرته الظاهرة والباطنة بتمسكهم للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عملا وقولا وفعلا كالتأمل في نصوص القرآن وحسن تلاوته والمواظبة على ملازمته والفقه في فهم نصوص الأحاديث النبوية والاجتهاد في التشبث بالسنة النبوية بأكملها هذا وعرف التصوف تطورا ملحوظا في سلم الترقي المعرفي بدءً من القرن الثاني للهجرة الموافق القرن الثامن للميلاد إلى غاية القرن السابع للهجرة الموافق القرن الثالث عشر الميلادي إذ أصبح علما قائما بذاته له موضوعه وخصوصياته ومنهجه وصار له اتجاها نفسيا وعقليا ويعد بوجه عام فلسفة حياة ونموذج معين في السلوك يتحلى به المتصوف ويتشبث فيه قصد تحقيق غايته الأخلاقية المطلقة بادراك كماله المطلق وعرفانه بالحقيقة السرمدية ، وسعادته الروحية المطلقة .
1- أنها أحوال إدراكية إذ تظهر لأصحابها كحالات معرفة وتكشف لهم في حقائق موضوعية فهي بمثابة الإلهامات النورانية وليس من مسالك المعرفة البرهانية.
2- إن هذه الأحوال المعرفة والتي صورتها إلهامات لا يمكن وصفها أو التعبير عنها لأنها أحوال وجدانية شعورية وبالتالي يصعب نقل هذه الأحوال إلى الغير أو الآخر في صورة لفظية دقيقة.
3- هذه الأحوال الوجدانية النفسية سريعة الزوال لا تثبت عن حال فلا تستمر مع الصوفي لمدة طويلة لكن آثارها ثابتة في ذاكرة صاحبها على نحو ما.
4- إن هذه الأحوال الوجدانية سالبة ليس موجبة لاعتبار أن الإنسان لا يحدثها بإرادته إذ هو في تجربته الصوفية يبدوا كما لوكان خاضعا لقوة خارجية تسيطر عليه وهناك باحث غربي آخر وهو بيوك " R.m Bueke" يحدد سبع خصائص لأحوال التصوف هي :
- النور الباطني الذاتي. - الشعور بالخلود .
- السمو الأخلاقي. - فقدان الخوف من الموت .
- الإشراف العقلي. - فقدان الشعور بالذنب .
- المفاجأة.
إلى جانب هذه الخصائص التي ذكرها كل من جيمس وبيوك للتصوف والتي هي موجودة في معظم أنواع التصوف، غير أنها ليس شاملة وعامة لأن هناك خصائص أخرى وهي في مستوى الخصائص المذكورة آنفا من حيث الأهمية منها سعادة النفس أو الرضا والشعور والإحساس بالطمأنينة الشعور بالفناء التام في الحقيقة المطلقة، الشعور بإيمان المعرفة النورانية، الشعور بالقدرة على تجاوز المكان والزمان وغير ذلك ما نجده لدى الصوفية، لكن هناك محاولة أخرى للفيلسوف برترندراسل تتمثل في حصر الحقائق الفلسفية للتصوف حيث أنتهى من خلال تحليله لأحوال التصوف في معطاها الخاص والعام إلى القول بأربعة خصائص تميز التصوف عن غيره من الفلسفات في العصور بأزمانها المختلفة في كل أنحاء العالم ببيئاته الثقافية والاجتماعية والحضارية وهي
أولا : الاعتقاد في الكشف أو البصيرة منهجا في المعرفة مقابلا للمعرفة التحليلية والاستدلالية .
ثانيا : الاعتقاد في وجدة الوجود وإطاره الكلي ورفض الكل ، ورفض كل التضاد والقسمة أيا كانت صورها .
ثالثا : إنكار الحقيقة الزمانية .
رابعا: الاعتقاد أن قيمة الشر المحض شيء ظاهري ووهم مترتب على القسمة والتضاد اللذين يحكم بهما العقل التحليلي
وما يلاحظ عن هذه الخصائص عند رسل أن الخاصية الأولى ، وهي الاعتقاد في الكشف أو الإدراك المباشر الوجداني هو المنهج الصحيح للمعرفة بصورة عامة بين أهل الصوفية على الرغم من اختلاف مذاهبهم وعصورهم أما الخصائص الثلاث الأخرى فهي تصدق على أهل الصوفية القائلين بوحدة الوجود فقط وليس كل المتصوفة يقول بهذا المذهب. وقد يذكر أبو الوفاء الغنيمي التفتازاني وجهة نظره الخاصة التي أثبت فيها أن للتصوف بصورة عامة خمسة خصائص نفسية وأخلاقية، وإبستمولوجية وتنطبق على مختلف 2. 2.3 أنواع التصوف :
1- الترقي الأخلاقي، في نظره أن كل تصوف يضم في جوهره قيم أخلاقية معينة الغرض منه تصفية النفس من أجل الوصول إلى تحقيق هذه القيم، ولا يكون هذا حاصل للصوفي إلا بشروط إلزامية تتجسد في مجاهدات بدنية، ورياضية نفسية معينة، وزهد في بهرج الحياة ومادياتها .
2- الفناء في الحقيقة المطلقة ، إن هذه الخاصية الصوفية تميز التصوف بمعناه الاصطلاحي الدقيق ويقصد بالفناء وصول الصوفي من رياضته ومجاهدته البدنية والروحية إلى حالة نفسية معينة لا يعود يشعر معها بأنيته كما يشعر ببقائه مع حقيقة أسمى مطلقة هي الله عند صوفية المسلمين ، أو الكلمة عند صوفية المسيحيين أو براهما في تصوف البرهمية " الهنود" وهكذا .. كما أن الصوفي يقصد من وراء الفناء أن تفنى إرادته في إرادة المطلق ، وقد عبر بعض الصوفية إلى القول بالاتحاد بهذه الحقيقة أو أنها حلت فيهم أو أن الوجود واحد لا كثرة فيه بوجه ما ، ولا يذهب بعضهم إلى القول بمثل هذه الآراء ف-ي الاتحاد أو الحلول ، أو وحدة الوجود وإنما يعودون من فنائهم إلى إثبات الإثنينية أو الكثرة في الوجود وعلى هذا تكون خاصية الفناء تتصف بها صوفية مذهب الوحدة في الوجود ، وتنطبق عليهم كما تنطبق على غيرهم من الصوفية الذين لم يقولوا بها .
3- العرفان الذوقي المباشر: يرى أبو الوفاء الغنيمي أن هذه الخاصية هي بمثابة قياس إبستمولوجي دقيق يميز التصوف عن غيره من الفلسفات فإذا كان الإنسان يعتمد علة مناهج الاستدلال العقلي في فلسفته لإدراك الحقيقة فهو فيلسوف ، أما إذا كان يؤمن أن وراء إدراكات الحس والاستدلالات العقلية منهجا آخر للمعرفة بالحقيقة يسميه كشفا أو ذوقا أو ما شابه ذلك من التسميات ، فهو في هذه الحالة صوفي ، وهذا الكشف الذي آل إليه الصوفي آن ويمكننا أن نقول أننا لا نستطيع أن نقيس زمانه فهو سريع الزوال أشبه شيء بالومضة السريعة المفاجئة
4- الطمأنينة أو السعادة : أنها الخاصية التي تجعل من الصوفي أن يقهر كل دواعي غرائز وشهوات البدن أو ضبطها ، ويحدث في ذاته نوع من التوازن النفسي، والتوافق النفسي، من شأنه أن يجعله متحررا من كل مخاوفه شاعرا براحة نفسية عميقة أو طمأنينة تتحقق معها سعادته مع العلم أن الصوفية قد أشاروا في كتاباتهم النثرية والشعرية أن الفناء في المطلق والمعرفة به يحدثان في نفس الإنسان سعادة لا توصف .
5- الرمزية في التعبير : إن هذه الخاصية تتمثل في وجود ألفاظ أو دلالات صوفية يهيمن عليها الرمز، ومن المعلوم أن عبارات الصوفية غالبا ما نجدها تحمل معنيين أحدهما يستفاد من ظاهر الألفاظ، والآخر بالتحليل والتعمق فالمعنى الأخير هو الذي يصعب فهمه بالنسبة لغير الصوفي، فصعوبة فهم كلام الصوفية، وصعوبة معرفة مقاصدهم وغايتهم وعلتها، حالات نفسية وجدانية خاصة يصعب التعبير عنها بألفاظ اللغة، وليست شيئا مشتركا بين الناس جمعيا. وأن كل صوفي له طريقة معينة تعبر عن حالاته، وبالتالي أن التصوف خبرة ذاتية وجدانية ذوقية مما يمكننا أن نقارن التصوف بالفن وأذواقه المختلفة لكون أن منطلقهما واحد يتمثل في الخبرة الذاتية لأن أهل الصوفية يعتمدون وصف حالاتهم الوجدانية على الاستنباط الذاتي أساسا وأي معرفة على هذا النحو يصعب فهمها على الغير ومن هنا توصف بأنها رمزية، مع العلم أن هذه الخصائص كما يذكرها " أبو الوفاء الغنيمي : تصدق على أي تصوف في صورته الناضج أو الكامل، وأن التصوف في أية حضارة يمر بمراحل مختلفة من التطور ، وعندئذ قد تنطبق بعض تلك الخصائص على بعض هذه المراحل دون البعض الآخر، كما هو الشأن في التصوف الإسلامي وفي ضوء هذه الخصائص الخمس كما يرى التفتازاني يمكن وضع تعريف للتصوف. إذ هو فلسفة حياة عملية تمسو بالإنسان إلى مستوى السعادة الروحية والرقي الأخلاقي ويبعده عن كل شرور الدنيا وملذاتها والعرفان بالتصوف ذوقا لا برهنة عقلية ويصعب التعبير على خلجات المتصوف والحالة المصاحبة للفعل التصوفي باللغة العادية لأنها وجدانية الطابع وذاتية بل أكثر من ذلك أنها عاطفية ذوقية.
3.3 اختلاف المقاصد والغايات من التصوف عند المتصوفة :
إن الخصائص المذكورة للتصوف تمثل مرحلة نضوجه الكاملة وبالتالي فإن القصد والغاية من التصوف يختلف باختلاف مراحل تطوره لذلك نجد المتصوفة يختلفون فيما بينهم من حيث السلوكات الوجدانية فهناك من المتصوفة يقف بسلوكه عند الغاية الأخلاقية وهي تهذيب النفس وضبط الإرادة وإلزام ،الإنسان بالأخلاق الفاضلة السامية ويتميز هذا التصوف بخاصية السلوك التربوي عند التربويون كما حدث في العصر الحديث ، أو ما كان يعرف في التربية القديمة بالمؤدب ، وعلى هذا الأساس يتصف التصوف بالصبغة العملية ومن المتصوفة من يذهب إلى أبعد من هذه الغاية الأخلاقية العملية في مسلكها ونهجها هادفا إلى معرفة غاية أسمى، وهي معرفة الله والمتصوف في طلبه لهذه المعرفة يضع في بداية المنطلق شروطا خاصة بهذا المنحى لبغلي السامي ذو البعد الماورائي أو الميتافيزيقي لهذا فإن من أصحاب هذا التصوف تجدهم يعتنون بالخصوص بمناهج للمعرفة وأدواتها ويؤثرن من بينها على الكشف، إضافة إلى هذا أن هناك أنواع من التصوف تصطبغ بالصبغة الفلسفية يهدف أصحاب هذه الأنواع إلى اتخاذ مواقف من الكون محاولين بذلك إيجاد تفسير له ، وتحديد صلته بخالقه وصلة الإنسان بالله_ وهذه المذاهب الصوفية قائمة على أساس الذوق فالصوفي يغيب في لحظات معينة عن شعوره بذاته فيشعر بأن العالم الخارجي، لا حقيقة له بالقياس إلى الله وملكوته ويترتب على هذا النهج الصوفي أو الذوقي مذاهب صوفية معينة كمذهب الوجود، ومذهب الحلول، والاتحاد ، ولكن هذه المذاهب الصوفية لا تخرج عن كونها في الأساس مذاقات خاصة تختلف كل الاختلاف عن تلك الأنسقة الفكرية والعلمية المبنية على الاستدلال العقلي والتجريبي فهي معرفة ذوقية ذاتية خاصة وهو بهذا يختلف عن الفلسفة التي بدورها تجربة خاصة وذاتية ولكنها تعتمد العقل في تقرير نتائجها وطرح أفكارها أما التصوف فهو تجربة ذاتية يعتمد الذوق الذاتي الوجداني الخاص الصادر عن الكشف أو المسلك النوراني فهو لا يعتمد البرهان وقد روي في علم التصوف أن جميع معارفه وعلومه ذوق إذ سئل الإمام محي الدين ابن عربي من أحد تلامذته قائلا : " أن الناس ينكرون علينا علومنا ويطالبوننا بالدليل عليها " فقال له ابن عربي ناصحا : " إذا طلبك أحد بالدليل والبرهان على علوم الأسرار الإلهية فقل: " ما الدليل على حلاوة العسل ، فلا بد أن يقول لك هذا علم لا يحصل إلا بالذوق فقل له : هذا مثل ذلك ." تمثل إجابة ابن عربي عن سعة إدراكه لعلم التصوف والقوة في قوة تحليل موضوعه باصدراه لحكم تقريري وتقييمي في الآن نفسه أن التصوف يتعلق بمجال العواطف الإنسانية التي يهيمن عليها طابع الكيفية فهي لا تخضع للقياس الكمي لأنها ظواهر لا مكان لها تجري في الزمان فهي خارج إطار الموضوع المكاني يتم معرفتها عن طريق المعاناة الشخصية كما أنها غير خاضعة لمنطق العقل واستدلالاته
4.3 التصوف وعلم النفس :
توجد دراسات كثيرة حول التصوف من طرف علماء النفس وخاصة المختصين في الجانب الديني منه -علم النفس الديني - ومن هؤلاء العلماء نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر عالم الأمريكي ويليام جيمس "James (w) ولوبا جيمس leuba (James) (H) وأندرهيل underhill Evelyn و ما لوحظ عن علماء النفس الذين درسوا التصوف دراسة موضوعية علمية، لم ينصفوا الصوفية، والسبب في ذلك تعود في نظر أبو الوفاء التفتازاني " معاصر " إلى بعض الأخطاء المنهجية التي وقعوا فيها ، حيث ضيقوا نطاق بحثهم في التجربة الحسية وحدها من دون أن يعتنوا بالتدقيق والتمحيص في فهم مصطلحات الصوفية التي عبروا بها عن أحوال وجدانية ذاتية خالصة، لا تتصف بصفة العمومية إنما هي تجارب ذاتية متمايزة من شخص للآخر تخضع للزمان النفسي الذاتي ويضيف التفتازاني قائل : " بأن الباحث لكي يحكم على هذا النوع من الحالات الصوفية حكما علميا فلابد له أن يقوم بتجريبه، أو يكون له استعداد معين لتذوقه ، أما أن يصطنع لماء النفس في بعض الأحيان منهج المماثلة في دراسة حالات التصوف، فهذا من الخطأ بعينه لتعذرمماثلتهم للصوفي في حالاته الوجدانية الخاصة مماثلة حقيقية، وهو ليسوا بصوفية. " ويضيف ناقدا علماء النفس في عدم التزامهم للموضوعية العلمية والمنهج التجريبي: أن أولئك العلماء لا يدرسون صوفية موجودة فعلا، وإنما يكتفون بتحليل ما خلفه الصوفية القدامى من آثار أدبية، وهذا يعني أن دراستهم ليست دراسة تجريبية بمعنى الكلمة. " و من الأخطاء الشائعة عند علماء النفس أن بعض السلوكيات الصوفية اعتبروها حالات مرضية عقلية. غير أن هذا الطرح عند هؤلاء ليس بحقيقة موضوعية إذ ما يشعر به الصوفي في لحظات معينة من الزمن النفسي الذاتي يغيب فيها عن ذانه مؤقتا ويدفع به أن يقول : أن عالم الظواهر لا حقيقة له وهذا لا يبرر الحكم على الصوفي بأنه شخص مريض أو صاحب شخصية غير سوية ، والمعلوم في علم النفس المرضي، وخاصة العقلي منه أن المريض العقلي هو الذي يصاحبه فقدان مستمر للشعوربالأنا. فينتقل من عالم الوعي إلى عالم اللاوعي، وسماه فرويد باللاشعور ، ويبقى يعيش في منطق هذا العالم مدة طويلة من الزمن في حين أن الصوفي يغيب للحظات زمنية دون أن يفقد الوعي بذاته ولو اعتبرنا الصوفي مريض لأمكننا أيضا أن نحكم بالقياس على كل من الشاعر ن والكاتب، والفنان والموسيقي، والقاص بأنهم مرضى لا شيء إلا أنهم يعانون من عواطف ومشاعر وأحاسيس خاصة لا يعانون منها غيرهم .
5.3 الحقل الزمني في ظهور التصوف :
إن الفعل الزمني الذي يحدد ظهور التصوف تضارب حوله الآراء وذلك من حيث بدايته فهناك روايات منها أن ظهور التصوف يرجع إلى العصر الجاهلي ونركز على روايتين بارزتين في هذا الحدث ، إحداها تمثلها رواية عن والدة الغوث بن مر، لما كان لم يعش لها أولاد دعت الله ونذرت لئن عاش لها ولد تربطه بالكعبة فلما أنجبت الغوث بن مر ربطته بالكعبة فاسترخى من شدة الحر فقالت : ما صار ابني إلا صوفة ، فسمي بهذا القول من أمه من أهل بلدته بصوفه ولما كبر صار خادما ببيت الله الحرام اقتدى به جمهور من الناس سكنوا الكعبة ، وانقطعوا للعبادة فسموا بالصوفية ونظرا لتعبده أصبح الحاج وإيجازة الناس من عرضه إلى منى ومن منى إلى الكعبة يتمان بأمره ، ثم صارت بعده تقليدا في عقبه ثم تطورت التسمية فأصبحت كلمة صوفي تطلق على كل من قام بشيء من أمر من المناسك
أما الرواية الثانية : ذكرها السراج الطوسي عن كتاب أخبار مكة خلاصتها أن مكة خلت في بعض الأزمان من الطوافين باستثناء رجل كان يطوف بالكعبة يدعى بصوفي هذا وقد أجمعت مصادر تاريخية وفكرية تناولت التصوف من الناحية الزمنية أن ظهوره كان قبل اكتمال المائة الثانية للهجرة وهؤلاء أبو القاسم القشيري والسراج الطوسي وعبد الرحمن بن خلدون بحجة أن صحابة النبي كانوا يعرفون باسم الصحابة ثم الذين نهجوا نهج الصاحبة ومسلكهم عرفوا بالتابعين ثم الذين أردفوا على سيرة التابعين عرفوا بتابعين التابعين وأن هؤلاء بدأ عندهم التصوف في شكل حركة زهدية والعلة في وجود هذه الحركة اعتكاف الصحة والتابعين وتابعي التابعين على فهم الاسلام والتوغل في مكنوناته وفقه غوامضه وذوق معانيه وتجلي انواره بأدوات معرفية أوجبها الاسلام في حد ذاته كتلاوة القرآن والتدبر فيه والحامل للكثير من الآيات الناصة والداعية إلى الزهد والتصوف منها قول الله تعالى : من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وأيضا يقول الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما منعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وكذلك التحلي بلبس السيرة النبوية وظهورها في السلوك عملا وقولا وفعلا إضافة إلى ذلك هناك الكثير من أقوال النبي في الزهد فقد ذكر الغزالي "ت 505هـ " في كتابه إحياء علوم الدين حديثا للنبي يدعو فيه إلى الزهد يقول : " من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه فأنطق بها لسانه وعرفه داء الدنيا ودوائها وأخرجه منها مسالما إلى دار السلام وقد ذكرت لنا مصادر التصوف الأصيلة أن ثمة تطورات تاريخانية كانت سببا في نقل بعض المسلمين من حياة الزهد إلى حياة التصوف فالإمام القشيري والعلامة ابن خلدون يؤكدان على ظهوره أنه مر بظروف صعبة تميزت بالبدع في المعتقدات، وكان سببا في نشأتها وتناميها وقوف الفرق الإسلامية بجانبها كالمعتزلة والرافضة والخوارج كل يدعي الزهد في الدنيا بالابتعاد عن زخرفها ومادياتها وكل ما يحيط بها من زينة وبهاء ناشدين بالعكوف عن الزهد من الدنيا بحب الآخرة والغوص في نشوة رحابها بغياب جسدي وحضور روحي ، فولعوا بطلب علوم الآخرة فشدوا عليها بالنواجذ ، وفي مقابل هؤلاء نجد الفقهاء اهتموا بعلوم الدنيا ألموا بكلياتها ووقفوا على دقائقها وجزئياتها منها أحكام المعاملات وفقه العبادات الظاهرة وعلة ذلك في نظر بعض المحققين كان لأجل الفوز بمناصب الفتوى ومنه تطور فقه الظاهر ، وكثرت العناية به في حين أهتم الأغلبية من المسلمين بالجانب الإقتصادي المالي منه بالخصوص في الكسب والامتلاك وهذا ما دفع بهم إلى النسيان والغفلة عن أعمال القلوب كما يذكر ابن خلدون مما جعل أهل السنة المهتمين بأعمال القلوب والمتأثرين بالسلف الصالح ، في سيرته الظاهرة والباطنة بتمسكهم للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عملا وقولا وفعلا كالتأمل في نصوص القرآن وحسن تلاوته والمواظبة على ملازمته والفقه في فهم نصوص الأحاديث النبوية والاجتهاد في التشبث بالسنة النبوية بأكملها هذا وعرف التصوف تطورا ملحوظا في سلم الترقي المعرفي بدءً من القرن الثاني للهجرة الموافق القرن الثامن للميلاد إلى غاية القرن السابع للهجرة الموافق القرن الثالث عشر الميلادي إذ أصبح علما قائما بذاته له موضوعه وخصوصياته ومنهجه وصار له اتجاها نفسيا وعقليا ويعد بوجه عام فلسفة حياة ونموذج معين في السلوك يتحلى به المتصوف ويتشبث فيه قصد تحقيق غايته الأخلاقية المطلقة بادراك كماله المطلق وعرفانه بالحقيقة السرمدية ، وسعادته الروحية المطلقة .
6.3 منزلة التصوف كعلم في منظومة العلوم الإسلامية :
1.6.3 مقارنة بين الفقه والتصوف :
لقد سبق أن أشرنا إشارة خفيفة إلى التفرقة بيبن الفقه والتصوف للبيان الفاصل بينهما، ونعود الآن لهذه المسألة للتفصيل فيها بشيء من التوسع في التحليل قاصدين بذلك غاية تحقيق التصوف كعلم قائم نسقه ضمن منظومة العلوم الإسلامية فقد كان علماء المسلمين في القرن الرابع الهجري، العاشر الميلادي يقسمون العلوم إلى علوم عربية وإلى علوم الأوائل ، أو علوم العربية وغير العربية، فالأولى هي علوم اللسان، والفقه والكلام، والتاريخ، وعلوم الأدب أما الثانية وهي العلوم الفلسفية كالعلوم الطبيعية والرياضية والإلهية وقد ذكر هذا التقسيم كثير من العلماء في مؤلفاتهم كالفارابي ، وابن سينا، والغزالي، وابن خلدون، فهذا أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن يوسف الخوارزمي يذكر في كتابه " مفاتيح العلوم " هذا التقسيم حيث يقول : " وجعلته مقالتين : إحداهما لعلوم الشرائع وما يقترن بها من العلوم العربية ، والثانية لعلوم العجم من اليونانيين وغيرهم من الأمم " فتعددت الآراء واختلفت وجهات النظر حول ظهور الفقه وكذلك التأثيرات الخارجية التي أثرت في نشأته وخاصة من علماء الاستشراق أمثال " كارادي فو " وجولد تيسهر " وفون كريمر، و " دي بور" التي أثرت في نشاـه وخاصة من علماء الاستشراق أمثال " كارادي فو " و " جولدتيسهر" و"فون كريمر " ," دي بور " التي حاولت هذه النظريات المختلفة في الاستشراق أن تفسر نشأة الفقه وتطوره والبحث عن العوامل الخارجية التي أدت إلى ظهوره تطوره كعلم وليس المهم في عرض هذه النظريات والإشادة بها إنما ما يهمنا في هذا المجال أن طبيعة الفقه كعلم ظاهر لظاهر الشريعة، وأن الصوفية حاولوا إقامة التصوف كعلم لباطن الشريعة يحاربون به الفقهاء فعلم الفقه يتناول حياة المسلم من جميع نواحيها فالإيمان أول واجبات المسلم وفي بداية نشأته واجه الفقه مقاومة شديدة وهذا شأن كل جديد فبسببه صارت أحكام الشريعة مسائل نظرية، وتحول امتثال الدين إلى تعمق وتدقيق في النظر وقد أثار هذا النهج الديني المعرفي الجديد معرضة ونقض من جانب أهل الورع والزهد ، وكذلك من جانب أهل السياسية والحكم أيضا ومع ذلك ألتف عامة الناس حول العلم واعترفوا بنهجه ونتائجه المعرفية شيئا فشيئا بحجة أن العلماء هم ورثة الأنبياء ، وقد ذهب " دي بور " مؤكدا أن علم الأحكام " الفقه " قد نما قبل علم العقائد ، " علم الكلام " واستطاع أن يحتل مكانة ممتازة بين المسلمين لأنه يعتبر من مبادئ وأسس التربية الصالحة فعلم الفقه قوت النفوس المؤمنة لا غناء لها عنه كل يوم ، أما علم الكلام فهو دواء للنفوس المريضة وغاية الفقه أقسامه الحياة وتقييمها على نهج ديني تقريري، واختلفت مدارس الفقه ومذاهبه مع تطور الحياة الإسلامية في تمدنها الثقافي الديني فظهر فريقان، فريق يمثل هذا الرأي وغالبيتهم يقطنون العراق مكانا ، وفريق أهل الحديث والسنة غالبيتهم يقطنون أهل المدينة ومكة مكانا وسمي الفقها الذين جعلوا لرأيهم في إصدار الأحكام ، أي غلبوا العقل على الدين بأهل الرأي، وإمامهم الأكبر أبو حنيفة ( ت عام 150 هـ ) وسمى الفقهاء الذين جعلوا للنص شأنا في اصدار الأحكام بأهل الحديث والسنة وهم الفقهاء في المدينة وإمامهم الأكبر مالك بن أنس ( ت عام 189هـ ) وكانوا يستعملون الرأي استعمالا لم يكن منه بأس وإن كان قليل المدى وقد استعمله تلامذة المالكية كالإمام الشافعي (ت عام 204هـ ) صاحب الفقه الثالث الذي اعتمد في أكثر اجتهاداته على السنة ، وهذا ما جعله في عداد أهل الحديث تمييزا له عن أبي حنيفة على الرغم أنه يميل إلى أهل الرأي ودليلنا في ذلك كتابه الرسالة الذي توجد فيه استنباطات عقلية لأحكام شرعية ، كما يلح على ضرورة استخدام القياس العقلي في تقرير الأحكام.
إن علم الفقه لم يظل علما حبيسا لتطبيقات قانونية محضة يتصل بالأعمال الواجبة والمستحبة والجائزة والمباحة والمكروهة فقط الأعمال التي تستحق الثواب والعقاب من جانب الشرع تحول علم الفقه إلى علم أخلاقي تهذيبي بالمعنى الصحيح وقد نص الإسلام في أكثرمن نص سواء من القرآن أو الحديث على التكمل الأخلاقي بالفضائل الخلقية، وعلى التكمل العقلي بالمعارف، والتكمل الديني بالعبادات والتي الغاية منها تعظيم الله جل جلاله والترقي والسمو بالإنسان إلى معارج القدس، ونجد الكثيرمن الفقهاء، اهتموا بهذا الجانب الخلقي، وخاصة الفضائل الخلقية الدينية، ويتسم الفقهاء الذين بحثوا هذا النحو الأخلاقي الديني بنزعة الدين والتصوف وعلى سبيل المثال في ذلك – الحارث بن أسد المحاسبي وهو من متصوفة مدرسة بغداد بكتابه المسمى " الرعاية لحقوق الله " وجاء بعده " أبو طالب المكي " بكتابه " قوت القلوب " ، " والغزالي " بكتابه " إحياء علوم الدين " ومما لا شك فيه أن هناك محاولات تأسيسية سبقت هؤلاء جميعا وللعلم نجدها عند صوفية مدرسة بغداد لإقامة التصوف كعلم من العلوم ، أو أنه " ظاهرة دينية فريدة لتربية المسلمين تربية ذوقية وجدانية تمس القلب والروح قبل الجوارح والأعضاء، واعتبر التصوف علما عمليا من حيث أنه يرتبط بالمجاهدة والرياضة والأحوال، والمقامات فقد ظهر التصوف كعلم أخروي يعطي المفهومات الفقهية الجامدة من تحليل وتحريم روحا جديدة ويمزجها بالعاطفة الدينية المؤسسة على أعمال القلوب من مقامات وأحوال وتنحصر هذه لأعمال في التصديق والإيمان واليقين والصدق والإخلاص والمعرفة والتوكل والمحبة والشوق والوجد وغير ذلك من أحوال الصوفية ومقاماتهم " وكان نتيجة هذا العلم أنه اتجه إلى فهم العبادات والأحكام اتجاها باطنيا أخرجها على حد تعبير أهل الصوفية أنفسهم من حدود الفقه الجامدة، وقد أدرك أهل التصوف منذ البداية أن علمهم يؤسس على الكتاب والسنة مما كان لهم شأن كشأن كل فرقة إسلامية ولم يحدث إنسجام وتوافق على اتفاق في فهم الأصول والعمل بالفروع بصورة واحدة مما دفع بكل الفريقين أهل التصوف، وأهل الفقه ، إلى صراع ومشاحنة أفضت في بعض الأحيان إلى إعدام وقتل نفر من الصوفية أشهرهم في ذلك الحلاج ، وحدث أن وقع بين الإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حبل من ناحية باعتبارهما من الفقهاء ، وبين شيبان الراعي الصوفي، كما حدث خلاف بين أبي عمران الأشيب الفقيه وأبي بكر الشبلي الصوفي في مسألة الحيض، ومع ذلك يجب أن نذكر بعض الفقهاء المعتدلين الذين وقفوا موقف تقدير واحترام وتبجيل، من الصوفية المخلصين لدينهم ومبادئهم .
إن كثير من مؤرخي التصوف تنبهوا إلى أن الفقهاء لا يعترفون بوجود علم باطن ولا معنى عندهم لقيامه أو قيام علم التصوف، وإنما يقرون وفقط بوجود علم الشريعة الظاهرة التي صرح وجاء بها نصا كل من الكتاب والسنة، وهذا ما كان مؤرخي التصوف وأهل التصوف أن يقفوا موقفا معاديا ومعارضا لموقف الفقهاء ورفض آرائهم في ذلك.
7.3 التصوف كعلم في تصور أهل الصوفية ومؤرخي التصوف :
هناك كثيرمن أهل الصوفية ومؤرخي التصوف يدافعون على علم التصوف كعلم قائم بذاته له موضوعه ومنهجه و رجاله ومصدر وجوده الشرع الإسلامي، ومن أمثال هؤلاء المؤرخين، وأهل الصوفية ومؤرخيها نذكرما يلي:
أولا : السراج الطوسي : هذا المؤرخ والمتصوف في الآن نفسه راح يؤرخ لعلم التصوف من حيث أنه فرع جديد من فروع المعرفة الإسلامية له موازينه ومقاييسه وموضوعاته وخصائصه وعمل جاهدا على التوفيق بين علم الفقه وعلم التصوف واعتبرهما علما واحدا بحجة دينية وهي أن علم الفقه وعلم التصوف مصدرهما واحد يعودان إليه في التحقيق والضبط وكسب الموضوعية واليقين وهو علم الشريعة الواحد ويرى هذا المؤرخ الصوفي أن التصوف قائم على الدراية في حين أن الفقه قائم على الرواية وأنه من غير الممكن أو اللامعقول أن نحكم القول في وجود العلم إلى علمين ، أن هناك علم باطن ، وعلم ظاهر ، ولكن في الأصل أن العلم متى كان في القلب فهو باطن فيه ، إلى أن يجري على اللسان ويظهر فإذا جرى على اللسان فهو ظاهر وتنقسم أعمال الجوارح الظاهرة إلى العبادة كالطهارة والصلاة والصوم ، والزكاة والحج وغير ذلك ، ثم الأحكام كالطلاق والعتاق والبيوع ، والقصاص ، والفرائض ، لكن علم التصوف أساسه الجوارح الباطنة والتي تتجمع كلها في القلب غير أن لكل عمل من هذه الأعمال الظاهرة والباطنة علم وفقه وبيان وحقيقة وإدراك ووجد ويتأكد من صحة كل منها مصادر الشرع الإسلامي وهما عنده القرآن والأحاديث النبوية ويلتجأ السراج الطوسي لتأكيد العلمين أنهما علما واحدا ويسيران جنبا إلى جنب إلى تذكير بقول الله عز وجل " واسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة " فالنعمة الظاهرة هي فعل الطاعات أم النعمة الباطنة فهي ما أنعم الله بها على القلب من الأحوال والمقامات وهذا من دون أن يستغني الظاهر على الباطن ولا الباطن على الظاهر.
1.6.3 مقارنة بين الفقه والتصوف :
لقد سبق أن أشرنا إشارة خفيفة إلى التفرقة بيبن الفقه والتصوف للبيان الفاصل بينهما، ونعود الآن لهذه المسألة للتفصيل فيها بشيء من التوسع في التحليل قاصدين بذلك غاية تحقيق التصوف كعلم قائم نسقه ضمن منظومة العلوم الإسلامية فقد كان علماء المسلمين في القرن الرابع الهجري، العاشر الميلادي يقسمون العلوم إلى علوم عربية وإلى علوم الأوائل ، أو علوم العربية وغير العربية، فالأولى هي علوم اللسان، والفقه والكلام، والتاريخ، وعلوم الأدب أما الثانية وهي العلوم الفلسفية كالعلوم الطبيعية والرياضية والإلهية وقد ذكر هذا التقسيم كثير من العلماء في مؤلفاتهم كالفارابي ، وابن سينا، والغزالي، وابن خلدون، فهذا أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن يوسف الخوارزمي يذكر في كتابه " مفاتيح العلوم " هذا التقسيم حيث يقول : " وجعلته مقالتين : إحداهما لعلوم الشرائع وما يقترن بها من العلوم العربية ، والثانية لعلوم العجم من اليونانيين وغيرهم من الأمم " فتعددت الآراء واختلفت وجهات النظر حول ظهور الفقه وكذلك التأثيرات الخارجية التي أثرت في نشأته وخاصة من علماء الاستشراق أمثال " كارادي فو " وجولد تيسهر " وفون كريمر، و " دي بور" التي أثرت في نشاـه وخاصة من علماء الاستشراق أمثال " كارادي فو " و " جولدتيسهر" و"فون كريمر " ," دي بور " التي حاولت هذه النظريات المختلفة في الاستشراق أن تفسر نشأة الفقه وتطوره والبحث عن العوامل الخارجية التي أدت إلى ظهوره تطوره كعلم وليس المهم في عرض هذه النظريات والإشادة بها إنما ما يهمنا في هذا المجال أن طبيعة الفقه كعلم ظاهر لظاهر الشريعة، وأن الصوفية حاولوا إقامة التصوف كعلم لباطن الشريعة يحاربون به الفقهاء فعلم الفقه يتناول حياة المسلم من جميع نواحيها فالإيمان أول واجبات المسلم وفي بداية نشأته واجه الفقه مقاومة شديدة وهذا شأن كل جديد فبسببه صارت أحكام الشريعة مسائل نظرية، وتحول امتثال الدين إلى تعمق وتدقيق في النظر وقد أثار هذا النهج الديني المعرفي الجديد معرضة ونقض من جانب أهل الورع والزهد ، وكذلك من جانب أهل السياسية والحكم أيضا ومع ذلك ألتف عامة الناس حول العلم واعترفوا بنهجه ونتائجه المعرفية شيئا فشيئا بحجة أن العلماء هم ورثة الأنبياء ، وقد ذهب " دي بور " مؤكدا أن علم الأحكام " الفقه " قد نما قبل علم العقائد ، " علم الكلام " واستطاع أن يحتل مكانة ممتازة بين المسلمين لأنه يعتبر من مبادئ وأسس التربية الصالحة فعلم الفقه قوت النفوس المؤمنة لا غناء لها عنه كل يوم ، أما علم الكلام فهو دواء للنفوس المريضة وغاية الفقه أقسامه الحياة وتقييمها على نهج ديني تقريري، واختلفت مدارس الفقه ومذاهبه مع تطور الحياة الإسلامية في تمدنها الثقافي الديني فظهر فريقان، فريق يمثل هذا الرأي وغالبيتهم يقطنون العراق مكانا ، وفريق أهل الحديث والسنة غالبيتهم يقطنون أهل المدينة ومكة مكانا وسمي الفقها الذين جعلوا لرأيهم في إصدار الأحكام ، أي غلبوا العقل على الدين بأهل الرأي، وإمامهم الأكبر أبو حنيفة ( ت عام 150 هـ ) وسمى الفقهاء الذين جعلوا للنص شأنا في اصدار الأحكام بأهل الحديث والسنة وهم الفقهاء في المدينة وإمامهم الأكبر مالك بن أنس ( ت عام 189هـ ) وكانوا يستعملون الرأي استعمالا لم يكن منه بأس وإن كان قليل المدى وقد استعمله تلامذة المالكية كالإمام الشافعي (ت عام 204هـ ) صاحب الفقه الثالث الذي اعتمد في أكثر اجتهاداته على السنة ، وهذا ما جعله في عداد أهل الحديث تمييزا له عن أبي حنيفة على الرغم أنه يميل إلى أهل الرأي ودليلنا في ذلك كتابه الرسالة الذي توجد فيه استنباطات عقلية لأحكام شرعية ، كما يلح على ضرورة استخدام القياس العقلي في تقرير الأحكام.
إن علم الفقه لم يظل علما حبيسا لتطبيقات قانونية محضة يتصل بالأعمال الواجبة والمستحبة والجائزة والمباحة والمكروهة فقط الأعمال التي تستحق الثواب والعقاب من جانب الشرع تحول علم الفقه إلى علم أخلاقي تهذيبي بالمعنى الصحيح وقد نص الإسلام في أكثرمن نص سواء من القرآن أو الحديث على التكمل الأخلاقي بالفضائل الخلقية، وعلى التكمل العقلي بالمعارف، والتكمل الديني بالعبادات والتي الغاية منها تعظيم الله جل جلاله والترقي والسمو بالإنسان إلى معارج القدس، ونجد الكثيرمن الفقهاء، اهتموا بهذا الجانب الخلقي، وخاصة الفضائل الخلقية الدينية، ويتسم الفقهاء الذين بحثوا هذا النحو الأخلاقي الديني بنزعة الدين والتصوف وعلى سبيل المثال في ذلك – الحارث بن أسد المحاسبي وهو من متصوفة مدرسة بغداد بكتابه المسمى " الرعاية لحقوق الله " وجاء بعده " أبو طالب المكي " بكتابه " قوت القلوب " ، " والغزالي " بكتابه " إحياء علوم الدين " ومما لا شك فيه أن هناك محاولات تأسيسية سبقت هؤلاء جميعا وللعلم نجدها عند صوفية مدرسة بغداد لإقامة التصوف كعلم من العلوم ، أو أنه " ظاهرة دينية فريدة لتربية المسلمين تربية ذوقية وجدانية تمس القلب والروح قبل الجوارح والأعضاء، واعتبر التصوف علما عمليا من حيث أنه يرتبط بالمجاهدة والرياضة والأحوال، والمقامات فقد ظهر التصوف كعلم أخروي يعطي المفهومات الفقهية الجامدة من تحليل وتحريم روحا جديدة ويمزجها بالعاطفة الدينية المؤسسة على أعمال القلوب من مقامات وأحوال وتنحصر هذه لأعمال في التصديق والإيمان واليقين والصدق والإخلاص والمعرفة والتوكل والمحبة والشوق والوجد وغير ذلك من أحوال الصوفية ومقاماتهم " وكان نتيجة هذا العلم أنه اتجه إلى فهم العبادات والأحكام اتجاها باطنيا أخرجها على حد تعبير أهل الصوفية أنفسهم من حدود الفقه الجامدة، وقد أدرك أهل التصوف منذ البداية أن علمهم يؤسس على الكتاب والسنة مما كان لهم شأن كشأن كل فرقة إسلامية ولم يحدث إنسجام وتوافق على اتفاق في فهم الأصول والعمل بالفروع بصورة واحدة مما دفع بكل الفريقين أهل التصوف، وأهل الفقه ، إلى صراع ومشاحنة أفضت في بعض الأحيان إلى إعدام وقتل نفر من الصوفية أشهرهم في ذلك الحلاج ، وحدث أن وقع بين الإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حبل من ناحية باعتبارهما من الفقهاء ، وبين شيبان الراعي الصوفي، كما حدث خلاف بين أبي عمران الأشيب الفقيه وأبي بكر الشبلي الصوفي في مسألة الحيض، ومع ذلك يجب أن نذكر بعض الفقهاء المعتدلين الذين وقفوا موقف تقدير واحترام وتبجيل، من الصوفية المخلصين لدينهم ومبادئهم .
إن كثير من مؤرخي التصوف تنبهوا إلى أن الفقهاء لا يعترفون بوجود علم باطن ولا معنى عندهم لقيامه أو قيام علم التصوف، وإنما يقرون وفقط بوجود علم الشريعة الظاهرة التي صرح وجاء بها نصا كل من الكتاب والسنة، وهذا ما كان مؤرخي التصوف وأهل التصوف أن يقفوا موقفا معاديا ومعارضا لموقف الفقهاء ورفض آرائهم في ذلك.
7.3 التصوف كعلم في تصور أهل الصوفية ومؤرخي التصوف :
هناك كثيرمن أهل الصوفية ومؤرخي التصوف يدافعون على علم التصوف كعلم قائم بذاته له موضوعه ومنهجه و رجاله ومصدر وجوده الشرع الإسلامي، ومن أمثال هؤلاء المؤرخين، وأهل الصوفية ومؤرخيها نذكرما يلي:
أولا : السراج الطوسي : هذا المؤرخ والمتصوف في الآن نفسه راح يؤرخ لعلم التصوف من حيث أنه فرع جديد من فروع المعرفة الإسلامية له موازينه ومقاييسه وموضوعاته وخصائصه وعمل جاهدا على التوفيق بين علم الفقه وعلم التصوف واعتبرهما علما واحدا بحجة دينية وهي أن علم الفقه وعلم التصوف مصدرهما واحد يعودان إليه في التحقيق والضبط وكسب الموضوعية واليقين وهو علم الشريعة الواحد ويرى هذا المؤرخ الصوفي أن التصوف قائم على الدراية في حين أن الفقه قائم على الرواية وأنه من غير الممكن أو اللامعقول أن نحكم القول في وجود العلم إلى علمين ، أن هناك علم باطن ، وعلم ظاهر ، ولكن في الأصل أن العلم متى كان في القلب فهو باطن فيه ، إلى أن يجري على اللسان ويظهر فإذا جرى على اللسان فهو ظاهر وتنقسم أعمال الجوارح الظاهرة إلى العبادة كالطهارة والصلاة والصوم ، والزكاة والحج وغير ذلك ، ثم الأحكام كالطلاق والعتاق والبيوع ، والقصاص ، والفرائض ، لكن علم التصوف أساسه الجوارح الباطنة والتي تتجمع كلها في القلب غير أن لكل عمل من هذه الأعمال الظاهرة والباطنة علم وفقه وبيان وحقيقة وإدراك ووجد ويتأكد من صحة كل منها مصادر الشرع الإسلامي وهما عنده القرآن والأحاديث النبوية ويلتجأ السراج الطوسي لتأكيد العلمين أنهما علما واحدا ويسيران جنبا إلى جنب إلى تذكير بقول الله عز وجل " واسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة " فالنعمة الظاهرة هي فعل الطاعات أم النعمة الباطنة فهي ما أنعم الله بها على القلب من الأحوال والمقامات وهذا من دون أن يستغني الظاهر على الباطن ولا الباطن على الظاهر.
وعلم التصوف هو علم مستنبط وللصوفية مستنبطات من القرآن والحديث ويجسده قوله تعالى كما يرى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فلا فرق إذن بين علم الفقه وعلم التصوف في نظر الطوسي وإن وجد فإن الفرق بينهما في الوسيلة وليس في الغاية فعلم الفقه يختص بعلم الأعضاء الظاهرة بينما علم التصوف يختص بعلم الأعضاء الباطنية أي القلب، وعليه نرى في النهاية أنهما ينتميان إلى علم الشريعة الإسلامية .
ثانيا : عبد الوهاب الشعراني ( ولد 898هـ)
يعتبر هذا الرجل الصوفي من أهم رجال التصوف وهو مغربي الأصل وسار على نهج أسلافه، حيث تنبه الشعراني إلى كل ما ذكره الطوسي، وذلك حين جعل طريق الصوفية مشيدا بالكتاب والسنة ، وأن نظامه مبني على سلوك أسلاف الأنبياء والأولياء الصالحين والأصفياء وعلم التصوف لا يكون مذموما إلا إذا خالف صريح النص القرآني أو خالف السنة والإجماع أما إذا كان موافق له ولم يخالف الشرع في مصادره فإن غاية الكلام أنه فهم رجل مسلم فمن شاء عمل به ومن شاء تركه ونظير الفهم في ذلك هو الأفعال يقول عبد الوهاب الشعراني في التصوف : " إن علم التصوف عبارة علم انقداح في قلوب الأولياء حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة ، فكل من عمل بهما انقدح له من ذلك علوم وآداب وأسرار وحقائق تعجز الألسن عنها ، نضير ما انقدح لعلماء الشريعة من الأحكام حين عملوا بما عملوه من أحكامها فالتصوف إنما هو زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة إذا خلا من عمله العلل وحظوظ النفس كما أن علم المعاني والبيان زبدة علم النحو . فمن جعل علم التصوف علما مستقلا صدق، ومن جعله من عين أحكام الشريعة صدق، كما أن من جعل علم المعاني والبيان علما مستقلا، فقد صدق، ومن جعله من جملة علم النحو فقد صدق. " والمتبحر في علوم الشرع يدرك أهمية علم التصوف والغاية منه بالذوق الذي يكسبه إياه الدين وبالتالي يقف عند حقيقة أن التصوف من عين الشريعة، وأن الله وهب أصحابه قوة الاستنتاج والاستنباط في تقرير الأحكام ووضعها نظير الأحكام الظاهرة على حد سواء فيستنبطوا واجبات ومندوبات وآدابا ومحرمات ومكروهات ومن يتفحص ويدقق النظر ويتأمل ويعتبر ، يعلم أنه لا يخرج لشيء من علوم أهل الله تعالى عن الشريعة، وكيف تخرج علومهم عن الشريعة والشريعة هي التي وصلتهم إلى الله عز وجل في كل لحظة والذي لا إلمام له بأهل الطريق، أو النجاة أو الخلاص وأن علم التصوف من عين الشريعة فإنه لم يتبحر في علم الشريعة، لأن كل صوفي يكون فقيها ولكن ليس كل فقيه صوفي. ويؤكد الشعراني على مكانة الصوفية وأهل التصوف بين مفكري الإسلام وذلك من خلال مجموعة من الوقائع والأحداث التي تجمعت لديه وتحولت إلى أدلة تثبت مكانة الصوفية وطابع هذه الأحداث والوقائع مشاحنات دينية بين الفقهاء والصوفية ، منها إذعان الشافعي لشيبان الراعي الصوفي، حين طلب الإمام احمد بن حبل أن يسأله عمن نسي صلاة، لا يدري أي صلاة هي، وإذعان ابن حنبل حين قال مجيبا هذا رجل غفل عن الله عز وجل، فجزاؤه أن يؤدب، وكذلك يكفيهم إذعان احمد بن حبل لأبي حمزة البغدادي الصوفي واعتقاده فيه حين كان يرسل له بدقائق المسائل الفقهية والدينية على العموم ويقول : ما تقول في هذا يا صوفي ؟ وكذلك إذعان أبي العباس بن سريج الفقيه القاضي لأبي القاسم الجنيد شيخ طائفة الصوفية، وقال : " لا أدري ما يقول، ولكن لكلامه صولة ليست بصولة مبطل " وكذلك إذعان الإمام أبي عمران لأبي بكر الشبلي حين أمتحنه في مسائل الحيض وأراد أن يكشف ع، ستار ذاته العارفة مما يحمل من العلم والمعرفة فكان امتحانه له خير فأفاده بسبع مقالات لم تكن عند أبي عمران ، ويكفي الصوفية مدحا وشأنا وقيمة من هذه الوقائع والأحداث التاريخية وروي عنهم أن الشيخ قطب الدين أيمن، أن الإمام أحمد بن حنبل كان يحث ولده على الاجتماع بصوفية زمانه، ويقول أنهم بلغوا في الإخلاص مقاما لم نبلغه والشيء الجديد الذي أتى به الشعراني في علم التصوف والذي لم نجده عند أسلافه من قبل كالسراج الطوسي، هو إضافة موضوعات لها من الأهمية الأثر البليغ في ترسيخ أسس علم التصوف وتمييزه عن غيره ومنها ، موضوع أنواع اليقين ، وموضوع التوحيد عند الصوفية ، يقدم الشعراني تفرقة بين أنواع اليقين المختلفة التي تدخل كأساس في المعرفة بأنواعها فاليقين هو من يقن الماء في الحوض إذا استقر ، وهي علامة دالة لحصول السكون والاستقرار والاطمئنان بزوال الوهم والضنون والشكوك والتردد ويحدد بيان أنواع اليقين بنص شيخ محي الدين بن عربي فيقول فيه : " وهذا السكون والاستقرار والاطمئنان إذا أضيف إلى العقل والنفس يقال له علم اليقين وإذا أضيف إلى الروح الروحاني يقال له عين اليقين وإذا أضيف إلى القلب الحقيقي يقال له حق اليقين وإذا أضيف إلى السر الوجودي يقال له حقيقة حق اليقين ولا تجتمع هذه المراتب كلها إلا في الكامل محن الرجال " أما موضوع معنى التوحيد عند الصوفية فنجد الشعراني يميز بينه وبين معنى التوحيد عند المعتزلة كفرقة كلامية ، ولكنه يؤكد على مكانة المعتزلة والفلاسفة في تحصيل العلم والمعرفة وتقييدها ، إذ يرى أن كثير من كلام الصوفية لا يماشى ظاهره إلا على قواعد المعتزلة والفلاسفة – أو على منهجهم فالعاقل – أي الحكيم – إلا يبادر إلى الإنكار بمجرد غزو ذلك الكلام إليهم بل عليه أن ينظر ويتأمل في أدلتهم التي استندوا إليها فما كل ما قاله الفلاسفة والمعتزلة في كتبهم يكون باطلا، وإنما حذر البعض منهم عن مطالعة كتبهم والاشتغال بمسائلهم خوفا من حصول شبهة تقع في قلب الناظر لا سيما أهل الإنكار والدعاوى وبعد هذه الموضوعية في إقرار الحق مهما كان مصدره يقرر المقارنة بين المعتزلة والصوفية في مسألة التوحيد فيذكر لنا قول الشيخ محمد المغربي الشاذلي يقول : " إن طريف القوم – أي الصوفية – مبني على شهود الإثبات ، وعلى ما يقرب من طريق المعتزلة في بعض الحالات ، وهي حالة شهود غيبة الصفات في شهود وحدة جمال الذات حتى كان لا صفات. وهذه الحالة وإن كان غيرها أرفع منها فهي عزيزة المراد، شديدة الإبهام، موقعة في سوء الظن في السادة الكرام لشبهها بمذهب المعتزلة ، ولا شبهة في تلك الحالة، فلينتبه السالك لذلك وليحذر من الوقيعة في القوم. " فالاهتمام بالشريعة وأحكامها والعمل بها والتزام ما تقرره من قواعد هو فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة في طريق إلى الله عند الصوفية فإن أول ما اتهم به الصوفية أعدائهم هو خروجهم عن قواعد الشرع وحدوده وترك التكاليف ورفعها وهذا ما يسمى عند بعضهم باسم " الإباحية " فكان على الصوفية والمؤرخين منهم أن يؤكدوا على هذه الحقيقة وهي أن الشريعة هي المسلك الحق إلى اليقين الحق، فلا حقيقة من دون شريعة وهذا ما أكدوه لنا في نصوصهما كل من السراج الطوسي، وعبد الوهاب الشعراني، ودفاعهما المستميت عن تمسك الصوفية المخلصين بالشريعة وأحكامها .
ثالثا : أبي بكر محمد ابن إسحاق الكلاباذي ( المتوفى سنة 380هـ ) : يكر الكلاباذي في كتابه التعرف لأهل التصوف مجموعة القضايا المعرفية واللدنية التي تبين مدى تميز علم التصوف عن غيره من العلوم وذلك من خلال تعرضه لمسائل فقهية وعقائدية منها قوله في المعاملات ، والتوحيد واختلافهم في الأسماء وقولهم في القرآن والرؤية والقدر وخلق الأفعال .. والجبر ، وقولهم في الإيمان وحقائق المعرفة ... الخ ، من المسائل المذكورة في الكتاب التي تفصل علم التصوف عن غيره من العلوم وقد بين الكلاباذي أشد بيان أن هناك مجموعة مختلفة من العلوم الإسلامية وأن للصوفية علما خاصا انفردوا به دون سواهم وهو علم المكاشفات وعلم الأنوار والمشاهدات والخواطر إلى جانب اهتمامهم بع_لوم الشريعة وأحكامها منها علم أصول الفقه، والفقه، وعلم المعاملات يقول الكلاباذي : " إن علوم الصوفية علوم الأحوال والأحوال مواريث الأعمال ولا يرث الأحوال إلا من صحح الأعمال وأول تصحيح الأعمال معرفة علومها، وهي علم الأحكام الشرعية من أصول الفقه وفروعه من الصلاة والصوم وسائر الفرائض، إلى علم المعاملات من النكاح والطلاق والمبايعات وسائر ما أوجب الله تعالى وندب إليه وما لاغناء به عنه من أمور المعاش . وهذه علوم التعلم فأول ما يلزم العبد الاجتهاد في طلب هذا العلم وإحكامه على قدر ما أمكنه ووسعه طبعه وقوي عليه فهمه بعد إحكام علم التوحيد والمعرفة على طريق الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح عليه القدر الذي يتيقن بصحة ما عليه أهل السنة والجماعة فإن وفق لما فوقه من نفي الشبه التي تعترضه من خاطر أو ناظر فذاك، وإن أعرض عن خواطر السوء اعتصاما بالجملة التي عرفها وتجافى عن المناظر الذي بحاجة فيه ويجادله عليه وباعده فهو في سعة إن شاء الله عز وجل، واشتغل باستعمال علمه وعمل بما علم ." ويضيف مبينا الكلاباذي مدى أهمية هذا العلم في معالجة النفس ومداواتها من أدران المرض وذهاب كل فساد حل في الطبع يقول : " أول ما يلزمه علم آفات النفس ومعرفتها ورياضتها وتهذيب أخلاقها ومكائد العدو وفتنة الدنيا وسبيل الاحتراز منها ... فإذا استقامت النفس على الواجب وصلحت طباعها وتأدبت بآداب الله عز وجل من زم جوارحها ، وحفظ أطرافها ، وجمع حواسها سهل عليه إصلاح أخلاقها وتطهير الظاهر منها والفراغ مما لها وعزوفها عن الدنيا وإعراضها عنها. " ويؤكد أن الوصول إلى علم التصوف يتم عن طريق درجات في العلم إذ بين القواعد والمبادئ التي يجب على العبد أن يتقيد بها حتى يصل إلى علم المكاشفة والمشاهدة وعلم الخواطر الخاصة بالصوفية التي يتميزون بها عن غيرهم من طرف المسلمين فطريق الصوفي عند الكلاباذي ينقسم إلى أقسام ثلاثة :
• أولا: علم الحكمة وهو الذي يختص بدراسة وفهم آفات النفس والوقوف على معرفتها ورياضتها وتهذيب أخلاقها والإحاطة بمكائد العدو وفتنة الدنيا ومعرفة مسلك أو طريق الاحتراز منها .
• ثانيا : علم المعرفة وهو علم اهتم بدراسة النفس أيضا من الناحية الأخلاقية كالعمل على تطهير السرائر والعزوف عن غرائز الدنيا وملذاتها يقول الكلاباذي : " فإذا استقامت النفس على الواجب وصلحت طباعها وتأدبت بآداب الله عز وجل من زم جوارحها وحفظ أطرافها وجمع حواسها سهل عليه إصلاح أخلاقها وتطهير الظاهر منها والفراغ مما لها وعزوفها عن الدنيا وإعراضها عنها فعند ذلك يمكن العبد مراقبة الخواطر وتطهير السرائر "
• ثالثا : علم الإشارة و يتجسد هذا العلم من العلوم الجزئية لأهل التصوف تجتمع معا تشكل ما يعرف عندهم بعلم الإشارة يقول الكلاباذي : " ثم وراء هذه علوم الخواطر وعلوم المشاهدات والمكاشفات وهي التي تختص بعلم الإشارة، وهو الذي تفردت به الصوفية بعد جمعها سائر العلوم التي وصفناها وإنما قيل علم الإشارة، لأن مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرارلا يمكن العبارة عنها على التحقيق بل تعلم بالمنازلات والمواجيد ، ولا يعرفها إلا من نازل تلك الأحوال وحل تلك المقامات . روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله " * وعن عبد الواحد بن زيد قال سألت الحسن عن علم الباطن فقال : سألت حذيفة بن اليمان ع، علم الباطن فقال : سألت رسول الله عن علم الباطن فقال : " سألت جبريل عن علم الباطن فقال : سألت الله عز وجل عن علم الباطن فقال هو سر من سري أجعله في قلب عبدي لا يقف عليه أحد من خلقي "* قال أبو الحسن بن أبي ذر في كتابه " منهاج الدين " أنشدونا للشبلي :
علم التصوف علم لا نفاد له * علم سني سماوي ربوبي
فيه الفوائد للأرباب يعرفها * أهل الجزالة والصنع الخصوصي
وهناك متصوفة كثيرون لا يسع المقال لذكرهم جميعا.
ثانيا : عبد الوهاب الشعراني ( ولد 898هـ)
يعتبر هذا الرجل الصوفي من أهم رجال التصوف وهو مغربي الأصل وسار على نهج أسلافه، حيث تنبه الشعراني إلى كل ما ذكره الطوسي، وذلك حين جعل طريق الصوفية مشيدا بالكتاب والسنة ، وأن نظامه مبني على سلوك أسلاف الأنبياء والأولياء الصالحين والأصفياء وعلم التصوف لا يكون مذموما إلا إذا خالف صريح النص القرآني أو خالف السنة والإجماع أما إذا كان موافق له ولم يخالف الشرع في مصادره فإن غاية الكلام أنه فهم رجل مسلم فمن شاء عمل به ومن شاء تركه ونظير الفهم في ذلك هو الأفعال يقول عبد الوهاب الشعراني في التصوف : " إن علم التصوف عبارة علم انقداح في قلوب الأولياء حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة ، فكل من عمل بهما انقدح له من ذلك علوم وآداب وأسرار وحقائق تعجز الألسن عنها ، نضير ما انقدح لعلماء الشريعة من الأحكام حين عملوا بما عملوه من أحكامها فالتصوف إنما هو زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة إذا خلا من عمله العلل وحظوظ النفس كما أن علم المعاني والبيان زبدة علم النحو . فمن جعل علم التصوف علما مستقلا صدق، ومن جعله من عين أحكام الشريعة صدق، كما أن من جعل علم المعاني والبيان علما مستقلا، فقد صدق، ومن جعله من جملة علم النحو فقد صدق. " والمتبحر في علوم الشرع يدرك أهمية علم التصوف والغاية منه بالذوق الذي يكسبه إياه الدين وبالتالي يقف عند حقيقة أن التصوف من عين الشريعة، وأن الله وهب أصحابه قوة الاستنتاج والاستنباط في تقرير الأحكام ووضعها نظير الأحكام الظاهرة على حد سواء فيستنبطوا واجبات ومندوبات وآدابا ومحرمات ومكروهات ومن يتفحص ويدقق النظر ويتأمل ويعتبر ، يعلم أنه لا يخرج لشيء من علوم أهل الله تعالى عن الشريعة، وكيف تخرج علومهم عن الشريعة والشريعة هي التي وصلتهم إلى الله عز وجل في كل لحظة والذي لا إلمام له بأهل الطريق، أو النجاة أو الخلاص وأن علم التصوف من عين الشريعة فإنه لم يتبحر في علم الشريعة، لأن كل صوفي يكون فقيها ولكن ليس كل فقيه صوفي. ويؤكد الشعراني على مكانة الصوفية وأهل التصوف بين مفكري الإسلام وذلك من خلال مجموعة من الوقائع والأحداث التي تجمعت لديه وتحولت إلى أدلة تثبت مكانة الصوفية وطابع هذه الأحداث والوقائع مشاحنات دينية بين الفقهاء والصوفية ، منها إذعان الشافعي لشيبان الراعي الصوفي، حين طلب الإمام احمد بن حبل أن يسأله عمن نسي صلاة، لا يدري أي صلاة هي، وإذعان ابن حنبل حين قال مجيبا هذا رجل غفل عن الله عز وجل، فجزاؤه أن يؤدب، وكذلك يكفيهم إذعان احمد بن حبل لأبي حمزة البغدادي الصوفي واعتقاده فيه حين كان يرسل له بدقائق المسائل الفقهية والدينية على العموم ويقول : ما تقول في هذا يا صوفي ؟ وكذلك إذعان أبي العباس بن سريج الفقيه القاضي لأبي القاسم الجنيد شيخ طائفة الصوفية، وقال : " لا أدري ما يقول، ولكن لكلامه صولة ليست بصولة مبطل " وكذلك إذعان الإمام أبي عمران لأبي بكر الشبلي حين أمتحنه في مسائل الحيض وأراد أن يكشف ع، ستار ذاته العارفة مما يحمل من العلم والمعرفة فكان امتحانه له خير فأفاده بسبع مقالات لم تكن عند أبي عمران ، ويكفي الصوفية مدحا وشأنا وقيمة من هذه الوقائع والأحداث التاريخية وروي عنهم أن الشيخ قطب الدين أيمن، أن الإمام أحمد بن حنبل كان يحث ولده على الاجتماع بصوفية زمانه، ويقول أنهم بلغوا في الإخلاص مقاما لم نبلغه والشيء الجديد الذي أتى به الشعراني في علم التصوف والذي لم نجده عند أسلافه من قبل كالسراج الطوسي، هو إضافة موضوعات لها من الأهمية الأثر البليغ في ترسيخ أسس علم التصوف وتمييزه عن غيره ومنها ، موضوع أنواع اليقين ، وموضوع التوحيد عند الصوفية ، يقدم الشعراني تفرقة بين أنواع اليقين المختلفة التي تدخل كأساس في المعرفة بأنواعها فاليقين هو من يقن الماء في الحوض إذا استقر ، وهي علامة دالة لحصول السكون والاستقرار والاطمئنان بزوال الوهم والضنون والشكوك والتردد ويحدد بيان أنواع اليقين بنص شيخ محي الدين بن عربي فيقول فيه : " وهذا السكون والاستقرار والاطمئنان إذا أضيف إلى العقل والنفس يقال له علم اليقين وإذا أضيف إلى الروح الروحاني يقال له عين اليقين وإذا أضيف إلى القلب الحقيقي يقال له حق اليقين وإذا أضيف إلى السر الوجودي يقال له حقيقة حق اليقين ولا تجتمع هذه المراتب كلها إلا في الكامل محن الرجال " أما موضوع معنى التوحيد عند الصوفية فنجد الشعراني يميز بينه وبين معنى التوحيد عند المعتزلة كفرقة كلامية ، ولكنه يؤكد على مكانة المعتزلة والفلاسفة في تحصيل العلم والمعرفة وتقييدها ، إذ يرى أن كثير من كلام الصوفية لا يماشى ظاهره إلا على قواعد المعتزلة والفلاسفة – أو على منهجهم فالعاقل – أي الحكيم – إلا يبادر إلى الإنكار بمجرد غزو ذلك الكلام إليهم بل عليه أن ينظر ويتأمل في أدلتهم التي استندوا إليها فما كل ما قاله الفلاسفة والمعتزلة في كتبهم يكون باطلا، وإنما حذر البعض منهم عن مطالعة كتبهم والاشتغال بمسائلهم خوفا من حصول شبهة تقع في قلب الناظر لا سيما أهل الإنكار والدعاوى وبعد هذه الموضوعية في إقرار الحق مهما كان مصدره يقرر المقارنة بين المعتزلة والصوفية في مسألة التوحيد فيذكر لنا قول الشيخ محمد المغربي الشاذلي يقول : " إن طريف القوم – أي الصوفية – مبني على شهود الإثبات ، وعلى ما يقرب من طريق المعتزلة في بعض الحالات ، وهي حالة شهود غيبة الصفات في شهود وحدة جمال الذات حتى كان لا صفات. وهذه الحالة وإن كان غيرها أرفع منها فهي عزيزة المراد، شديدة الإبهام، موقعة في سوء الظن في السادة الكرام لشبهها بمذهب المعتزلة ، ولا شبهة في تلك الحالة، فلينتبه السالك لذلك وليحذر من الوقيعة في القوم. " فالاهتمام بالشريعة وأحكامها والعمل بها والتزام ما تقرره من قواعد هو فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة في طريق إلى الله عند الصوفية فإن أول ما اتهم به الصوفية أعدائهم هو خروجهم عن قواعد الشرع وحدوده وترك التكاليف ورفعها وهذا ما يسمى عند بعضهم باسم " الإباحية " فكان على الصوفية والمؤرخين منهم أن يؤكدوا على هذه الحقيقة وهي أن الشريعة هي المسلك الحق إلى اليقين الحق، فلا حقيقة من دون شريعة وهذا ما أكدوه لنا في نصوصهما كل من السراج الطوسي، وعبد الوهاب الشعراني، ودفاعهما المستميت عن تمسك الصوفية المخلصين بالشريعة وأحكامها .
ثالثا : أبي بكر محمد ابن إسحاق الكلاباذي ( المتوفى سنة 380هـ ) : يكر الكلاباذي في كتابه التعرف لأهل التصوف مجموعة القضايا المعرفية واللدنية التي تبين مدى تميز علم التصوف عن غيره من العلوم وذلك من خلال تعرضه لمسائل فقهية وعقائدية منها قوله في المعاملات ، والتوحيد واختلافهم في الأسماء وقولهم في القرآن والرؤية والقدر وخلق الأفعال .. والجبر ، وقولهم في الإيمان وحقائق المعرفة ... الخ ، من المسائل المذكورة في الكتاب التي تفصل علم التصوف عن غيره من العلوم وقد بين الكلاباذي أشد بيان أن هناك مجموعة مختلفة من العلوم الإسلامية وأن للصوفية علما خاصا انفردوا به دون سواهم وهو علم المكاشفات وعلم الأنوار والمشاهدات والخواطر إلى جانب اهتمامهم بع_لوم الشريعة وأحكامها منها علم أصول الفقه، والفقه، وعلم المعاملات يقول الكلاباذي : " إن علوم الصوفية علوم الأحوال والأحوال مواريث الأعمال ولا يرث الأحوال إلا من صحح الأعمال وأول تصحيح الأعمال معرفة علومها، وهي علم الأحكام الشرعية من أصول الفقه وفروعه من الصلاة والصوم وسائر الفرائض، إلى علم المعاملات من النكاح والطلاق والمبايعات وسائر ما أوجب الله تعالى وندب إليه وما لاغناء به عنه من أمور المعاش . وهذه علوم التعلم فأول ما يلزم العبد الاجتهاد في طلب هذا العلم وإحكامه على قدر ما أمكنه ووسعه طبعه وقوي عليه فهمه بعد إحكام علم التوحيد والمعرفة على طريق الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح عليه القدر الذي يتيقن بصحة ما عليه أهل السنة والجماعة فإن وفق لما فوقه من نفي الشبه التي تعترضه من خاطر أو ناظر فذاك، وإن أعرض عن خواطر السوء اعتصاما بالجملة التي عرفها وتجافى عن المناظر الذي بحاجة فيه ويجادله عليه وباعده فهو في سعة إن شاء الله عز وجل، واشتغل باستعمال علمه وعمل بما علم ." ويضيف مبينا الكلاباذي مدى أهمية هذا العلم في معالجة النفس ومداواتها من أدران المرض وذهاب كل فساد حل في الطبع يقول : " أول ما يلزمه علم آفات النفس ومعرفتها ورياضتها وتهذيب أخلاقها ومكائد العدو وفتنة الدنيا وسبيل الاحتراز منها ... فإذا استقامت النفس على الواجب وصلحت طباعها وتأدبت بآداب الله عز وجل من زم جوارحها ، وحفظ أطرافها ، وجمع حواسها سهل عليه إصلاح أخلاقها وتطهير الظاهر منها والفراغ مما لها وعزوفها عن الدنيا وإعراضها عنها. " ويؤكد أن الوصول إلى علم التصوف يتم عن طريق درجات في العلم إذ بين القواعد والمبادئ التي يجب على العبد أن يتقيد بها حتى يصل إلى علم المكاشفة والمشاهدة وعلم الخواطر الخاصة بالصوفية التي يتميزون بها عن غيرهم من طرف المسلمين فطريق الصوفي عند الكلاباذي ينقسم إلى أقسام ثلاثة :
• أولا: علم الحكمة وهو الذي يختص بدراسة وفهم آفات النفس والوقوف على معرفتها ورياضتها وتهذيب أخلاقها والإحاطة بمكائد العدو وفتنة الدنيا ومعرفة مسلك أو طريق الاحتراز منها .
• ثانيا : علم المعرفة وهو علم اهتم بدراسة النفس أيضا من الناحية الأخلاقية كالعمل على تطهير السرائر والعزوف عن غرائز الدنيا وملذاتها يقول الكلاباذي : " فإذا استقامت النفس على الواجب وصلحت طباعها وتأدبت بآداب الله عز وجل من زم جوارحها وحفظ أطرافها وجمع حواسها سهل عليه إصلاح أخلاقها وتطهير الظاهر منها والفراغ مما لها وعزوفها عن الدنيا وإعراضها عنها فعند ذلك يمكن العبد مراقبة الخواطر وتطهير السرائر "
• ثالثا : علم الإشارة و يتجسد هذا العلم من العلوم الجزئية لأهل التصوف تجتمع معا تشكل ما يعرف عندهم بعلم الإشارة يقول الكلاباذي : " ثم وراء هذه علوم الخواطر وعلوم المشاهدات والمكاشفات وهي التي تختص بعلم الإشارة، وهو الذي تفردت به الصوفية بعد جمعها سائر العلوم التي وصفناها وإنما قيل علم الإشارة، لأن مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرارلا يمكن العبارة عنها على التحقيق بل تعلم بالمنازلات والمواجيد ، ولا يعرفها إلا من نازل تلك الأحوال وحل تلك المقامات . روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله " * وعن عبد الواحد بن زيد قال سألت الحسن عن علم الباطن فقال : سألت حذيفة بن اليمان ع، علم الباطن فقال : سألت رسول الله عن علم الباطن فقال : " سألت جبريل عن علم الباطن فقال : سألت الله عز وجل عن علم الباطن فقال هو سر من سري أجعله في قلب عبدي لا يقف عليه أحد من خلقي "* قال أبو الحسن بن أبي ذر في كتابه " منهاج الدين " أنشدونا للشبلي :
علم التصوف علم لا نفاد له * علم سني سماوي ربوبي
فيه الفوائد للأرباب يعرفها * أهل الجزالة والصنع الخصوصي
وهناك متصوفة كثيرون لا يسع المقال لذكرهم جميعا.
تمهيد :
لقد ظهرت مجموعة من المعارف والعلوم وكانت بأسباب مختلفة، وأدت بالتمييز بين الحضارات، والحضارة العربية الإسلامية، فالمسلمين حين اختلطوا بالأمم والشعوب المجاورة لهم والبعيدة عنهم عن طريق مسالك دينية وتجارية وثقافية أدى هذا الاختلاط إلى امتزاج ثقافتهم بثقافة هؤلاء كما أدى إلى إحداث ضرر من حين لآخر، في تأصيل مظاهر ثقافتهم فعملوا جاهدين على علاج الضرر والقضاء على بواطن الفساد وإحلال الصحة والصواب ، فحدث زيغ ولكلكة في اللسان العربي لسبب تكلم الأعاجم والبربر لهذا اللسان فراح المسلمون يعملون على إصلاحه بوضع علوم اللسان العربي من نحو وصرف وإملاء، وشكل وبلاغة وهذا أيضا خوفا من تشويه الشريعة الإسلامية في كلياتها أو فروعها، كقراءة النصوص النقلية، قراءة خاطئة من طرف الأعاجم أو اللذين يلحنون في اللغة، فإلجام هؤلاء بإلتزام قواعد اللغة العربية كان لقيمة دينية، وكان لقيمة ثقافية أيضا ، كذلك النقاش الذي حدث لدى الأعاجم والعرب في مسائل الدين ذات الطابع الميتافيزيقي وأيضا تشويه هذه المسائل الدينية في الممارسة أو التصديق والإيمان بها، بإسقاط عاداتهم وتقاليدهم عليها ، كان سببا في وضع علم جديد عند المسلمين وهو علم جدلي، عرف بعلم الكلام الذي يدافع عن العقيدة بالحجة العقلية للتغلب على الخصم أو إقناعه، أو بعبارة أخرى أن علم الكلام "هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب أهل السلف وأهل السنة" فالجماعة التي تشتغل بهذا العلم (علم الكلام سموا بالمتكلمين) ومنهجهم استعمال العقل لفهم النص والدفاع عن العقيدة ، إذن : فهؤلاء المتكلمون يختلفون عن الفقهاء والفلاسفة والمتصوفة ، يقول الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد أن علم الكلام : ( هو علم يبحث فيه عن وجود الله، وما يجب أن يثبت له من صفات وما يجوز أن يوصف به وما يجب أن ينفي عنه، وعن الرسل لإثبات رسالتهم ، وما يجب أن يكونوا عليه، وما يجوز أن ينسب إليهم وما يمتنع أن يلحق بهم) إن هذا العلم الذي أنجبته الحضارة العربية الإسلامية كمحام للعقيدة الإسلامية أدى إلى ظهور مذاهب فكرية تسمى اليوم بالفرق الكلامية . التي تعبر عن مدى قوة العقل العربي الإسلامي في التدليل على قضايا الدين بوجهات نظر مختلفة تصب نحو غاية واحدة، نقتصر على ذكر البعض منها وهي نوعان، الفرق السياسية، والفرق الكلامية.
أولا : الفرق السياسية .
أ – الخوارج ، حين تولى معاوية الخلافة عن طريق استعمال القوة والعصبية مال جماعة إلى علي رضي الله عنه إلى محاربته والمطالبة بالحكم لعلي ، ولما حدثت واقعة الصفين بين علي ومعاوية واشتد وطيسها وكان الغلبة لأصحاب علي، حينها طلب معاوية كحيلة سياسية تحكيم كتاب الله فرفعت المصاحف على السيوف، وتعالت الأصوات الحاكمية لله ، فحدث اختلاف لدى أصحاب علي هل يقبلوا التحكيم ، لأنهم يحاربون لإعلاء كلمة الله ؟ أم لا يقبلونه، إنما هو خدعة حربية لجأ إليها معاوية وأصحابه حين أحسوا بالهزيمة ؟ فظهر جماعة من الجند وهم أكثرهم من قبيلة تميم يرفضون هذا التحكيم فخرجوا على علي، فسموا بالخوارج وقالوا :" لا حكم إلا الله "، وكانوا يسمون أنفسهم بالشراة، أي الذين باعوا أنفسهم إلى الله وكذلك سموا بالحرورية أي يعود هذا الاسم إلى المكان الذي اجتمعوا فيه بعد خروجهم على علي وهو مكان اسمه " حروراء " .
إن الخوارج في بداية الأمر ظهروا كفرقة سياسية ، ولكن تطور أمرهم أثناء الدولة الأموية حيث مزجوا آراؤهم السياسية بأفكار دينية ولاهوتية ، غير أنهم مشتتين متنازعين ، يغلب فيهم جانب العمل والثورة على جانب التفكير والفطرة. وظلت الخوارج شوكة في جنب الدولة الأموية يهددونها ويحاربونها حربا في صورة متواصلة بشدة وشجاعة نادرة يطالبون بإلغاء هذا الحكم ، وإحلال حكم الله ، وقد أنقسم الخوارج إلى فرعين فرع بالعراق وما حولها وكان أهم مركز لها هو البطائح بالقرب من البصرة ، ومن رجال هذا الفرع ، نافع بن الأزرق وقطرى بن الفجاءة، وفرع آخر بجزيرة العرب استولوا على اليمامة، وحضرموت، واليمن والطائف، وأشهر أمرائهم أبو طالوت ونجدة بن عامر، وأبو فديك. ووصلت من الخوارج فرقتان من المغرب " الصفرية والأباضية " لم يتغلب الأمويين على الخوارج إلا بعد حروب طويلة، ولكن في عهد الدولة العباسية خف خطرهم وضعف شأنهم وللخوارج منطلقين اثنين عنهما تصدر جميع التعاليم هما :
أولا، أمور تتعلق بالخلافة : إن الخوارج يقولون بصحة خلافة كل من أبي بكر وعمر بن الخطاب لصحة انتخابهما كما قالوا بصحة خلافة عثمان في سنية الأولى، لكن لما غير وبدل، ولم يسر سيرة أبي بكر وعمر، وأتى بما أتى من أحداث تخالف المبادئ الأساسية كما ضنوا وجب عزله وقتله ، واقروا بصحة خلافة علي، لكن حين أخطأ في التحكيم حكموا بكفره، وطعنوا في أصحاب الجمل، طلحة والزبير وعائشة، كما حكموا بكفر أبي موسى الأشعري، وعمر بن العاص وأنه في نظرهم ليس من الضروري أن تحصر الخلافة في قريش، وهم في هذا يخالفون أهل السنة وجمهور المسلمين الذين اشترطوا النسب القرشي في الخليفة كما أنهم خالفوا الشيعة الذين يرون أن الخلافة تكون في نسل علي، وذهبوا إلى أن الخلافة تكون باختيار حر من المسلمين والمقياس لاختيار الخليفة هو صلاحه بغض النظر أنه قريشي أو غير قريشي عربي أو غير عربي، كما لا يجوز للخليفة حين يتم اختياره، أن يتنازل عن الحكم، وبالتالي عليه أن يخضع لهذا الاختيار إضافة إلى ذلك أنهم يرون بأن الخليفة يجب أن يتقيد تقيدا صارما بما أمر الله وينتهي عن كل ما نهى عنه الله بالنص، وإذا خرج الخليفة عن جادة الصواب، وعن العدل والحق، يجب عزله وإذا ثبت عن مظالم في صورة كبيرة الكبائر وجب قتله.
كما أن هناك رأي يمثله بعض الخوارج ينص على عدم تنصيب الخليفة فيكفي أن يعمل كل مسلم من تلقاء نفسه بكتاب الله ويطبق أوامر الدين ويتجنب نواهيه.
أمور تتعلق بالإيمان :
ينظر الأغلبية من الخوارج وحادث بينهم الاتفاق على أن كل كبيرة كفر، وأن الله عز وجل يعذب أصحاب الكبائر عذابا أليما، والعمل عندهم جزء من الإيمان فمن اعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم لم يعمل بفروض الدين وأرتكب الكبائر فهو كافر في نظرهم بمعنى أن العمل بقواعد الدين من صلاة وصيام وزكاة، وأوامر من صدق وعدل وصفاء جزء من الإيمان وليس الإيمان الاعتقاد وحده، وأن من أنكر ذلك أو تهاون في التزامه فهو مرتكب الكبيرة، وكافر يجوز قتله بل يجب قتله
الشيعة: إن ظهور الشيعة كان كاتجاه عفوي ، وهم جماعة كانت تعطف على علي بسبب قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأيه السديد ، وتطور هذا الاتجاه إلى حركة سياسية فيما بعد، بعد مقتل عثمان بن عفان، بعد حادثة التحكيم، وأصبحت هذه الحركة السياسية والدينية لها منطلقاتها وأسسها وآراؤها الخاصة بها في شئون الدنيا والدين ، وأهم المبادئ التي يقوم عليها الفكر الشيعي هي :
أ ، الوصية : إن المبدأ ينص على أن الخلافة أو الإمامة تكون بطريق الاختيار يقول ابن خلدون : " إن الإمامة ليس من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ، ويتعين القائم بتعيينهم، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ، ولا يجوز لنبي إغفالها ولا تفويضها إلى الأمة بل يجب عليه تعيين الإمام ويكون معصوما من الكبائر والضمائر، وأن عليا رضي الله عنه هو الذي عينه صلوات الله عليه وسلامه عليه، بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة، ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة "، ويفهم من هذا النص أن الشيعة قالوا بخلافة علي بدليل وصية النبي بعده، وأن الذين بايعوا أبا بكر ، فإن هؤلاء فعلوا تجاهلا أو جهلا بالوصية أو أنهم اغتصبوا حقا معتمدا ، و هناك من الشيعة الذين يقولون بالرجعة أي برجوع الإمام بعد أن يكون قد اختفى، أو مات ، لأن الوقت لا يخلو من إمام إما إمام ظاهر أو إمام مستتر .
ب - التقية : تذهب الشيعة بالقول أن البعض قد اغتصبوا الحكم في أثناء غيبة الإمام، وفرضوا أنفسهم على الأمة فرضا ، فماذا يكون موقف المؤمن الشيعي من هؤلاء المغتصبين حتى يرجع الإمام الحق ؟ يقول أن يفعل مثل باقي المسلمين يخضع لهذا الرئيس أو الحاكم المغتصب ، ويقوم بواجباته كلها نحوه ولكن يفعل هذا مكرها بالرغم منه ولا ينسى بأن هذا الخضوع هو في الأصل خضوع مفروض عليه وهو في ظنه خضوع مؤقت، فعليه أن يأمل دائما في رجعة الإمام العادل الحق، وصاحب الحق في الوقت نفسه ، ويظهر حتما عندما تتقوى شوكته أو عصبيته فيسترد حقه المسلوب بالقوة والاغتصاب فيثأر لنفسه من أعدائه، ويسترد حقه، بمعنى أنه يجوز للشيعي أن يخفي عقيدته الشيعية، وهذا إذا كان يخاف على نفسه بطش الحكام ، وبالتالي يخضع لحكمهم فيتبعهم ويظهر لهم ما لا يبطن في دعوته. والإعداد للثورة التي تضمن الاستمرار وعن المحن التي تعرضوا لها خلال تاريخهم السياسي الطويل .
ج - العصمة : ترى الشيعة أن الإمام أسمى رجل وهو ليس كباقي البشر في اعتقادهم أن الله أختاره ليكون حارسا على هذه الوديعة المقدسة التي أودعها إياه لهذا أن الإمام كان معصوما، فهو المحافظ على الشريعة وإلا كيف نفسر أن الشريعة بين أيدي أمينة فما الضامن لها، وبهذا فإن الإمامة هي حق إلهي، والإمام معصوم فما يقوله ويفعله صواب كما أن الإمام يرث سر النبوة عن آبائه وأجداده وأنه يعلم الظاهر والباطن، وهو الذي لديه القدرات والكفاءة وحده على فهم الدين وتأويل ما يحتاج إلى تأويل يقول غلاة الشيعة عن " علي " : أنه يعلم باطن القرآن وظاهره ، وأن الله أطلعه عن أسرار الكون وغيبيا ته، وأن كل إمام يورث هذا السر لمن بعده .وكل إمام يعلم الناس في وقته ما يستطيعون فهمه من الأسرار لذلك أن الإمام أكبر معلم .
المرجئة : أن المرجئة هي جماعة تكونت في المغازي، والحروب ومنهجهم الشك يقول أحمد آمين عنهم فيما نقل عن ابن عساكر : " إنهم هم الشكاك الذين شكوا وكانوا في المغازي، فما قدموا المدينة بعد مقتل " عثمان " وكان عهدهم بالناس، وأمرهم واحد ليس بينهم اختلاف قالوا : تركناكم وأمركم واحد ليس بينكم اختلاف، وقدمنا عليكم وانتم مختلفون فبعضكم يقول قتل عثمان مظلوما، وكان أولى بالعدل أصحابه، وبعضكم يقول : كان علي أولى بالحق وأصحابه ، كلهم ثقة وعند مصدق، فنحن لا نتبرأ منهما ولا نلعنهما ولا نشهد عليهما ونرجئ أمرهما إلى الله حتى يكون الله هو الذي يحكم بينهما " إن هذه الفرقة السياسية الدينية تريد أن لاتغمس يدها في الفتن ، ولا يريق دماء حزب، ولا يحكم بتخطئة وتصويب آخر فهدفت هذه الفرقة إلى التزام الحياد ، وفي رأيها أيضا أن الخلاف فيه التباس وغموض وجميع المنتمين إليها يظهرون الإيمان ويعملون في دائرة الإسلام، وإنما أرجئوا أمرهم إلى الله قال أحمد آمين : " كلمة المرجئة مأخوذة من أرجأ ، بمعنى أمهل وأخر، سموا المرجئة لأنهم يرجئون أمر هؤلاء المختلفين الذين سفكوا الدماء إلى يوم القيامة، فلا يقضون بحكم على هؤلاء، ولا على هؤلاء ، وبعضهم يشتق اسمهم من أرجأ بمعنى بعث الرجاء، لأنهم كما يقولون : لا تضر مع الإيمان معصية ، كما لا تنفع مع الكفر طاعة ، فهم يؤملون كل مؤمن عاص ، والأول أنسب لما حكينا على ابن عساكر " والموقف الديني لهذه الفرقة السياسية الدينية يتجسد في تعريف المرجئة أ] تأخير العمل يقول الشهرستاني "ملخصا لنا هذا الموقف كتابه الملل والنحل:" الإرجاء على معنيين أحدهما يعني التأخير قوله تعالى: ( قالوا أرجأه وأخاه ) * والثاني إعطاء الرجاء أما إطلاق أسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح لأنهم كانوا يؤخرون العمل على النية والعقد ، وإما بالمعنى الثاني فظاهر فأغلبهم كانوا يقولون : لا تضر مع الإيمان معصية ، كما لا تنفع مع الكفر طاعة ، وقيل : الإرجاء تأخير صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة ، فلا يقضي عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة ، أو من أهل النار ، فعلى هذا المرجئة ، والوعيدية فرقتان متقابلتان ، وقيل الإرجاء تأخير " علي " رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة فعلى هذا المرجئة ، والشيعة فرقتان متقابلتان .." والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الفكر الإرجائي هي :
أ – حقيقة الإيمان : الإيمان هو المعرفة بالله ورسله ، فمن عرف أن لا إله إلا الله محمد رسولا الله فهو مؤمن ، وهذا رد على الخوارج الذين يقولون إن الإيمان معرفة بالله ، وبرسله والإتيان بالفرائض ، والكف عن الكبائر وهذا كذلك رد أيضا على الشيعة، الذين يعتقدون أن الإيمان بالإمام والطاعة له جزء من الإيمان، ويذهب البعض من غلاة المرجئة أن المعرفة هي الإقرار باللسان والخضوع بالقلب، والمحبة لله ورسوله والتعظيم لهما والخوف منهما، والعمل بالجوارح فليس من الإيمان مسألة، بمعنى أنهم يؤخرون العمل عن النية والعقد، فالإيمان مسألة إعتقادية قلبية لا تطبيقية، وقالوا : بالرجاء أي يبعثون الأمل في النفوس، ولا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة.
حكم مرتكب الكبيرة: إن السؤال الديني في هذه المسألة تمثل فيما يلي، هل مرتكب الكبيرة كافرا أو مؤمنا هل يخلد في النار؟أم سيكون له مصير آخر ؟ تجيب فرقة المرجئة على هذه الأسئلة، وترى أن الحكم على مرتكب الكبيرة يدخل النار أو الجنة، وهذا أمر يتعلق بإرادة الله وحده، وليس من اختصاص الناس والحكم عليه في هذا الشأن، وبهذا فإنهم يخالفون الوعيدية من الخوارج كما أنهم يخالفون رأي المعتزلة في الذين يموتون وهم على كبائرهم فهم في النار خالدون، فالمرجئة تذهب إلى عدم إمكانية الحكم على أحد من المسلمين بالكفر منها أذنب، وإن الذنب مهما عظم لا يذهب بالإيمان، وإنما لا يسفك دم أحد من المسلمين إلا دفاعا عن نفسه، وإذا اشتبهت الأمور وكفرت كل طائفة أختها فيما فعلت أرجأنا أمرهم جميعا إلى الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أما الجور البين والعناد الواضح والأعمال الظاهرة نصدر أحكامنا عليها بصراحة ونبين الخطأ من الصواب.
مكانة ومرتبة علي كخليف: ترى بأن علي كرم الله وجهه يأتي في الدرجة الرابعة من حيث الترتيب التاريخي للخلفاء الأربعة، وهذا يخالف رأي الخوارج الذين أثبتوا إمامة عثمان في السنوات الأخيرة من حكمه، وكذلك أن إمامة علي تعتبر شرعية قبل التحكيم، ويخالفون رأي الشيعة الذين اعتبروا أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان إمامة غير شرعية فهي باطلة مع الملاحظة أن هذه الفرقة لم تستمر ويقال في التاريخ الإسلامي أن أغلب أنصارها انظموا إلى فرقة أهل السنة الأشاعرة، فرجالها الذين يمثلونها هم من أصحاب أهل السنة حماد ابن أبي سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف، والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب
لقد ظهرت مجموعة من المعارف والعلوم وكانت بأسباب مختلفة، وأدت بالتمييز بين الحضارات، والحضارة العربية الإسلامية، فالمسلمين حين اختلطوا بالأمم والشعوب المجاورة لهم والبعيدة عنهم عن طريق مسالك دينية وتجارية وثقافية أدى هذا الاختلاط إلى امتزاج ثقافتهم بثقافة هؤلاء كما أدى إلى إحداث ضرر من حين لآخر، في تأصيل مظاهر ثقافتهم فعملوا جاهدين على علاج الضرر والقضاء على بواطن الفساد وإحلال الصحة والصواب ، فحدث زيغ ولكلكة في اللسان العربي لسبب تكلم الأعاجم والبربر لهذا اللسان فراح المسلمون يعملون على إصلاحه بوضع علوم اللسان العربي من نحو وصرف وإملاء، وشكل وبلاغة وهذا أيضا خوفا من تشويه الشريعة الإسلامية في كلياتها أو فروعها، كقراءة النصوص النقلية، قراءة خاطئة من طرف الأعاجم أو اللذين يلحنون في اللغة، فإلجام هؤلاء بإلتزام قواعد اللغة العربية كان لقيمة دينية، وكان لقيمة ثقافية أيضا ، كذلك النقاش الذي حدث لدى الأعاجم والعرب في مسائل الدين ذات الطابع الميتافيزيقي وأيضا تشويه هذه المسائل الدينية في الممارسة أو التصديق والإيمان بها، بإسقاط عاداتهم وتقاليدهم عليها ، كان سببا في وضع علم جديد عند المسلمين وهو علم جدلي، عرف بعلم الكلام الذي يدافع عن العقيدة بالحجة العقلية للتغلب على الخصم أو إقناعه، أو بعبارة أخرى أن علم الكلام "هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب أهل السلف وأهل السنة" فالجماعة التي تشتغل بهذا العلم (علم الكلام سموا بالمتكلمين) ومنهجهم استعمال العقل لفهم النص والدفاع عن العقيدة ، إذن : فهؤلاء المتكلمون يختلفون عن الفقهاء والفلاسفة والمتصوفة ، يقول الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد أن علم الكلام : ( هو علم يبحث فيه عن وجود الله، وما يجب أن يثبت له من صفات وما يجوز أن يوصف به وما يجب أن ينفي عنه، وعن الرسل لإثبات رسالتهم ، وما يجب أن يكونوا عليه، وما يجوز أن ينسب إليهم وما يمتنع أن يلحق بهم) إن هذا العلم الذي أنجبته الحضارة العربية الإسلامية كمحام للعقيدة الإسلامية أدى إلى ظهور مذاهب فكرية تسمى اليوم بالفرق الكلامية . التي تعبر عن مدى قوة العقل العربي الإسلامي في التدليل على قضايا الدين بوجهات نظر مختلفة تصب نحو غاية واحدة، نقتصر على ذكر البعض منها وهي نوعان، الفرق السياسية، والفرق الكلامية.
أولا : الفرق السياسية .
أ – الخوارج ، حين تولى معاوية الخلافة عن طريق استعمال القوة والعصبية مال جماعة إلى علي رضي الله عنه إلى محاربته والمطالبة بالحكم لعلي ، ولما حدثت واقعة الصفين بين علي ومعاوية واشتد وطيسها وكان الغلبة لأصحاب علي، حينها طلب معاوية كحيلة سياسية تحكيم كتاب الله فرفعت المصاحف على السيوف، وتعالت الأصوات الحاكمية لله ، فحدث اختلاف لدى أصحاب علي هل يقبلوا التحكيم ، لأنهم يحاربون لإعلاء كلمة الله ؟ أم لا يقبلونه، إنما هو خدعة حربية لجأ إليها معاوية وأصحابه حين أحسوا بالهزيمة ؟ فظهر جماعة من الجند وهم أكثرهم من قبيلة تميم يرفضون هذا التحكيم فخرجوا على علي، فسموا بالخوارج وقالوا :" لا حكم إلا الله "، وكانوا يسمون أنفسهم بالشراة، أي الذين باعوا أنفسهم إلى الله وكذلك سموا بالحرورية أي يعود هذا الاسم إلى المكان الذي اجتمعوا فيه بعد خروجهم على علي وهو مكان اسمه " حروراء " .
إن الخوارج في بداية الأمر ظهروا كفرقة سياسية ، ولكن تطور أمرهم أثناء الدولة الأموية حيث مزجوا آراؤهم السياسية بأفكار دينية ولاهوتية ، غير أنهم مشتتين متنازعين ، يغلب فيهم جانب العمل والثورة على جانب التفكير والفطرة. وظلت الخوارج شوكة في جنب الدولة الأموية يهددونها ويحاربونها حربا في صورة متواصلة بشدة وشجاعة نادرة يطالبون بإلغاء هذا الحكم ، وإحلال حكم الله ، وقد أنقسم الخوارج إلى فرعين فرع بالعراق وما حولها وكان أهم مركز لها هو البطائح بالقرب من البصرة ، ومن رجال هذا الفرع ، نافع بن الأزرق وقطرى بن الفجاءة، وفرع آخر بجزيرة العرب استولوا على اليمامة، وحضرموت، واليمن والطائف، وأشهر أمرائهم أبو طالوت ونجدة بن عامر، وأبو فديك. ووصلت من الخوارج فرقتان من المغرب " الصفرية والأباضية " لم يتغلب الأمويين على الخوارج إلا بعد حروب طويلة، ولكن في عهد الدولة العباسية خف خطرهم وضعف شأنهم وللخوارج منطلقين اثنين عنهما تصدر جميع التعاليم هما :
أولا، أمور تتعلق بالخلافة : إن الخوارج يقولون بصحة خلافة كل من أبي بكر وعمر بن الخطاب لصحة انتخابهما كما قالوا بصحة خلافة عثمان في سنية الأولى، لكن لما غير وبدل، ولم يسر سيرة أبي بكر وعمر، وأتى بما أتى من أحداث تخالف المبادئ الأساسية كما ضنوا وجب عزله وقتله ، واقروا بصحة خلافة علي، لكن حين أخطأ في التحكيم حكموا بكفره، وطعنوا في أصحاب الجمل، طلحة والزبير وعائشة، كما حكموا بكفر أبي موسى الأشعري، وعمر بن العاص وأنه في نظرهم ليس من الضروري أن تحصر الخلافة في قريش، وهم في هذا يخالفون أهل السنة وجمهور المسلمين الذين اشترطوا النسب القرشي في الخليفة كما أنهم خالفوا الشيعة الذين يرون أن الخلافة تكون في نسل علي، وذهبوا إلى أن الخلافة تكون باختيار حر من المسلمين والمقياس لاختيار الخليفة هو صلاحه بغض النظر أنه قريشي أو غير قريشي عربي أو غير عربي، كما لا يجوز للخليفة حين يتم اختياره، أن يتنازل عن الحكم، وبالتالي عليه أن يخضع لهذا الاختيار إضافة إلى ذلك أنهم يرون بأن الخليفة يجب أن يتقيد تقيدا صارما بما أمر الله وينتهي عن كل ما نهى عنه الله بالنص، وإذا خرج الخليفة عن جادة الصواب، وعن العدل والحق، يجب عزله وإذا ثبت عن مظالم في صورة كبيرة الكبائر وجب قتله.
كما أن هناك رأي يمثله بعض الخوارج ينص على عدم تنصيب الخليفة فيكفي أن يعمل كل مسلم من تلقاء نفسه بكتاب الله ويطبق أوامر الدين ويتجنب نواهيه.
أمور تتعلق بالإيمان :
ينظر الأغلبية من الخوارج وحادث بينهم الاتفاق على أن كل كبيرة كفر، وأن الله عز وجل يعذب أصحاب الكبائر عذابا أليما، والعمل عندهم جزء من الإيمان فمن اعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم لم يعمل بفروض الدين وأرتكب الكبائر فهو كافر في نظرهم بمعنى أن العمل بقواعد الدين من صلاة وصيام وزكاة، وأوامر من صدق وعدل وصفاء جزء من الإيمان وليس الإيمان الاعتقاد وحده، وأن من أنكر ذلك أو تهاون في التزامه فهو مرتكب الكبيرة، وكافر يجوز قتله بل يجب قتله
الشيعة: إن ظهور الشيعة كان كاتجاه عفوي ، وهم جماعة كانت تعطف على علي بسبب قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأيه السديد ، وتطور هذا الاتجاه إلى حركة سياسية فيما بعد، بعد مقتل عثمان بن عفان، بعد حادثة التحكيم، وأصبحت هذه الحركة السياسية والدينية لها منطلقاتها وأسسها وآراؤها الخاصة بها في شئون الدنيا والدين ، وأهم المبادئ التي يقوم عليها الفكر الشيعي هي :
أ ، الوصية : إن المبدأ ينص على أن الخلافة أو الإمامة تكون بطريق الاختيار يقول ابن خلدون : " إن الإمامة ليس من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ، ويتعين القائم بتعيينهم، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ، ولا يجوز لنبي إغفالها ولا تفويضها إلى الأمة بل يجب عليه تعيين الإمام ويكون معصوما من الكبائر والضمائر، وأن عليا رضي الله عنه هو الذي عينه صلوات الله عليه وسلامه عليه، بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة، ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة "، ويفهم من هذا النص أن الشيعة قالوا بخلافة علي بدليل وصية النبي بعده، وأن الذين بايعوا أبا بكر ، فإن هؤلاء فعلوا تجاهلا أو جهلا بالوصية أو أنهم اغتصبوا حقا معتمدا ، و هناك من الشيعة الذين يقولون بالرجعة أي برجوع الإمام بعد أن يكون قد اختفى، أو مات ، لأن الوقت لا يخلو من إمام إما إمام ظاهر أو إمام مستتر .
ب - التقية : تذهب الشيعة بالقول أن البعض قد اغتصبوا الحكم في أثناء غيبة الإمام، وفرضوا أنفسهم على الأمة فرضا ، فماذا يكون موقف المؤمن الشيعي من هؤلاء المغتصبين حتى يرجع الإمام الحق ؟ يقول أن يفعل مثل باقي المسلمين يخضع لهذا الرئيس أو الحاكم المغتصب ، ويقوم بواجباته كلها نحوه ولكن يفعل هذا مكرها بالرغم منه ولا ينسى بأن هذا الخضوع هو في الأصل خضوع مفروض عليه وهو في ظنه خضوع مؤقت، فعليه أن يأمل دائما في رجعة الإمام العادل الحق، وصاحب الحق في الوقت نفسه ، ويظهر حتما عندما تتقوى شوكته أو عصبيته فيسترد حقه المسلوب بالقوة والاغتصاب فيثأر لنفسه من أعدائه، ويسترد حقه، بمعنى أنه يجوز للشيعي أن يخفي عقيدته الشيعية، وهذا إذا كان يخاف على نفسه بطش الحكام ، وبالتالي يخضع لحكمهم فيتبعهم ويظهر لهم ما لا يبطن في دعوته. والإعداد للثورة التي تضمن الاستمرار وعن المحن التي تعرضوا لها خلال تاريخهم السياسي الطويل .
ج - العصمة : ترى الشيعة أن الإمام أسمى رجل وهو ليس كباقي البشر في اعتقادهم أن الله أختاره ليكون حارسا على هذه الوديعة المقدسة التي أودعها إياه لهذا أن الإمام كان معصوما، فهو المحافظ على الشريعة وإلا كيف نفسر أن الشريعة بين أيدي أمينة فما الضامن لها، وبهذا فإن الإمامة هي حق إلهي، والإمام معصوم فما يقوله ويفعله صواب كما أن الإمام يرث سر النبوة عن آبائه وأجداده وأنه يعلم الظاهر والباطن، وهو الذي لديه القدرات والكفاءة وحده على فهم الدين وتأويل ما يحتاج إلى تأويل يقول غلاة الشيعة عن " علي " : أنه يعلم باطن القرآن وظاهره ، وأن الله أطلعه عن أسرار الكون وغيبيا ته، وأن كل إمام يورث هذا السر لمن بعده .وكل إمام يعلم الناس في وقته ما يستطيعون فهمه من الأسرار لذلك أن الإمام أكبر معلم .
المرجئة : أن المرجئة هي جماعة تكونت في المغازي، والحروب ومنهجهم الشك يقول أحمد آمين عنهم فيما نقل عن ابن عساكر : " إنهم هم الشكاك الذين شكوا وكانوا في المغازي، فما قدموا المدينة بعد مقتل " عثمان " وكان عهدهم بالناس، وأمرهم واحد ليس بينهم اختلاف قالوا : تركناكم وأمركم واحد ليس بينكم اختلاف، وقدمنا عليكم وانتم مختلفون فبعضكم يقول قتل عثمان مظلوما، وكان أولى بالعدل أصحابه، وبعضكم يقول : كان علي أولى بالحق وأصحابه ، كلهم ثقة وعند مصدق، فنحن لا نتبرأ منهما ولا نلعنهما ولا نشهد عليهما ونرجئ أمرهما إلى الله حتى يكون الله هو الذي يحكم بينهما " إن هذه الفرقة السياسية الدينية تريد أن لاتغمس يدها في الفتن ، ولا يريق دماء حزب، ولا يحكم بتخطئة وتصويب آخر فهدفت هذه الفرقة إلى التزام الحياد ، وفي رأيها أيضا أن الخلاف فيه التباس وغموض وجميع المنتمين إليها يظهرون الإيمان ويعملون في دائرة الإسلام، وإنما أرجئوا أمرهم إلى الله قال أحمد آمين : " كلمة المرجئة مأخوذة من أرجأ ، بمعنى أمهل وأخر، سموا المرجئة لأنهم يرجئون أمر هؤلاء المختلفين الذين سفكوا الدماء إلى يوم القيامة، فلا يقضون بحكم على هؤلاء، ولا على هؤلاء ، وبعضهم يشتق اسمهم من أرجأ بمعنى بعث الرجاء، لأنهم كما يقولون : لا تضر مع الإيمان معصية ، كما لا تنفع مع الكفر طاعة ، فهم يؤملون كل مؤمن عاص ، والأول أنسب لما حكينا على ابن عساكر " والموقف الديني لهذه الفرقة السياسية الدينية يتجسد في تعريف المرجئة أ] تأخير العمل يقول الشهرستاني "ملخصا لنا هذا الموقف كتابه الملل والنحل:" الإرجاء على معنيين أحدهما يعني التأخير قوله تعالى: ( قالوا أرجأه وأخاه ) * والثاني إعطاء الرجاء أما إطلاق أسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح لأنهم كانوا يؤخرون العمل على النية والعقد ، وإما بالمعنى الثاني فظاهر فأغلبهم كانوا يقولون : لا تضر مع الإيمان معصية ، كما لا تنفع مع الكفر طاعة ، وقيل : الإرجاء تأخير صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة ، فلا يقضي عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة ، أو من أهل النار ، فعلى هذا المرجئة ، والوعيدية فرقتان متقابلتان ، وقيل الإرجاء تأخير " علي " رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة فعلى هذا المرجئة ، والشيعة فرقتان متقابلتان .." والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الفكر الإرجائي هي :
أ – حقيقة الإيمان : الإيمان هو المعرفة بالله ورسله ، فمن عرف أن لا إله إلا الله محمد رسولا الله فهو مؤمن ، وهذا رد على الخوارج الذين يقولون إن الإيمان معرفة بالله ، وبرسله والإتيان بالفرائض ، والكف عن الكبائر وهذا كذلك رد أيضا على الشيعة، الذين يعتقدون أن الإيمان بالإمام والطاعة له جزء من الإيمان، ويذهب البعض من غلاة المرجئة أن المعرفة هي الإقرار باللسان والخضوع بالقلب، والمحبة لله ورسوله والتعظيم لهما والخوف منهما، والعمل بالجوارح فليس من الإيمان مسألة، بمعنى أنهم يؤخرون العمل عن النية والعقد، فالإيمان مسألة إعتقادية قلبية لا تطبيقية، وقالوا : بالرجاء أي يبعثون الأمل في النفوس، ولا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة.
حكم مرتكب الكبيرة: إن السؤال الديني في هذه المسألة تمثل فيما يلي، هل مرتكب الكبيرة كافرا أو مؤمنا هل يخلد في النار؟أم سيكون له مصير آخر ؟ تجيب فرقة المرجئة على هذه الأسئلة، وترى أن الحكم على مرتكب الكبيرة يدخل النار أو الجنة، وهذا أمر يتعلق بإرادة الله وحده، وليس من اختصاص الناس والحكم عليه في هذا الشأن، وبهذا فإنهم يخالفون الوعيدية من الخوارج كما أنهم يخالفون رأي المعتزلة في الذين يموتون وهم على كبائرهم فهم في النار خالدون، فالمرجئة تذهب إلى عدم إمكانية الحكم على أحد من المسلمين بالكفر منها أذنب، وإن الذنب مهما عظم لا يذهب بالإيمان، وإنما لا يسفك دم أحد من المسلمين إلا دفاعا عن نفسه، وإذا اشتبهت الأمور وكفرت كل طائفة أختها فيما فعلت أرجأنا أمرهم جميعا إلى الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أما الجور البين والعناد الواضح والأعمال الظاهرة نصدر أحكامنا عليها بصراحة ونبين الخطأ من الصواب.
مكانة ومرتبة علي كخليف: ترى بأن علي كرم الله وجهه يأتي في الدرجة الرابعة من حيث الترتيب التاريخي للخلفاء الأربعة، وهذا يخالف رأي الخوارج الذين أثبتوا إمامة عثمان في السنوات الأخيرة من حكمه، وكذلك أن إمامة علي تعتبر شرعية قبل التحكيم، ويخالفون رأي الشيعة الذين اعتبروا أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان إمامة غير شرعية فهي باطلة مع الملاحظة أن هذه الفرقة لم تستمر ويقال في التاريخ الإسلامي أن أغلب أنصارها انظموا إلى فرقة أهل السنة الأشاعرة، فرجالها الذين يمثلونها هم من أصحاب أهل السنة حماد ابن أبي سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف، والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب

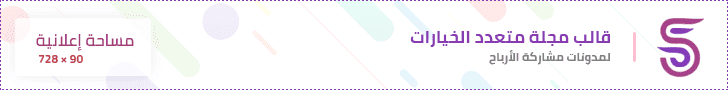
إرسال تعليق