المعتزلة إن ظهور هذه الفرقة كان في مطلع القرن الثاني للهجرة وكان في مدينة البصرة، وكان وقتذاك العلوم الفلسفية والعقلية حاضرة بقوة في منظومة النسق الفكري آنذاك، حيث أثرت في عقلية الناس في تلك المدينة وقد تضاربت الآراء، وحدث الاختلاف بين العلماء والمؤرخين في سبب نشأة المعتزلة وظهورها وحتى في مؤسسها إذ ظهرت فيها مواقف عديدة منها أن المعتزلة فرقة ظهرت -إثر الخلاف الذي حدث بين معاوية وعلي حول الخلافة حيث أن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأسامة بن زيد رفضوا القتال بجانبه فسموا بالمعتزلة، وهؤلاء يعتبرون أجداد المعتزلة اللذين أتوا من بعد، ومن أشهر الروايات تاريخيا ما يذهب إليه الشهرستاني، أن واصل بن عطاء الغزال هو مؤسس هذه الفرقة عندما اختلف مع أستاذه الحسن البصري في مسألة كبيرة الكبائر حيث سأل أحدهم ذات مرة الحسن البصري وهو في المسجد يلقي دروسه على طلاب العلم، هذا السؤال هل من أتى كبيرة من الكبائر صاحبها مؤمن أم كافر؟ وقبل أن يجيب الحسن في ذلك قال واصل بن عطاء أنا " لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا، ولا كافر مطلقا بل هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ، ولا كافر ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به فقال الحسن مع جماعة من أصحابه : أعتزل عنا واصل فسمي هو وأصحابه معتزلة " وهناك روايات كثيرة في ذكر تسمية المعتزلة ، هذا وأن الفكر الاعتزالي يقوم على مبادئ ينطلق منها في التفكير تعرف بالأصول الخمسة فمن اعتقدها جميعا كان معتزليا، ومن أنقص منها أو زاد عليها لم يطلق عليه لفظ الاعتزال، أو لا يسمى معتزليا .
التوحيد: يمثل هذا المبدأ عند المعتزلة الركن الأساسي في الدفاع عن الإيمان بوحدانية الله فقد ردوا على أهل الشرك كالمجوسية بفرقها والدهرية فهي تذهب بأن الله واحد في ذاته لا شريك له، وكذلك لاشريك له أيضا في خلق هذا العالم وتكوينه ولا شريك له في القدم، ونفى المعتزلة أن تكون لله صفات قديمة زائدة على ذاته سبحانه، وأثبتوا هذه الصفات من حيث أنها عين الذات الإلهية، وبهذا يتحدد معنى التوحيد عندهم . لأن : " الذات الإلهية واحدة في ذاتها إذ ليس هناك ذات وصفات متميزة عن الذات فالله مثلا قادر بقدرة وقدرته ذاته، وعلم بعلم وعلمه ذاته، وهكذا " وهذا ما دفع المعتزلة بـتأويل الآيات التي توحي بوجود شبه بين الله وبين الأشياء الحادثة ، ومثل ذلك الآيات التي تذكر صراحة فيها اليد، والعين، والوجه، أعطوا لدلالة هذه الألفاظ معاني مجازية حتى لا يتبادر إلى الذهن، أن الذات الإلهية متشابهة مع الكائنات الحية .. واهتم المعتزلة بإثبات انفراد الله بالقدم فذهبوا أن هذه الصفة صفة القدم هي أخص الخصائص التي تتصف بها الذات الإلهية قالت المعتزلة : " إن الله عالم بذاته حي بذاته، لا بعلم وقدرة، وحياة، هي صفات قديمة ومعان قائمة به لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الألوهية فكل ماعدا الله من الكائنات حادثة" ويعالجون مسألة كلام الله ، فإذا كان كلامه مخلوقا فالقرآن هو مخلوقا أيضا، لأنه كلام وقد خلقه الله وأحدثه، ولا يمكن أن يكون الله أحدث الكلام في ذاته بحجة أنه إذا تكلم فمعنى ذلك أنه خلق في ذاته الصوت، الذي هو جسم أو عرض، وأصبحت ذاته محلا للحوادث، ولا يجوز أن يحدثه لا في مكان أو محل لأن الأجسام والأعراض تتطلب مكانا أو محلا تحل به، وبالتالي لا يبقى معه إلا أن يحدثه في مكان، وبهذا فإن الله متكلم، ولكن ليس بكلام قديم، وإنما بكلام محدث يحدثه عند الحاجة عند الكلام، وأنه خارج عن ذاته العلية، ونفت المعتزلة الجهة عن الله تعالى، وأن الله لا يوجد في مكان معين وإلا وجب إثبات المكان والجسمية، ومن المعتزلة من تشدد في إنكار الصفات خوفا من الوقوع في التشبيه، أو الوقوع في تصور الذات على أنها شيء نسبي أو محدود، وعليه أنكروا أن يطلق على الله القول بأنه قديم ، لأن القول بهذه الفكرة يؤدي إلى التقادم الزماني مع أن وجود الله فوق مفهوم الزمان
العدل : هو الأصل الثاني، بعد أصل التوحيد وقد سمي المعتزلة أنفسهم بأنهم أهل العدل والتوحيد، والعدل عرفه القاضي عبد الجبار على هذا النحو، أن أفعال الله كلها حسنة، وأنه سبحانه لا يفعل القبيح، ولا يخل بما هو واجب عليه والمقصود بالعدل أن الله لا يظلم أحدا من عباده، وبهذا أن الإنسان حر مختار مسؤول عن أفعاله، وأنه هو خالقها، والله يحاسبه على ما فعل ولا يتدخل في أفعال العباد، لا لأنه لا يستطيع بل لأن الله أقدر العباد على أفعال محدودة ، وكلفهم أدائها، فلو كان خالق أفعال العباد لبطل التكليف، والوعد والوعيد لأن التكليف طلب، والطلب يستدعي مطلوبا ممكنا من المطلوب منه فإذا لم يتصور منه فعل بطل الطلب فإذا كانت أفعال العباد من عند الله أو من صنعه فكيف يحاسبهم الله عليها يوم القيامة؟ وكذلك لو كان الله هو خالق أفعال العباد ، فلماذا بعبث الرسل والأنبياء إلى الإنسان .. وهذا ما دفع المعتزلة بأن الإنسان حر في أفعاله وقادرا عليها، ويمتنعون عن القول بأن الله هو خالق أفعال العباد ، لينفوا عنه الظلم والقبح ، واستدلوا بآيات قرآنية كثيرة منها ((وما ربك بظلام للعبيد )) (( وما الله يريد ظلما للعباد )) (( إن الله لا يظلم الناس شيئا لكن الناس أنفسهم يظلمون ))
الوعد والوعيد : قالوا، أن الوعد هو كل خير يتضمن ايصال نفع إلى الغير أو أنه دفع ضرر عنه في المستقبل ولا فرق بين أن يكون حقا مستحقا، أو لا يكون . في حين أن الوعيد فهو كل ما يضمن ايصال ضرر إلى الغير، أو تفويت نفع عنه في المستقبل، ولا فرق بين أن يكون مستحقا، وبين أن لا يكون كذلك.، ولا بد من وضع المستقبل في ذهننا فيما يأمر الوعد والوعيد لأن في الأصل يتضمن حدوث شيء أو إن شئتم جواز حدوث شيء في المستقبل لأنه إذا نفذ الوعد أو الوعيد في الحال لما أصبح كذلك قالوا : إذا خرج المؤمن من الدنيا على طاعة وتوبة عن كبيرة ارتكبها خلد في النار وكان عذابه فيها أخف من عذاب الكفار، فإنهم أنكروا الشفاعة. بهذا يوم القيامة، وتجاهلوا الآيات القرآنية التي تدل على الشفاعة، وتمسكوا بالآيات التي تنفيها
المنزلة بين المنزلتين :
ترى المعتزلة أن الذي أرتكب كبيرة الكبائر، صاحبها ليس مؤمنا، وليس كافرا، بل فاسق والفسق عندهم موضوع في المرتبة الثالثة مستقلة عن منزلتي الإيمان والكفر، فمرتكب الكبيرة دون المؤمن، وخير من الكافر أي لا يرتفع إلى مرتبة الإيمان، ولا يكون في حضيض الكفر، واعتمدوا على آيات قرآنية منها''((وكذلك جعلناكم أمة وسطا ، لتكونوا شهداء على الناس ))
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
ترى المعتزلة من الواجب على سائر المؤمنين كل على قدر استطاعته، وبهذا المبدأ دفع بهم إلى اضطهاد مخاليفهم، وكانوا يقسون عليهم، لاعتقادهم أنهم بمخالفتهم قد أتوا منكرا، مثال ذلك في التاريخ الإسلامي، نفى، واصل بن عطاء ، بشار بن برد من البصرة إلى الحيرة، ولم تتوسع المعتزلة في هذا المبدأ لما له من علاقة وثيقة بالسياسة، واستدلوا على هذا المبدأ بآيات قرآنية منها قوله تعالى : '(( يا بني أقم الصلاة وآمر بالمعروف وأنه عن المنكر )) والحديث الشريف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يسطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " إن هذا الأصل الخامس عند المعتزلة يندرج في مبحث الأخلاق .
مشكلة الإمامة عند المعتزلة : ترى المعتزلة لا يكون وسيلة أن الإمام لا يكون وسيلة لمعرفة الشريعة لأن في اعتقادهم أن الشريعة تعرف من الكتاب والسنة، والإجماع، والاجتهاد، والقياس، وهذا متفق تمام الاتفاق مع مذهبها العقلي وبالتالي فدور الإمام عندها يقتصر على الدور السياسي، حيث يقف الإمام على الحالة الاقتصادية، والحربية والسياسية، ويعمل على تنفيذ أوامر الحكم السياسي فيها كما يعمل على تنفيذ حدود الله فحسب، أما التحريم والحلال ، فهو لا يخص الإمام، إنما ينبغي أن يعرف من النص والإمام لا ينصب بالوراثة أو النص، ولا ينتمي إلى طائفة معينة، وإنما ينبغي أن يكون الإمام مبرزا في العلم مجتهدا، وأن يكون مالك ناصية اللغة العربية حتى يفهم النصوص الدينية فهما جيدا ويكون عالما بتوحيد الله وعدله وعالما بما يجوز على الله من الصفات وما لا يجوز، وما يجب له من الصفات، وما لا يجب، ويكون عالما بنبوة محمد عليه السلام وأيضا يكون ورعا شديدا، ويكون موضع ثقة المسلمين، ولا يكذب ، ولا يغش، ولا يخدع، ولا ينافق، ويكون عند حسن ظن الجميع وحسن السيرة، ويكون مجتهدا ويكون ذا بأس وشدة وقوة قلب
الأشاعرة : ممثل هذه الفرقة هو أبو الحسن الأشعري الذي حاول أن يتخذ موقف وسط بين المعتزلة كاتجاه عقلي متطرف، وبين أهل السنة من المحدثين المتطرف ورأي بعض المؤمنين، وكان من الذي يتخذ هذا الموقف الوسط أن يرضي العقل من جهة والإيمان في الوقت ذاته إن الصراع بين الموقف العقلي المعتمد على المنطق والقياس، والموقف السني المتمسك بحرفية النص قد سبب في صراع فكري كاد أن يؤدي بل أدى بالعقيدة الإسلامية إلى الجمود فأخذ الأشعري موقفا معتدلا ووسطا بينهما‘ يرى أن النظر والاعتبار العقلي في فهم العقيدة هو ليس بدعة وإنما هو ذا قيمة ظرفية في إقامة الأدلة العقلية لتأييد العقيد ة وهذه الفائدة متوقفة عليه وجود النقل قبل العقل أي أن العقل في خدمة الشرع، وليس العكس ، فالعقل تابع للشرع ولا يلتزم أحكامه إلا إذا أيدها وقبلها الشرع .
مسائل كلامية عند الأشاعرة :
1- التوحيد ( ذات الله وصفاته ، يرى الأشاعرة أن الله القديم الواحد لا يشبه شيء ولا يشبهه شيئا، ولو أشبه الحوادث، لكان حكمه في الحوادث كحكمها وهذا أمر محال لأن الله : (( ليس كمثله شيء )) وأثبت الأشاعرة صفات الله الورادة في القرآن، والسنة فالله عالم، لأن الأفعال المتسقة التدبير والنظام لا تكون إلا من عالم، والله حي قادر فلا يجوز أن تحدث الصنائع إلا من حي قادر، والله مريد ، وإرادته مطلقة شاملة، والله خالق كل شيء (( فعال لما يريد ))، وهذه الصفات أزلية قديمة، وليس حادثة ، لأن الله ليس محلا للحوادث، ولو كانت محدثة قديمة قائمة بذاتها فإن هذا يؤدي إلى تعدد القدماء، ويعتبر شرك، ولما كان الله قديما و كانت صفاته قديمة فعلية وأن هذه الصفات قائمة بذات الله ولا يمكن تصور انفصالها عن ذاته، فلا يمكن أن يكون الله حيا بغير حياة أو عالما بغير علم أو مريدا بغير إرادة أو متكلما بغير كلام (( الله حي بحياة عالم علم بعلم مريد بإردة متكلم بكلام ))، ويرى أن هذه الصفات ثابتة قائمة بذات الله ولذاته كلها، والله ما يزال موصوفا بها لأنه تليق بذاته غير أنها لا تشبه صفات الإنسان والحوادث، وليس بمقدور العقل أن يكشف عن ما هياتها وأن لله يد، ووجه، وعين، وساق، وأثبتها كل من القرآن والسنة لكن أنها قضايا تمثل صفات حقيقية من غير الممكن معرفة كنهها .
2- مسألة الرؤية: يرى الأشاعرة أن رؤية الله ممتنعة في الدنيا، ولكنها جائزة في الآخرة ، وقد أثبتوا هذا بأدلة نقلية وعقلية يقول الله تعالي: (( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة )) آية محكمة تدل صراحة على جواز رؤية الله بالأبصار في الآخرة فالنظر إذا ذكر مع الوجه فمعناه نظر بالعينين اللتين في الوجه وليس الانتظار، وأن الآية التي تنص (( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار )) فإنها آية متشابهة يمكن تأويلها أن الله لا يرى في الدنيا دون الآخرة، وأن كل موجود فهو مرئي من حيث هو موجود، وليس من حيث هو جوهر وأعراض ، والله موجود فهو إذن مرئي .
3- مسألة الكلام : تفرق الأشاعرة بين نوعين من الكلام، الكلام النفسي الذي يجول في النفس، والكلام المتلفظ الذي هو دليل على الكلام النفسي، والدليل غير المدلول ، فالكلام هو المعنى قائم بذات الله ، وهو أزلي قديم يمثل جملة المعاني والأفكار، والكلام بالمعنى الثاني متغير بتغير العبارات، والذي هو جملة الألفاظ والأصوات والحروف فهو محدث مخلوق إذن كلام الله ألفاظه وإشاراته المقروءة والمكتوبة وبالتالي أن تنزيل القرآن بالمعنى الأشعري ليس معناه تنزيل الألفاظ إنما هو تنزيل المعاني والأفكار القديمة
4- مسألة الفعل الإنساني في نظرية الكسب : تنظر الأشاعرة للفعل الإنساني بأنه يتم بالمشاركة مع الله تنظر الأشاعرة للفعل الإنساني بأنه يتم بالمشاركة مع الله فلا يستقل بالأفعال أي من الطرفين بها وحده ، بحيث لما كان الله لا يحتاج في أفعاله الخاصة إلى معين فيبقى أن العبد هو المحتاج إلى عون الله في أفعاله، ومن ثم فالفعل ينسب إلى فاعلين هما الله والعبد فلو كان الإنسان خالقا لأفعاله في نظرهم لأتت أفعالهم على نحو ما يشتهي وما يرغب فيه، وما يريده لكن لما كانت على غير ذلك فإن هذا يعني وجود فاعلا حقيقيا وهو الله، غير أن القدرة الموجودة في الإنسان التي تمكنه بالاختبار والإحساس من وقوع الفعل من نفسه، وأنه يعمل ما يشاء، ويترك ما يشاء، هي قدرة خارج ذات الإنسان لأنها لوكانت ذاتية لكانت ملازمة له بالضرورة والإنسان يكون غير قادرا أحيانا، والله الذي خلق الإنسان يخلق فيه نوع من القدرة والاستطاعة يحسه الإنسان أثناء الفعل ومعه، وهذا النوع من الاستطاعة والقدرة سماه الأشعري بالكسب . فالكسب بحسب هذا الفهم هو ارتباط الفرد بالفعل المقدور من الله، والمخلوق لله فعلا من غير أن يكون للإنسان تأثيرا في هذا الكسب يقول الأشعري : (( المكتسب المقدور بالقدرة الحادثة، والحاصل تحت القدرة الحادثة، ولا تأثير للقدرة الحادثة في الأحداث لأن جهة الحدوث قضية واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض، فلو أثرت في قضية حدوث كل محدث حتى تصلح لأحدث الألوان والأطعمة والروائح وتصلح لأحداث الجواهر والأجسام فيؤدي إلى تجويز وقوع السماء على الأرض بالقدرة الحادثة ، غير أن الله تعالى أجرى سنته بأن يخلق عقيب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها الفعل الحاصل إذا أراده وتجرد له، ويسمى هذا الفعل كسبا فيكون خلقا من الله تعالى، إبداعا وإحداثا وكسبا من العبد مجعولا تحت قدرته ، فالأفعال في نظر الأشاعرة مخلوقة لله وليس للإنسان فيها إلا اكتسابها وهنا تظهر مشكلة تتمثل في عدالة الله يوم القيامة .
الخلاصة : يتبين لنا من خلال عرض هذه الفرق التي تمثل تيارات فكرية كبرى أن الحضارة العربية الإسلامية، كانت لها مناهج فكرية خاضت في مسائل الحياة والوجود والإنسان والألوهية من زاويتين زاوية العقل، وزاوية النقل، وكان على يدي هذه المناهج اختلاف رؤى سببت في وجود مفاهيم ونظرات علاج لثقافة الأمة العربية الإسلامية كما أنها تدل على مدى تقدم العقل العربي وقتذاك بربط العقل التجريبي، والعقل المجرد مع الحقائق الدينية ذات الطابع الميتافيزيقي في غالب الأحيان .
المذاهب الفلسفية عن الآخر أو الغرب
ليس من السهل عرض كل التيارات الفكرية والفلسفية ، وذلك لكون أن المذاهب الفلسفية كثيرة ، وكذلك كثرة أعلامها ، لذلك أوجزنا الحديث عن هذه المذاهب بإيجاز شديد وحصرناها في الاتجاهات التالية وهي :
1- الاتجاه الفلسفي التقليدي
2- الوضعية المنطقية .
3- الفلسفة البرجماتية " النفعية : .
4- الماركسية .
5- الوجودية .
إن هذه المذاهب كانت لها تأثير في الفكر الإنساني العالمي ، لذلك يجب معرفة محتواها وما تهدف إليه
وقبل التطرق إلى هذه المذاهب نذكر بعض المعلومات عن الاتجاهين الفلسفيين الكبيرين اللذين ظهرا وتبلورا في إبان العصر الحديث، وهما:
الاتجاه العقلي الديكارتي ، والاتجاه التجريبي .
المذاهب الفلسفية عن الآخر أو الغرب
ليس من السهل عرض كل التيارات الفكرية والفلسفية ، وذلك لكون أن المذاهب الفلسفية كثيرة ، وكذلك كثرة أعلامها ، لذلك أوجزنا الحديث عن هذه المذاهب بإيجاز شديد وحصرناها في الاتجاهات التالية وهي :
1- الاتجاه الفلسفي التقليدي
2- الوضعية المنطقية .
3- الفلسفة البرجماتية " النفعية : .
4- الماركسية .
5- الوجودية .
إن هذه المذاهب كانت لها تأثير في الفكر الإنساني العالمي ، لذلك يجب معرفة محتواها وما تهدف إليه
وقبل التطرق إلى هذه المذاهب نذكر بعض المعلومات عن الاتجاهين الفلسفيين الكبيرين اللذين ظهرا وتبلورا في إبان العصر الحديث، وهما:
الاتجاه العقلي الديكارتي ، والاتجاه التجريبي .
أولا الاتجاه العقلي : يمثل هذا الاتجاه الفيلسوف الفرنسي ديكارت 1596- 1650 م ، فهو المؤسس الحقيقي للنزعة العقلية في فلسفة العصر الحديث والمعلم الفلسفي البارز في الفلسفة الحديث . ويراد بالنزعة العقلية أنته تلك الاتجاه الذي يرد المعرفة الإنسانية ومعايير صدقها إلى العقل الإنساني ، وليس إلى الواقع أو الحس . ، والرياضيات عند ديكارت هي العلم اليقيني بالمعنى العميق والتام لهذا الوصف وهي المثل الأعلى لكل العلوم من حيث مناهجها ، ومن ثم طالب ديكارت ، وأنصار النزعة العقلية باستخدام المناهج الرياضية في دراستهم للمشاكل الفلسفية وراح ديكارت ينادي بالتخلص من الكنيسة ومن سلطة أرسطو وأن يستبدل بهما سلطة العقل ، نعم سلطة العقل الذي هو القاسم المشترك بين الناس جميعا ، وأن نفحص بالعقل وحده آرائنا الفلسفية ، وأن يكون وحده هو الفيصل في الحكم على صحة هذه الآراء أو عد صحتها ، وقد ثار ديكارت على فلسفة أرسطو وفلسفة العصور الوسطى وأبدى عدة مآخذ عليها منها :
1- أنها لم تعمل على تحقيق السعادة .
2- لم تحقق غرضا أو مصلحة عملية للبشر لكنها ربطت نفسها بالكنيسة .
3- أصبحت الكنيسة المرجع والفيصل في البحوث الفلسفية .
4- أتسمت الكنيسة بالغموض والخلط والاضطراب . ، وكذلك فلسفة أرسطو .
لهذا الفعل الفلسفي النقدي راح ديكارت في العصر الحديث يؤسس فلسفة أساسها قائم على العلم الرياضي ، الذي يستخدم المنهج الاستنباطي في إقامة براهينه ، وفي استخلاص نظرياته ، حتى يتحقق للفلسفة ما تحقق للرياضة من دقة ويقين .
ولزاما في نظر ديكارت على الفيلسوف أـن يتعلم الرياضة ، ويبدأ منها وبهذا المنحى يعيد ديكارت إلى الأذهان ما كان مكتوبا على باب أكاديمية أفلاطون من لم يكن حاذقا في الهندسة لا يدخل علينا . وديكارت يرى أن إصلاح الفلسفة لا يكون إلا بإصلاح مناهجها ، ويقوم منهجها على أسس رياضية ، حتى تفوز بما فازت به العلوم الرياضية من الوضوح والدقة واليقين .
وللمنهج الرياضي الديكارتي خاصيتان بارزتان :
- البداهة ، بداهة الأفكار التي يستخدمها علماء الرياضة .
- والترتيب المنطقي الذي تتسلسل بمقتضاه هده الأفكار . لكن السؤال الذي يطرح هنا هو كيف تتحقق هذه البداهة الرياضية للأفكار والنظريات الفلسفية . ؟
من دون شك أن تحقيقها لا يكون إلا بتخليص تفكيرنا الفلسفي من بعض المعوقات مثل
طرح الأفكار الصادرة من السلطات المعرفية أيا كانت هذه السلطات فلسفية أو سياسية أو دينية أو كنسية ، لأنها أشد الأفكار ميلا مع الهوى . وبعدا عن اليقين .
هجر الأفكار التي يتفق حولها الجماهير لأنها ليس كثرة الأصوات التي تجتمع على رأي واحد دليلا على صحته .
ترك شهادة الحواس لأنها كثيرا ما تكون خادعة .
هجر المنطق الأرسطي كآداة للمعرفة لأن القياس الأرسطي هو صلب منطق اليونان وعموده أداة عقيمة لا توصل إلى معرفة جديدة . فهو لا يثبت لنا حقيقة معينة تندرج تحت حقيقة أخرى أعم منها ، وهو بهذا يعرقل حركة الذهن الطبيعية ، ويجعله يدور حول نفسه ... ولا يساعدنا على اكتشاف الحقائق الجديدة . والمنهج الديكارتي يقوم أساسه على ركيزتين هما الحدس ، والاستنباط .
- فالحدس هو الإدراك الذي لا يقبل الشك عن طريق العقل اليقظ وهذا الإدراك سبيله نور العقل وحده . وهو إدراك بسيط ، بمعنى غير مشوش أو مضطرب ولا يبقى نعه أي نوع من أنواع الشك ، كما قال ديكارت أنا أفكر إذن أنا موجود أو أن المثلث محاط بثلاث أضلاع فقط ، والحدس يتصور موضوعه من دون أن يصدر عليه حكما .
- الاستنباط الديكارتي هو تلك الحركة الذهنية المتصلة التي تدرك إدراكا حدسيا كل حد من حدود الاستنباط . وهو ، حركة ذهنية تسنتج بها شيئا مجهولا من شيء معلوم .
والفرق الذي يجعلنا نقيمه بين القياس الأرسطي ، والاستنباط الديكارتي هو كما يلي :
1 - القياس الأرسطي يفتح المجال للقضايا الاحتمالية والظنية بواسطة الأقيسية الخطابية والظنية واستنباط ديكارت لا يتضمن إلا القضايا اليقينية .
2- القياس الأرسطي هو رابطة بين أفكار ،بينما الاستنباط الديكارتي رابطة بين حقائق .
3- العلاقة القائمة بين الحدود تخضع لقواعد معقدة في المنطق الأرسطي ، بينما الاستنباط عند ديكارت يقوم على الحدس الذي يدرك بين الحدود التي تؤلفه إدراكا بديهيا .
4- النتيجة التي يصل إليها في القياس متضمنة في مقدماته، بينما النتيجة التي نصل فيها عن طريق الاستنباط تمثل معرفة جديدة تكتسب بالتأمل العقلي.
5 - وضمن النقد الذي صبه ديكارت على الفلسفة الأرسطية ، قدم للعقل المعرفي أربع قواعد يمكن تطبيقها على أي بحث نظري وهي :
- قاعدة اليقين ، - قاعدة التحليل ، -وقاعدة التأليف والتركيب ، - وقاعدة الاستقراء التام .
فالنزعة العقلية تنظر إلى الحقيقة على أنها حقيقة متعقلة ، وليست حقيقة عينية حسية ، ومن أعلام هذا الاتجاه إلى جانب ديكارت ليبنيتز ، وكانط ، ولوك ، وغيرهم .
ثانيا: النزعة التجريبية،
تفجرت في القرن السابع عشر ثورة علمية تحمل شعار التجريب وإعادة النظر في المعارف التي لها علاقة بدراسة الطبيعة وظواهرها وكانت على أيدي علماء كبار مثل كبلر وغاليلي ، ونيوتن ، وفرنسيس بيكون . فبيكون ( 1561م – 1626 م ) هاجم الفلسفة الكلاسيكية ، وبالأخص الأرسطية وحط من قيمتها وحملها سبب تخلف العلم أو توقف التطور العلمي ، فأصبحت الفلسفة أشبه بصنم ميت يقدس ويعبد . وسبب هذا العقم الفلسفي بدءً من سقراط إلى اللذين أنو من بعده ، لم يهتموا بدراسة الطبيعة وتفسيرها ، فاعتنوا بتسجيل هواجس و خواطر العقل ووصلوا في تقديرهم للعقل الإنساني إلى حد التقديس والعبادة . وكان تخلف العقل وعقمه في نظر بيكون هو المنهج الذي أتبع في المعرفة آنذاك فهو منهج ضال مغلوط خاطئ في البحث والنظر . ، وعليه لابد اللجوء إلى إصلاح المنهج العلمي ، ، فوضع بيكون المنهج الاستقرائي التجريبي ، وضمنه كتابه الأرغانون الجديد . وهو كتاب يمثل نقض للأرغانون الأرسطي ، ، يقول برتراندرسل : ( لقد كان بيكون أول ذلك الصف الطويل من الفلاسفة ذوي العقول العلمية ، الذين أكدوا أهمية الاستقراء كمقابل للقياس .
واجتهد بيكون في وضع قواعد منهجه الجديد فأرسى قواعده على دعامتين السلبية والإيجابية ، أما السلبية : وتعني عنده تخليص العقل الإنساني من الأوهام والتي هي :
أوهام القبيلة : وهي تلك السلبية العقلية المتأصلة في الطبيعة البشرية كالميل إلى التعميم مثلا :
أوهام الكهف : وهي الآراء الشخصية المسبقة المميزة للباحث الفرد .
أوهام السوق وهي تلك المتصلة بسوء استخدام اللغة .
أوهام المسرح وهي المتصلة بتأثير المذاهب الفلسفية والفلسفات الشائعة .
أوهام المدارس، وهي المعارف التي تتكون من الاعتقاد بأن قاعدة ما عمياء كالقياس يمكن أن تأخذ مكان الحكم في البحث .
أما الجانب الإيجابي : يتمثل في تلك القواعد الإجرائية التي ينبغي مراعاتها في البحث العلمي الاستقرائي .
فالمعرفة قوة تهدف لمعرفة الطبيعة بواسطة الاكتشافات والابتكارات العلمية .
وما يلاحظ عن فلسفة بيكون التجريبية ، أنه كان يحط من قيمة الاستنباط والرياضيات بصفة عامة ويزعم أنها غير كافية من الناحية التجريبية ،
وها هو برتراندرسل يقول " إن الدور الذي يلعبه الاستنباط في العلم أعظم مما ظن بيكون ، ففي كثير من الأحيان حين يتعذر اختيار الفرض ، فثمة رحلة استنباطية طويلة من الفرض إلى النتيجة لا يمكن اختبارها بالملاحظة ... وعادة ما يكون الاستنباط رياضيا ، وفي هذا الصدد يبخس بيكون أهمية الرياضيات في البحث العلمي " ،
تعقيب : من دون شك أن النقد الموجه للفلسفة الإغريقية المتمثلة في فلسفة أفلاطون ، وفلسفة أرسطو ، كان نقدا بناءً ، وهو الخلاص من النزعة الفكرية ، العقيمة إلى موضوع المعرفة لا من زاوية الموضوع المدروس ، وإنما زاوية الأنا العارف ، وما يتضمن من مقولات فطرية تؤسس المعرفة الذاتية ، فكانت الحاجة ماسة إلى البحث عن منهج جديد يتضمن أطر تأسيسية أخرى للمعرفة ، فوضع ديكارت أسس المنهج العقلي ، ووضع للاستنباط الرياضي مكانة ، أعلى وأسمى في مضمون هذا المنهج على حساب الحس والملاحظة والتجربة والواقع الموضوعي .
أما بيكون أسس المنهج التجريبي ووضع مكانة سامية للتجربة والاستقراء على حساب العقل الرياضي . أو الاستنباط الرياضي ، أو بتعبير آخر على حساب التأمل العقلي .
ومع هذا ظهر القصور في المنهجيين كليهما ، مما أدى إلى نوع من الصراع الفكري والمعرفي بين المذهبين : " والحق أن القرن السابع عشر بأكمله كان بمثابة نقاش وجدل بين التجريبيين والرياضيين ... واستمر الجدل بينهما حتى إسحاق نيوتن فبرهن على أن المزج بين التجريبية وبين الرياضيات أو بين الحس والعقل هو أفضل السبل ، بل أعمقها فائدة ، فالتجريبية غير الهادفة ، يمكن أن تكون عقيمة " كل من المذهب العقلي والتجريبي خلع عن نفسه اللباس المعرفي الأرسطي ، وكذلك سلطة الكنيسة ، فالعقلي سلم بالعقل ، والتجريبي سلم بالتجربة والحس والملاحظة ، مما سادت في أوساط بعض العلماء والفلاسفة موضة عارمة من الشك والإلحاد والكفر ، وإن كانت للكنيسة دور يذكر في ذلك الوقت ، وهو التذكير بكراهة العلماء للدين . والحط من شأنه ، والعمل على الكفر والإلحاد ، ولا يمنع أن الكثير من المنجزات العلمية الرائعة التي تحققت على أيدي كثير من العلماء كانوا على قدم راسخة من الإيمان . بل إدراكهم للآيات الكونية زادتهم يقينا وثباتا ومكنتهم من البحث والبحث لكثير من حقائق هذه الآيات . لكن لا يمنعنا من القول : أن الأكثرية من العلماء كانوا من وراء تحقيق قدر كبير من الإيمان .
وأحسن ما نضيفه إلى هذا التعقيب : هو قول رونالد سترومبرج : " ينبغي علينا أن نكرر القول بأن ديكارت كان يعتبر في نظر الكثيرين مجحرر الفلسفة من اللاهوت ، ومحطم التحالف بين العلم والميتافيزيقا والدين ، ذلك التحالف الذي استمسك به طويلا المشاؤون وكان أيضا واضع الفيزياء الميكانيكية حيث كانت الحاجة إلى الله تتمثل فقط في إعطائه الدفعة الأولى للكون ، وذلك منذ زمان لانهائي وسحيق في ماضيه ، وهذه فكرة شديدة الخطر من حيث أنها فكرة تخرج على الربوبية التقليدية ، ، علما أن ديكارت أستند بشدة إلى الله بوصفه الضامن لكون منتظم ، وقد وجد عدد من العباقرة ك ( باسكال ، وليبنتز ) أن نظرية ديكارت تلك تبعث على القلق ، وعدم الارتياح وهنا سنذكر الانسحاب الشهير لباسكال وتراجعه إلى الدين الصوفي ، مرعوبا من " آلة الكون " التي لا إله لها .. ومن ثم كانت هنالك حاجة إلى برهان مقنع على أن العلم الجديد لن يدمر أسس الأخلاق والنظام الاجتماعي " وموقف بيكون لم يكن أفضل من موقف ديكارت في هذا المنحى ، " إلى كانت النيوتينية تحسينا للديكارتية وتطويرا لها من حيث الإيمان بالإلوهية ، والنظرة إليها فالدور الذي أناطه ديكارت بالله كان دورا سلبيا إذ حدد وضع الإله كضامن لانتظام الكون ومعقوليته ، وسمح له فقط بأن يعطي الآلة الكونية ، الدفعة الأولى من الحركة حيث تدير فيما بعد نفسها بنفسها بعد تلك الدفعة ، ولكن آلة العلم عند إسحاق نيوتن ، تستوجب وجود الله ليتولها بعنايته ، فالله باق إلى الأبد ، وموجود في كل مكان ، وهو بوجوده الأبدي وفي كل مكان ينشئ ويعين الديمومة والمكان . "
المذهب البرجماتي :
إن هذا المذهب هو في الواقع يمثل أول إسهام في الفكر الفلسفي الأمريكي ، وهو المذهب الذي أتخذ من فكرة النجاح ، المبدأ الأساسي في فلسفته ، ويطلق في الفكر العربي إسم المذهب النفعي ، أو فلسفة العمل أو الفعل ومن وراء هذا المذهب فلاسفة وهم : تشارلز بيرس : 1839م - 1914 م ووليم جيمس 1842م – 1910م وجون ديوي 1859 1952م ، وهذا المذهب لم يكن له أتباع وأنصار أو مقتصرا على أمريكا فحسب بل كان له أنصار كثيرون في أوربا وعرف انتشار واسعا بهيمنة أمريكا على العالم في كل النواحي السياسية والاقتصادية ، والعسكرية ،
أصحاب هذا المذهب يزعمون بأنهم يغيروا العالم ويهدفون إلى تحقيق السعادة للأنسانية وهاجم هؤلاء البرجماتيون بالأخص جون ديوي الميتافيزيقا بوجه عام وكذلك الدين وكانت هذه المهاجمة مبنية على أمرين هما :
- التفكير الميتافيزيقي لا يهتم بما يتصل بسيطرة الإنسان على الطبيعة ومحاولة فهمها والاستفادة من نتائجها فالميتافيزيقا تفكير ضال فلا يسهم بأي شيء فيما أحرزه الإنسان من تقدم في مجال العلم عن طريق البحث التجريبي الاستقرائي .
- التفكير الميتافيزيقي وما يتناول من قضايا لا تهم الإنسان وخاصة في حياته الواقعية ، عاق البحث العلمي ، وصبغ الفلسفة بصبغة قطعية جامدة وأغلق عقول الناس ، وأعاقها عن البحث في العلم الطبيعي لاستخراج ما فيه من إمكانات كامنة "
إن جون ديوي يذهب كغيره من الفلاسفة التنويريين من ديكارت وفرنسيس بيكون وهوبز وسبنسر ومل أن الميتافيزيقا هي بحث في علم اللاهوت وهي مظهر من مظاهره لذلك في رأي جون ديوي أن المشكلة الأساسية في الفلسفة وبالأخص أن الميتافيزيقا سمحت لمباحثها أن تختلط بالمباحث الدينية ، فيقول: " عندما كنت أقرأ أفلاطون رأيت الفلسفة ، تسير سيرا طبيعيا ‘لى أساس سياسي يستهدف تنظيم مجتمع عادل ... ولكنها سرعان ما ضلت في أحلام العالم الآخر ... ولن يبدأ العصر الحديث إلا إذا تبنى الإنسان وجهة النظر الطبيعية في كل الميادين إن هذا لا يعني الهبوط بالعقل ... ولكنه يعني أن لا تفهم الحياة والعقل بالطريقة اللاهوتية الدينية ، ولكن بالطريقة البيولوجية ... وعلى الفلسفة
ألا تتجه إلى معرفة كيفية العالم الخارجي ، ولكن عليها أن تتجه إلى محاولة معرفة كيفية السيطرة عليه "
يتفق البرجماتيون على أن العقل موجه للعمل دون النظر ولابد للعقل أن ينصرف عن التفكير في المبادئ والأوليات ويتجه إلى النتائج والغايات ، ن والفكرة الصادقة عندهم هي التحقق من منفعتها عن طريق التجربة ومعنى أن توضيح أي فكرة وبيان صحتها إنما يكون بقياسها إلى آثارها العملية في حياة الإنسان ، وأن كل فكرة نهايتها لا تكون سلوك عملي في الواقع ، تعد فكرة باطلة لا معنى لها ، وبهذا ابعد البرجماتيون أية فكرة ليست واقعية ، فانصب نقدهم اللاذع على الأفكار المجردة التي تأتي بها الفلسفة التأملية أو الميتافيزيقا .
وما يمكن أن نقوله : أن الفكرة الصادقة عنهم والتي تؤدي إلى النجاح في الحياة العملية
والعقدية الصحيحة عندهم هي التي تحقق أغراض عملية نفعية في الحياى الإنسانية ، وبالتالي فهذه الأفكار والعقائد التي تكون موضع طلب إذا كانت وسائل لتحقيق أغراض واقعية ، ويصبح معيار الصواب والحق ، بالنسبة لأي فكرة ، هو مدى قابليتها بأن تكون سلوك عملي ، وكملاحظة أن البرجماتيون أخضعوا الأخلاق إلى سلوك منفعي أيضا .
فمقياس الص3واب والحق عندهم هو المنفعة أو العمل المنتج ، والمنفعة هي المعيار الوحيد الذي يقاس به صدق الأحكام وصواب الأفكار وليس العقل . ، فلا يوجد في نظرهم حق في ذاته فهو حق أجوف لا يحمل أي معنى ، لكن الحق الذي ينبغي أن يطلب هو الحق الذي يحقق بالنسبة إلى نتائجه العملية في الحياة منفعة . إن الدين عندهم لا يطلب لذاته إنما يطلب ما يؤدي في الحياة العملية من منفعة .
هذه باختصار الفلسفة البرجماتية ، وهي فلسفة لا تتوافق مع فلسفات سابقة عنها فهي تصطدم معها وخاصة فلسفة العصور الوسطى والفلسفات القديمة ، ولا تتفق في بعض جوانب الفلسفة الحديثة ، ( )
الفلسفة الماركسية :
كل المذاهب المادية هي مذاهب نقدية وثورية على الفلسفة العقلية وآخر هذه المذاهب المادية الجدلية التاريخية ، عند ماركس وأتباعه ، ففي نظر الواقعية المادية أن وجود الأشياء المادية سابق عن وجود الذات المدركة ، والعقل في نظر ها مجرد نتاج للطبيعة المادية أو هو صورة انعكاس لها ، فالمادة هي الأصل بينما العقل أو الفكر هو مجرد مظهر من مظاهرها ، والمخ يفرز الأفكار مثلما تفرز الكلية البول ... والمادة تتطور ويكون تطورها في حركة تغير مستمر ، وهذا التغير حادث نتيجة الصراع القائم بين الأضداد ، ويسمى عندهم هذا التطور والتغير للمادة بالديالكتيك ، ويراد بالماركسية التطور الذي حدث للفلسفة المثالية الهيغلية ( هيغل ) توفى 1831 م ) الذي انتهى إلى المادية الجدلية وكان من وراء هذا الاتجاه ، وكان من وراء هذا الاتجاه كارل ماركس المتوفى سنة 1883 وفردريك انجلز – المتوفى 1895 ، وتعمق وفصل فيها لينين وبخارين ، وستالين ، وغيرهم فيما بعد ..
غير أن المادية الماركسية تنسب إلى ماركس على أساس أنه صاغ الشيوعية كنظرية فلسفية ، هذا وأن الماديون الجدليون أنكروا الميتافيزيقا في كل صورها ، ويرفضون الفلسفة التقليدية ، يرى ماركس أن الفلسفة الماركسية ، أحدثت ثورة جذرية في تاريخ الفلسفة ، لأنها تختلف اختلاف كاملا ، وتتميز تميزا مطلقا عن جميع المذاهب والنظريات الفلسفية السابقة مثالية كانت أو مادية ، يقول ماركس في رسالته موضوعات عن فيور باخ : " أن الفلاسفة اكتفوا بتفسير العالم بصور مختلفة ، ولكن المشكلة ، تكمن في تغيير العالم " بمعنى أن كارل ماركس ، يزعم بقوله هذا أن فلسفته فلسفة تغيير وليس فلسفة تفكير .
ما هو معلوم أن الفلسفة الماركسية وجدت في أوربا ،÷ وهي منتوج الحضارة الغربية لأنها تعالج مشاكل الإنسان المعاصر الغربي فهي ليست إبداعا خالصا أتقدح به عقل ماركس غير أنها تطوير وتنسيق لأنساق فلسفية ، وأصول فكرية غربية خالصة وسابقة ، مثالية كانت أو مادية ، نتيجة ظروف عقلية واقتصادية واجتماعية سيطرت على الغرب في الفترة التي عاش فيها ماركس بل وفي الفترة السابقة عليه فهي " فلسفة ماركس " أمشاج وأخلاط من فكر أفلاطون وفردك وتوماس مور وكامبانلا ومورلي ، وهيغل وفيورباخ ، والنظرة اليهودية للمال والاقتصاد
وأهم الظروف التي ساعدت ماركس على وضع نظريته هي ( نظرية سياسية وفكرية ، اقتصادية اجتماعية ) بالإضافة إلى خصائص شخصيته وسماته ما يلي :
أولا : التناقضات التي جاء بها تطور النظام الرأسمالي في أوربا خلال القرن التاسع عشر بين طبقة الملاك الرأسماليين ، وطبقة العمال الكادحين
ثانيا : التطور الكبير الذي قطعه علم الطبيعة وهذا في خلال القرن التاسع عشر حيث أن علم الطبيعة لم يعد يدرس الأشياء والوقائع منفصلة بعضها عن بعض ، فتحول إلى علم نظري ، وأصبح يسعى إلى تفسير هذه الوقائع والأشياء ، وإيضاح الصلة أو العلاقة العلية بينها على أساس ديالكتيكي جدلي .
كما ساهمت مساهمة فعالة النظريات والاكتشافات الكبرى في علم الطبيعة إبان القرن التاسع عشر على تكوين النظرة المادية الجدلية إلى الطبيعة ، وهذا باكتشاف بقاء الطاقة وتحولها ، ونظرية تركيب الكائنات الحية ، من خلايا ونظرية داروين التطورية ، وقد ساعد في الغرب شعور عميق في ذلك الوقت . بوحدة العالم المادية ، وعدم فناء المادة ، وعدم فناء الحركة ، وأن الخلية كعنصر مادي هي أساس كائن معقد ، وأن الإنسان شأنه شأن كل الكائنات الحية هو نتيجة من نتائج تطور المادة الحية "
ساد هذا الاعتقاد في القرن التاسع عشر عند الغرب وهو القرن الذي عاش في ظلاله ومناخه تيارات فكرية كبرى
ثالثا : الفلسفة الألمانية في القرن التاسع عشر وبالذات فلسفة هيغل المثالية ، وفلسفة فيورباخ ( ت 1872) المادية .
رابعا : تاريخ الفلسفة بأكمله حيث قرأه ماركس واستوعب قوالبه ، ووقف عند الأفكار التي يستمد منها الشواهد على صحة آرائه الفلسفية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، والذي أساس هذا التاريخ الفلسفي في نظره على المادية الجدلية ، والمادية التاريخية .
المادية التاريخية : هي مصطلح أطلقه أنجلز على نظرية ماركس ، والتي تنص على أن الوقائع الاقتصادية هي الأصل التي تتولد عنه كل الظواهر ، أو بعبارة أخرى كل الحوادث والوقائع التاريخية والاجتماعية فالذي يحرك الإنسان في حياته عبر تاريخه هو العامل الاقتصادي المادي وهذا العامل هو الأساس ، فلا أثر لبقية العوامل الروحية والعقدية والفكرية
المادية الجدلية : هي نظرة فلسفية قامت على وجهة نظر في العالم على اعتبار أن الكون وحدة لا تتجزأ ومصادره المادة المتحركة المتطورة إلى أعلى وهي في خلال تطورها تمر بمستويات من التعقيد ، حيث يؤدي التراكم الكمي إلى تغير كيفي .
والمادية الجدلية تقوم على قوانين ثلاث ، وهذه القوانين تتحكم في عملية التغير والتطور . وهي :
1 – قانون تحول التغيرات الكمية إلى تغييرات كيفية ، مثل الماء وتعرضه إلى تغير كمي هو زيادة الحرارة يحدث عند نقطة حاسمة ، تغيير كيفي هو تحول الماء إلى بخار .
2 - قانون وحدة وصراع الأضداد ، ويفترض هذا القانون وجود التناقضات في الطبيعة .
3 – قانون نفي النفي أو سلب السلب ، وهو القانون الذي يحكم التطور في العالم فالإقطاع تنفيه الرأسمالية ، والرأسمالية تنفيها الاشتراكية ، وينشأ الجديد بناء على نفيس النفي أو على سلب السلب فهذا هو الأساس الذي زعم ماركس على ضوئه يتحقق التغير للمجتمع في صورة حضارية متطورة غايتها سعادة الإنسان .
وما يمكن أن نقوله في الأخير أن الفلسفة الماركسية :
أولا : نتاج غربي أوربي جاء علاجا لأوضاع سائدة هناك وكانت محددة في فترة زمنية بعينها وقد أثبت قصوره وفشله عند التطبيق الواقعي ، مما ظهرت التنقيحات والتعديلات لهذا النتاج الفلسفي .
ثانيا : هي فلسفة مادية في اعتقادها أن العقل صورة من صور الماد ية ، والفكر عندهم مجرد مظهر من مظاهر المادة وأسمى الأفكار وأعلاها كفكرة الألوهية لا تعد فكرة واقعية ، لأنه لا يوجد لها مقابل في عالم المادة ، وهم لا يغفلونها فحسب ، بل يقولون أنها غير موجودة أصلا فالموجودات هي انعكاسات مادية فقط ، ويرون أن الأديان خرافة وأنها أفيون الشعوب .
ثالثا : الماركسيون يهاجمون الفلسفات السابقة ، ويرون أنها نوع من التآمر الفكري الموجه ضد مصالح الطبقة العاملة . في حين أن فلسفتهم فلسفة تغير اجتماعي واقتصادي وسياسي ومنها قوانين التطور التاريخي فالمادة وحدها والصراع الاقتصادي، هما اللذان يوجهان الفكر، ويضعان حركة التطور والتغير، وحركة التاريخ.
ملاحظة : أنكر هؤلاء وجود مبادئ أخلاقية كلية ، فالأخلاق عندهم دائما ، أخلاق طبقة معينة ، وقد قدم الأستاذ د ، توفيق الطويل : دعوة يثبت فيها خطر فلسفتين لأنها متشابهتين في التنظير وهما الفلسفة الأمريكية البرجماتية ، والفلسفة الماركسية ، فلسفة الكتلة الشرقية ، فعوامل التشابه بين هاتين الفلسفتين قائمة ، ولابد من النظر في أسسهما ، وقراءة هذا الفكر الفلسفي بالنسبة للفكر العربي قراءة واعية . ( )
الوضعية الكلاسيكية ، والوضعية المنطقية :
الوضعية الكلاسيكية رائدها أوجست كونت المتوفى ( 1857 ) تؤول بعدم الاعتراف بواقع غير الواقع المحسوس ، والذي يخضع للملاحظة والتجربة ، وفي رأيها أن العلوم الجزئية القائمة على الملاحظة والتي تتبنى بالدراسة الواقع المحسوس ، أنها قطعت مجالات بحث الفلسفة القديمة ولم يعد اتصال بين الفلسفة والعلم بعد الانفصال عنه ، وإن بقي للفلسفة دور مع العلوم ف‘ن دورها بسيط لا يتجاوز النتائج التي تصل إليها هذه العلوم الجزئية ، والربط بينهما هذه الوضعية لم تعترف بغير المحسوس ، فهي ترفض الميتافيزيقا الكلاسيكية .
يزعم أصحاب هذه الوضعية ، أنهم معنيون بالكشف عن مجهول الوجود ومعرفة مكنوناته وأسراره الخفية ، ومعرفة حقيقة الموجودات ، وكنه الأشياء وفهم النفس البشرية ، وإدراك خباياها ، وقد صرح كونت أن الميتافيزيقا لم يعد لها موضوع ، وهي تمثل في تاريخ الفلسفة مرحلة تاريخية في تطور الفكر الإنساني . ويقسم كونت مراحل الفكر الإنساني إلى ثلاثة مراحل هي :
المرحلة اللاهوتية ، وهي المرحلة الأولى التي مر بها الفكر الإنساني في دورته التاريخية ، وما يميز العقل في هذه المرحلة هو توغله في البحث عن كنه الحقائق من كائنات مادية جامدة ’حية ، لمعرفة أصلها ومصيرها محاولا إرجاع كل طائفة أو مجموعة من الظواهر إلى مبدأ ميتافيزيقي غيبي ، ولكن هذا المبدأ مفارق للطبيعة ، وهذه المرحلة عنده تنقسم بدورها إلى ثلاث مراحل :
أولا : عبادة الأشياء المادية لذاتها
ثانيا : أن الآلهة متعددة وهي أكثر الدرجات الثلاث لتمييز الحالة اللاهوتية لأن في هذه المرحلة يخلع العقل ، ما كان قد خلعه ، على الأشياء المادية ، من قدرة وحياة ، ويشبه إلى قوى غير منظورة تؤلف عالما علويا مفارقة للعالم الحسي .
ثالثا ، هي الحالة التي جمع فيها العقل الآلهة المتعددة في إله واحد مفارقة ، وهي مرحلة التوحيد .
المرحلة الميتافيزيقية ، أنها المرحلة التي استمر العقل الإنساني فيها ، في البحث عن طبائع الأشياء وأصلها ومصيرها لكنه استبدل بالعلل المفارقة عللا ذاتية مباطنة للأشياء ، ونسج الخيال الإنساني معاني مجردة ، يفسر بها الأشياء كالعلة والقوة ، والجوهر ، والغاية ،
المرحلة الوضعية : هي مرحلة من مراحل تطور الفكر الإنساني ، تدرك بعد تجاوز العقل المرحلة الميتافيزيقية ، بإدراكه أنه ليس في الإمكان ، التوصل إلى معارف مطلقة فا بتعد البحث عن مبدأ العالم وغايته ، ، وعن البحث عن العلل البعيدة للأشياء ، وراح هذه المرة يستخدم الملاحظة والاستدلال معا قاصدا الكشف عن قوانين الظواهر ، أي البحث عن علاقاتها الثابتة بين الأشياء ، وتفسير الظواهر يبعضها البعض عن طريق العلاقات القاـمة فيما بينها .
إن الفلسفة الوضعية ترفض الفلسفة التقليدية القديمة ، وترى أ،ها مرحلة في تطور العقل البشري ، والعقل تجاوز هذه المرحلة ، وهي لا تقر بالدين لاعتبار أنه غير علمي ولا يخضع للملاحظة والتجربة ، وأنه فضلا عن ذلك يمثل مرحلة بدائية للعقل البشري ، وهذا العقل تطور وتقدم وتجاوز هذه المرحلة الطفولة البدائية ، ولهذا المذهب أنصار كثيرون
هذا وظهرت في ثلث القرن العشرين جماعة مولعة بالمنطق العلمي الرياضي أطلق عليهم فلاسفة الوضعية المنطقية يسلمون بما جاء به الوضعيون ويتنكرون للفلسفة التقليدية ، بل يرفضونها ، وقالوا أن الدين مرحلة تمثل طفولة العقل الإنساني وبدائيته وقد انتهت والفلسفة ما هي إلا مجرد للبحث هدفه التحليل المنطقي للغة التي يستخدمها الإنسان في حياته اليومية ، أو يستخدمها العلماء في مباحثهم العلمية رغبة في إزالة اللبس والغموض الذي يعتري الأفكار وبيان عناصرها حتى تبدوا واضحة وجلية متميزة ، والفيلسوف ، فتجنشتاين " 1951 ، عرف الفلسفة بقوله " إنها مجرد توضيح للأفكار توضيحا منطقيا " بمعنى أن الفلسفة مجرد تحليل منطقي للغة ، وهي لا تعني مطلقا البحث في حقيقة الوجود أو طبيعة المعرفة . إضافة إلى ذلك أنهم يرون أن لا موجود إلا المحسوس ، لا فكر ولا تفكير ، وكل ما هنالك ألفاظ ، وكل لفظ لا يشير إلى شيء محسوس يمكن التثبت منه بالتجربة لا يحمل معنى
الفلسفة الوجودية :
إذا كانت الفلسفة الماركسية هدفها الكشف عن قوانين تغيير المادة ، فان الفلسفة الوجودية هي منهج يصف أبعاد التجربة الذاتية الحيوية في خضم الوجود أي الوجود الشخصي الذاتي فلئن كانت الفلسفة التقليدية تهتم بالبحث في الوجود المطلق ، والتعرف على علله البعيدة ومبادئه القصوى ، وكانت تضحي بالشخص الفرد في سبيل الجماعة ، فالفلسفة الوجودية المعاصرة بالخصوص التي يمثلها مارتن هيجر وكيركجارد ،
وجان بول سارتر انحصر اهتمامها في الوجود الإنساني الواقعي المفرد
فالفيلسوف (كيركجارد) الوجودي المعاصر إن الوجود المطلق أو الوجود الفلسفي بمعناه الأرسطي ليس موضوعا للفلسفة ومن مبادئ الوجودية المعاصرة :
1- الوجود الواقعي الإنساني الشخصي (الفرد) يسبق الماهية وهم بهذا النحو الفلسفي جعلوا الفلسفي تمشي على رأسها، لأن ماهية الفلسفة التقليدية تسبق الوجود الفعلي.
2- الفلسفة ليست بحثا في المعاني المجردة ، وإنما هي بحث في المعاني الشخصية بمعنى أنها لا تبحث في المبادئ والغايات والماهيات ،بل في الذوات المتعينة .
فالحرية أو الموت ،أو الصدق ،أو الأمانة أو الفضيلة...الخ . من حيث أنها معاني مجردة فهذه لا تعتبر عند الوجوديين مشاكل فلسفية حقيقية ، فالمشاكل الحقيقية عندهم هي ،حريتي أنا وأمانتي أنا ،وموتي أنا، وفضيلتي أنا...الخ.
فأفرطت الوجودية في التركيز على الفردية الشخصية المتعينة وعلى حرية الفرد، فهي رد فعل ضد الماركسية التي اعتنت بالجماعة ، فالتركيز على المتعين الفردي في نظر الوجودية يؤدي إلى كراهة الآخرين ، والنفور منهم على اعتبار أنهم الجحيم بعينه .
وتوضيح ما سبق أن الماهية في الفلسفة الكلاسيكية وخاصة الأرسطية ، هي الصفات الجوهرية المشتركة التي تميز وتفصل أفراد نوع ما عن بقية الأنواع الأخرى مثلا نحدد ماهية الإنسان بالحيوانية والنطق فما يجعل الإنسان إنسانا ، هو كونه حيوانا ناطقا ، وأكثر الفلسفة الأرسطية أسبقية الماهية عن الوجود .
لكن الوجوديون قالوا الإنسان يوجد أولا ، ثم تتكون ماهيته بعد وجود بالفعل وثارت الوجودية على الفلسفة التقليدية وثورة مؤسسها كيركجارد (ت1855م) ضد كل الفلسفة النظرية ، وعلى الخصوص فلسفة هيغل(ت1831)
أهم أعلام هذه الفلسفة الوجودية كيركجارد- كارل ياسبرز ،جابريل مارسل مارتن هيدجر، جان بول سارتر .
هذا المذهب الفلسفي عرف تطور وغلا في تطوره فتحول إلى مذهب الحادي على يدي جان بول سارتر ،وهيدجر،وصوغ أنصار هذا المذهب في أشكال وصور أدبية متنوعة كالمسرحية والقصة والرواية مما ساعد ويسر قراءته وانتشاره.
هذا وأن أصحاب هذا الاتجاه ركزوا على أمراض النفس الإنسانية وكان تركيزهم يحمل مغالاة ومبالغة لا نكاد تجد حديثهم عن القلق و العبث واليأس ...الخ حديثا طويلا ومفصلا مما يبعث على التشاؤم وكذلك حديثهم عن ظاهرة الموت ...الخ .
فكان هذا المذهب قد أثار مشكلة أخلاقية شرسة تمثلت في قلب القيم الأخلاقية و العقائد الايمانية بل أدى إلى تغييرها وإلغائها وذلك بدعوى الحرية الشخصية التامة وهي فوق كل الدعاوي الأخلاقية من زجر ونهي وضابط وتقليد ، لان في حقيقة أمرها بمنظور الوجوديين تقييد لحرية الشخص أو الفرد.
يقول الدكتور توفيق الطويل << وللمواقف السالفة خطرها في فلسفة الوجوديين ، فإن معاناة الواقع واختباره تقضي بالإنسان لا محالة إلى الضيق والقلق والحيرة ، لأن الإنسان متى تبين موقفه من العالم ، وعرف أن وجود منته لا محالة إلى الموت ، أدركه القلق وتولاه اليأس ، ومن هنا انصرفت تأملات الوجوديين عامة إلى البحث والضيق واليأس والإخفاق و العدم والموت هو الشيء الوحيد الذي يستطيع الإنسان أن يكون على يقين من أنه ختام كل حياة ، وهو التعبير عن النقص الطبيعي الذي يعتوره ويعوقه عن تحقيق إمكاناته ، ومن هنا كان تفكيره المتواصل فيه ،ومنه انتهى إلى أن حياته فراغ وعبث وعدم >>
تعقيب :
إن هذا المذهب يتضمن في جوهره عن أغاليط لا تسلم بها فطرة العقل الإنساني ومع ذلك ،فان العقل الغربي خادع هذه الفطرة بترهاته وأبعاده عن الحق فتاه وزاغ ، وضل،وتخبط ، بأقوال التي قال بها وهي أقرب إلى الحفريات منها إلى الأفكار المعقولة
وحتى ممثلي هذا المذهب لم يتفقوا فيما بينهم فمن قال أن الوجود يسبق الماهية،ومن قال أن الوجود مساو للماهية أو هو الماهية بعينه ،ومن قال الوجود لا يحتاج إلى الماهية .
تطبيقات في مادة التيارات الفكرية
تطبيقات على الإرسال الأول :
أسئلة تحصيلية :
س 1 ما هي الخلافات السياسية حول الإمامة
س2 – عرف علم الكلام وما هو موضوعه ؟
س3 – أذكر تعريف من تعاريف علم الكلام
س3 أذكر الثقافات الأجنبية التي ساهمت في وجود علم الكلام
س4- ما مناهج علم الكلام .
س5- هل التصوف علم عند أهل الصوفية والتصوف
1- أنها لم تعمل على تحقيق السعادة .
2- لم تحقق غرضا أو مصلحة عملية للبشر لكنها ربطت نفسها بالكنيسة .
3- أصبحت الكنيسة المرجع والفيصل في البحوث الفلسفية .
4- أتسمت الكنيسة بالغموض والخلط والاضطراب . ، وكذلك فلسفة أرسطو .
لهذا الفعل الفلسفي النقدي راح ديكارت في العصر الحديث يؤسس فلسفة أساسها قائم على العلم الرياضي ، الذي يستخدم المنهج الاستنباطي في إقامة براهينه ، وفي استخلاص نظرياته ، حتى يتحقق للفلسفة ما تحقق للرياضة من دقة ويقين .
ولزاما في نظر ديكارت على الفيلسوف أـن يتعلم الرياضة ، ويبدأ منها وبهذا المنحى يعيد ديكارت إلى الأذهان ما كان مكتوبا على باب أكاديمية أفلاطون من لم يكن حاذقا في الهندسة لا يدخل علينا . وديكارت يرى أن إصلاح الفلسفة لا يكون إلا بإصلاح مناهجها ، ويقوم منهجها على أسس رياضية ، حتى تفوز بما فازت به العلوم الرياضية من الوضوح والدقة واليقين .
وللمنهج الرياضي الديكارتي خاصيتان بارزتان :
- البداهة ، بداهة الأفكار التي يستخدمها علماء الرياضة .
- والترتيب المنطقي الذي تتسلسل بمقتضاه هده الأفكار . لكن السؤال الذي يطرح هنا هو كيف تتحقق هذه البداهة الرياضية للأفكار والنظريات الفلسفية . ؟
من دون شك أن تحقيقها لا يكون إلا بتخليص تفكيرنا الفلسفي من بعض المعوقات مثل
طرح الأفكار الصادرة من السلطات المعرفية أيا كانت هذه السلطات فلسفية أو سياسية أو دينية أو كنسية ، لأنها أشد الأفكار ميلا مع الهوى . وبعدا عن اليقين .
هجر الأفكار التي يتفق حولها الجماهير لأنها ليس كثرة الأصوات التي تجتمع على رأي واحد دليلا على صحته .
ترك شهادة الحواس لأنها كثيرا ما تكون خادعة .
هجر المنطق الأرسطي كآداة للمعرفة لأن القياس الأرسطي هو صلب منطق اليونان وعموده أداة عقيمة لا توصل إلى معرفة جديدة . فهو لا يثبت لنا حقيقة معينة تندرج تحت حقيقة أخرى أعم منها ، وهو بهذا يعرقل حركة الذهن الطبيعية ، ويجعله يدور حول نفسه ... ولا يساعدنا على اكتشاف الحقائق الجديدة . والمنهج الديكارتي يقوم أساسه على ركيزتين هما الحدس ، والاستنباط .
- فالحدس هو الإدراك الذي لا يقبل الشك عن طريق العقل اليقظ وهذا الإدراك سبيله نور العقل وحده . وهو إدراك بسيط ، بمعنى غير مشوش أو مضطرب ولا يبقى نعه أي نوع من أنواع الشك ، كما قال ديكارت أنا أفكر إذن أنا موجود أو أن المثلث محاط بثلاث أضلاع فقط ، والحدس يتصور موضوعه من دون أن يصدر عليه حكما .
- الاستنباط الديكارتي هو تلك الحركة الذهنية المتصلة التي تدرك إدراكا حدسيا كل حد من حدود الاستنباط . وهو ، حركة ذهنية تسنتج بها شيئا مجهولا من شيء معلوم .
والفرق الذي يجعلنا نقيمه بين القياس الأرسطي ، والاستنباط الديكارتي هو كما يلي :
1 - القياس الأرسطي يفتح المجال للقضايا الاحتمالية والظنية بواسطة الأقيسية الخطابية والظنية واستنباط ديكارت لا يتضمن إلا القضايا اليقينية .
2- القياس الأرسطي هو رابطة بين أفكار ،بينما الاستنباط الديكارتي رابطة بين حقائق .
3- العلاقة القائمة بين الحدود تخضع لقواعد معقدة في المنطق الأرسطي ، بينما الاستنباط عند ديكارت يقوم على الحدس الذي يدرك بين الحدود التي تؤلفه إدراكا بديهيا .
4- النتيجة التي يصل إليها في القياس متضمنة في مقدماته، بينما النتيجة التي نصل فيها عن طريق الاستنباط تمثل معرفة جديدة تكتسب بالتأمل العقلي.
5 - وضمن النقد الذي صبه ديكارت على الفلسفة الأرسطية ، قدم للعقل المعرفي أربع قواعد يمكن تطبيقها على أي بحث نظري وهي :
- قاعدة اليقين ، - قاعدة التحليل ، -وقاعدة التأليف والتركيب ، - وقاعدة الاستقراء التام .
فالنزعة العقلية تنظر إلى الحقيقة على أنها حقيقة متعقلة ، وليست حقيقة عينية حسية ، ومن أعلام هذا الاتجاه إلى جانب ديكارت ليبنيتز ، وكانط ، ولوك ، وغيرهم .
ثانيا: النزعة التجريبية،
تفجرت في القرن السابع عشر ثورة علمية تحمل شعار التجريب وإعادة النظر في المعارف التي لها علاقة بدراسة الطبيعة وظواهرها وكانت على أيدي علماء كبار مثل كبلر وغاليلي ، ونيوتن ، وفرنسيس بيكون . فبيكون ( 1561م – 1626 م ) هاجم الفلسفة الكلاسيكية ، وبالأخص الأرسطية وحط من قيمتها وحملها سبب تخلف العلم أو توقف التطور العلمي ، فأصبحت الفلسفة أشبه بصنم ميت يقدس ويعبد . وسبب هذا العقم الفلسفي بدءً من سقراط إلى اللذين أنو من بعده ، لم يهتموا بدراسة الطبيعة وتفسيرها ، فاعتنوا بتسجيل هواجس و خواطر العقل ووصلوا في تقديرهم للعقل الإنساني إلى حد التقديس والعبادة . وكان تخلف العقل وعقمه في نظر بيكون هو المنهج الذي أتبع في المعرفة آنذاك فهو منهج ضال مغلوط خاطئ في البحث والنظر . ، وعليه لابد اللجوء إلى إصلاح المنهج العلمي ، ، فوضع بيكون المنهج الاستقرائي التجريبي ، وضمنه كتابه الأرغانون الجديد . وهو كتاب يمثل نقض للأرغانون الأرسطي ، ، يقول برتراندرسل : ( لقد كان بيكون أول ذلك الصف الطويل من الفلاسفة ذوي العقول العلمية ، الذين أكدوا أهمية الاستقراء كمقابل للقياس .
واجتهد بيكون في وضع قواعد منهجه الجديد فأرسى قواعده على دعامتين السلبية والإيجابية ، أما السلبية : وتعني عنده تخليص العقل الإنساني من الأوهام والتي هي :
أوهام القبيلة : وهي تلك السلبية العقلية المتأصلة في الطبيعة البشرية كالميل إلى التعميم مثلا :
أوهام الكهف : وهي الآراء الشخصية المسبقة المميزة للباحث الفرد .
أوهام السوق وهي تلك المتصلة بسوء استخدام اللغة .
أوهام المسرح وهي المتصلة بتأثير المذاهب الفلسفية والفلسفات الشائعة .
أوهام المدارس، وهي المعارف التي تتكون من الاعتقاد بأن قاعدة ما عمياء كالقياس يمكن أن تأخذ مكان الحكم في البحث .
أما الجانب الإيجابي : يتمثل في تلك القواعد الإجرائية التي ينبغي مراعاتها في البحث العلمي الاستقرائي .
فالمعرفة قوة تهدف لمعرفة الطبيعة بواسطة الاكتشافات والابتكارات العلمية .
وما يلاحظ عن فلسفة بيكون التجريبية ، أنه كان يحط من قيمة الاستنباط والرياضيات بصفة عامة ويزعم أنها غير كافية من الناحية التجريبية ،
وها هو برتراندرسل يقول " إن الدور الذي يلعبه الاستنباط في العلم أعظم مما ظن بيكون ، ففي كثير من الأحيان حين يتعذر اختيار الفرض ، فثمة رحلة استنباطية طويلة من الفرض إلى النتيجة لا يمكن اختبارها بالملاحظة ... وعادة ما يكون الاستنباط رياضيا ، وفي هذا الصدد يبخس بيكون أهمية الرياضيات في البحث العلمي " ،
تعقيب : من دون شك أن النقد الموجه للفلسفة الإغريقية المتمثلة في فلسفة أفلاطون ، وفلسفة أرسطو ، كان نقدا بناءً ، وهو الخلاص من النزعة الفكرية ، العقيمة إلى موضوع المعرفة لا من زاوية الموضوع المدروس ، وإنما زاوية الأنا العارف ، وما يتضمن من مقولات فطرية تؤسس المعرفة الذاتية ، فكانت الحاجة ماسة إلى البحث عن منهج جديد يتضمن أطر تأسيسية أخرى للمعرفة ، فوضع ديكارت أسس المنهج العقلي ، ووضع للاستنباط الرياضي مكانة ، أعلى وأسمى في مضمون هذا المنهج على حساب الحس والملاحظة والتجربة والواقع الموضوعي .
أما بيكون أسس المنهج التجريبي ووضع مكانة سامية للتجربة والاستقراء على حساب العقل الرياضي . أو الاستنباط الرياضي ، أو بتعبير آخر على حساب التأمل العقلي .
ومع هذا ظهر القصور في المنهجيين كليهما ، مما أدى إلى نوع من الصراع الفكري والمعرفي بين المذهبين : " والحق أن القرن السابع عشر بأكمله كان بمثابة نقاش وجدل بين التجريبيين والرياضيين ... واستمر الجدل بينهما حتى إسحاق نيوتن فبرهن على أن المزج بين التجريبية وبين الرياضيات أو بين الحس والعقل هو أفضل السبل ، بل أعمقها فائدة ، فالتجريبية غير الهادفة ، يمكن أن تكون عقيمة " كل من المذهب العقلي والتجريبي خلع عن نفسه اللباس المعرفي الأرسطي ، وكذلك سلطة الكنيسة ، فالعقلي سلم بالعقل ، والتجريبي سلم بالتجربة والحس والملاحظة ، مما سادت في أوساط بعض العلماء والفلاسفة موضة عارمة من الشك والإلحاد والكفر ، وإن كانت للكنيسة دور يذكر في ذلك الوقت ، وهو التذكير بكراهة العلماء للدين . والحط من شأنه ، والعمل على الكفر والإلحاد ، ولا يمنع أن الكثير من المنجزات العلمية الرائعة التي تحققت على أيدي كثير من العلماء كانوا على قدم راسخة من الإيمان . بل إدراكهم للآيات الكونية زادتهم يقينا وثباتا ومكنتهم من البحث والبحث لكثير من حقائق هذه الآيات . لكن لا يمنعنا من القول : أن الأكثرية من العلماء كانوا من وراء تحقيق قدر كبير من الإيمان .
وأحسن ما نضيفه إلى هذا التعقيب : هو قول رونالد سترومبرج : " ينبغي علينا أن نكرر القول بأن ديكارت كان يعتبر في نظر الكثيرين مجحرر الفلسفة من اللاهوت ، ومحطم التحالف بين العلم والميتافيزيقا والدين ، ذلك التحالف الذي استمسك به طويلا المشاؤون وكان أيضا واضع الفيزياء الميكانيكية حيث كانت الحاجة إلى الله تتمثل فقط في إعطائه الدفعة الأولى للكون ، وذلك منذ زمان لانهائي وسحيق في ماضيه ، وهذه فكرة شديدة الخطر من حيث أنها فكرة تخرج على الربوبية التقليدية ، ، علما أن ديكارت أستند بشدة إلى الله بوصفه الضامن لكون منتظم ، وقد وجد عدد من العباقرة ك ( باسكال ، وليبنتز ) أن نظرية ديكارت تلك تبعث على القلق ، وعدم الارتياح وهنا سنذكر الانسحاب الشهير لباسكال وتراجعه إلى الدين الصوفي ، مرعوبا من " آلة الكون " التي لا إله لها .. ومن ثم كانت هنالك حاجة إلى برهان مقنع على أن العلم الجديد لن يدمر أسس الأخلاق والنظام الاجتماعي " وموقف بيكون لم يكن أفضل من موقف ديكارت في هذا المنحى ، " إلى كانت النيوتينية تحسينا للديكارتية وتطويرا لها من حيث الإيمان بالإلوهية ، والنظرة إليها فالدور الذي أناطه ديكارت بالله كان دورا سلبيا إذ حدد وضع الإله كضامن لانتظام الكون ومعقوليته ، وسمح له فقط بأن يعطي الآلة الكونية ، الدفعة الأولى من الحركة حيث تدير فيما بعد نفسها بنفسها بعد تلك الدفعة ، ولكن آلة العلم عند إسحاق نيوتن ، تستوجب وجود الله ليتولها بعنايته ، فالله باق إلى الأبد ، وموجود في كل مكان ، وهو بوجوده الأبدي وفي كل مكان ينشئ ويعين الديمومة والمكان . "
المذهب البرجماتي :
إن هذا المذهب هو في الواقع يمثل أول إسهام في الفكر الفلسفي الأمريكي ، وهو المذهب الذي أتخذ من فكرة النجاح ، المبدأ الأساسي في فلسفته ، ويطلق في الفكر العربي إسم المذهب النفعي ، أو فلسفة العمل أو الفعل ومن وراء هذا المذهب فلاسفة وهم : تشارلز بيرس : 1839م - 1914 م ووليم جيمس 1842م – 1910م وجون ديوي 1859 1952م ، وهذا المذهب لم يكن له أتباع وأنصار أو مقتصرا على أمريكا فحسب بل كان له أنصار كثيرون في أوربا وعرف انتشار واسعا بهيمنة أمريكا على العالم في كل النواحي السياسية والاقتصادية ، والعسكرية ،
أصحاب هذا المذهب يزعمون بأنهم يغيروا العالم ويهدفون إلى تحقيق السعادة للأنسانية وهاجم هؤلاء البرجماتيون بالأخص جون ديوي الميتافيزيقا بوجه عام وكذلك الدين وكانت هذه المهاجمة مبنية على أمرين هما :
- التفكير الميتافيزيقي لا يهتم بما يتصل بسيطرة الإنسان على الطبيعة ومحاولة فهمها والاستفادة من نتائجها فالميتافيزيقا تفكير ضال فلا يسهم بأي شيء فيما أحرزه الإنسان من تقدم في مجال العلم عن طريق البحث التجريبي الاستقرائي .
- التفكير الميتافيزيقي وما يتناول من قضايا لا تهم الإنسان وخاصة في حياته الواقعية ، عاق البحث العلمي ، وصبغ الفلسفة بصبغة قطعية جامدة وأغلق عقول الناس ، وأعاقها عن البحث في العلم الطبيعي لاستخراج ما فيه من إمكانات كامنة "
إن جون ديوي يذهب كغيره من الفلاسفة التنويريين من ديكارت وفرنسيس بيكون وهوبز وسبنسر ومل أن الميتافيزيقا هي بحث في علم اللاهوت وهي مظهر من مظاهره لذلك في رأي جون ديوي أن المشكلة الأساسية في الفلسفة وبالأخص أن الميتافيزيقا سمحت لمباحثها أن تختلط بالمباحث الدينية ، فيقول: " عندما كنت أقرأ أفلاطون رأيت الفلسفة ، تسير سيرا طبيعيا ‘لى أساس سياسي يستهدف تنظيم مجتمع عادل ... ولكنها سرعان ما ضلت في أحلام العالم الآخر ... ولن يبدأ العصر الحديث إلا إذا تبنى الإنسان وجهة النظر الطبيعية في كل الميادين إن هذا لا يعني الهبوط بالعقل ... ولكنه يعني أن لا تفهم الحياة والعقل بالطريقة اللاهوتية الدينية ، ولكن بالطريقة البيولوجية ... وعلى الفلسفة
ألا تتجه إلى معرفة كيفية العالم الخارجي ، ولكن عليها أن تتجه إلى محاولة معرفة كيفية السيطرة عليه "
يتفق البرجماتيون على أن العقل موجه للعمل دون النظر ولابد للعقل أن ينصرف عن التفكير في المبادئ والأوليات ويتجه إلى النتائج والغايات ، ن والفكرة الصادقة عندهم هي التحقق من منفعتها عن طريق التجربة ومعنى أن توضيح أي فكرة وبيان صحتها إنما يكون بقياسها إلى آثارها العملية في حياة الإنسان ، وأن كل فكرة نهايتها لا تكون سلوك عملي في الواقع ، تعد فكرة باطلة لا معنى لها ، وبهذا ابعد البرجماتيون أية فكرة ليست واقعية ، فانصب نقدهم اللاذع على الأفكار المجردة التي تأتي بها الفلسفة التأملية أو الميتافيزيقا .
وما يمكن أن نقوله : أن الفكرة الصادقة عنهم والتي تؤدي إلى النجاح في الحياة العملية
والعقدية الصحيحة عندهم هي التي تحقق أغراض عملية نفعية في الحياى الإنسانية ، وبالتالي فهذه الأفكار والعقائد التي تكون موضع طلب إذا كانت وسائل لتحقيق أغراض واقعية ، ويصبح معيار الصواب والحق ، بالنسبة لأي فكرة ، هو مدى قابليتها بأن تكون سلوك عملي ، وكملاحظة أن البرجماتيون أخضعوا الأخلاق إلى سلوك منفعي أيضا .
فمقياس الص3واب والحق عندهم هو المنفعة أو العمل المنتج ، والمنفعة هي المعيار الوحيد الذي يقاس به صدق الأحكام وصواب الأفكار وليس العقل . ، فلا يوجد في نظرهم حق في ذاته فهو حق أجوف لا يحمل أي معنى ، لكن الحق الذي ينبغي أن يطلب هو الحق الذي يحقق بالنسبة إلى نتائجه العملية في الحياة منفعة . إن الدين عندهم لا يطلب لذاته إنما يطلب ما يؤدي في الحياة العملية من منفعة .
هذه باختصار الفلسفة البرجماتية ، وهي فلسفة لا تتوافق مع فلسفات سابقة عنها فهي تصطدم معها وخاصة فلسفة العصور الوسطى والفلسفات القديمة ، ولا تتفق في بعض جوانب الفلسفة الحديثة ، ( )
الفلسفة الماركسية :
كل المذاهب المادية هي مذاهب نقدية وثورية على الفلسفة العقلية وآخر هذه المذاهب المادية الجدلية التاريخية ، عند ماركس وأتباعه ، ففي نظر الواقعية المادية أن وجود الأشياء المادية سابق عن وجود الذات المدركة ، والعقل في نظر ها مجرد نتاج للطبيعة المادية أو هو صورة انعكاس لها ، فالمادة هي الأصل بينما العقل أو الفكر هو مجرد مظهر من مظاهرها ، والمخ يفرز الأفكار مثلما تفرز الكلية البول ... والمادة تتطور ويكون تطورها في حركة تغير مستمر ، وهذا التغير حادث نتيجة الصراع القائم بين الأضداد ، ويسمى عندهم هذا التطور والتغير للمادة بالديالكتيك ، ويراد بالماركسية التطور الذي حدث للفلسفة المثالية الهيغلية ( هيغل ) توفى 1831 م ) الذي انتهى إلى المادية الجدلية وكان من وراء هذا الاتجاه ، وكان من وراء هذا الاتجاه كارل ماركس المتوفى سنة 1883 وفردريك انجلز – المتوفى 1895 ، وتعمق وفصل فيها لينين وبخارين ، وستالين ، وغيرهم فيما بعد ..
غير أن المادية الماركسية تنسب إلى ماركس على أساس أنه صاغ الشيوعية كنظرية فلسفية ، هذا وأن الماديون الجدليون أنكروا الميتافيزيقا في كل صورها ، ويرفضون الفلسفة التقليدية ، يرى ماركس أن الفلسفة الماركسية ، أحدثت ثورة جذرية في تاريخ الفلسفة ، لأنها تختلف اختلاف كاملا ، وتتميز تميزا مطلقا عن جميع المذاهب والنظريات الفلسفية السابقة مثالية كانت أو مادية ، يقول ماركس في رسالته موضوعات عن فيور باخ : " أن الفلاسفة اكتفوا بتفسير العالم بصور مختلفة ، ولكن المشكلة ، تكمن في تغيير العالم " بمعنى أن كارل ماركس ، يزعم بقوله هذا أن فلسفته فلسفة تغيير وليس فلسفة تفكير .
ما هو معلوم أن الفلسفة الماركسية وجدت في أوربا ،÷ وهي منتوج الحضارة الغربية لأنها تعالج مشاكل الإنسان المعاصر الغربي فهي ليست إبداعا خالصا أتقدح به عقل ماركس غير أنها تطوير وتنسيق لأنساق فلسفية ، وأصول فكرية غربية خالصة وسابقة ، مثالية كانت أو مادية ، نتيجة ظروف عقلية واقتصادية واجتماعية سيطرت على الغرب في الفترة التي عاش فيها ماركس بل وفي الفترة السابقة عليه فهي " فلسفة ماركس " أمشاج وأخلاط من فكر أفلاطون وفردك وتوماس مور وكامبانلا ومورلي ، وهيغل وفيورباخ ، والنظرة اليهودية للمال والاقتصاد
وأهم الظروف التي ساعدت ماركس على وضع نظريته هي ( نظرية سياسية وفكرية ، اقتصادية اجتماعية ) بالإضافة إلى خصائص شخصيته وسماته ما يلي :
أولا : التناقضات التي جاء بها تطور النظام الرأسمالي في أوربا خلال القرن التاسع عشر بين طبقة الملاك الرأسماليين ، وطبقة العمال الكادحين
ثانيا : التطور الكبير الذي قطعه علم الطبيعة وهذا في خلال القرن التاسع عشر حيث أن علم الطبيعة لم يعد يدرس الأشياء والوقائع منفصلة بعضها عن بعض ، فتحول إلى علم نظري ، وأصبح يسعى إلى تفسير هذه الوقائع والأشياء ، وإيضاح الصلة أو العلاقة العلية بينها على أساس ديالكتيكي جدلي .
كما ساهمت مساهمة فعالة النظريات والاكتشافات الكبرى في علم الطبيعة إبان القرن التاسع عشر على تكوين النظرة المادية الجدلية إلى الطبيعة ، وهذا باكتشاف بقاء الطاقة وتحولها ، ونظرية تركيب الكائنات الحية ، من خلايا ونظرية داروين التطورية ، وقد ساعد في الغرب شعور عميق في ذلك الوقت . بوحدة العالم المادية ، وعدم فناء المادة ، وعدم فناء الحركة ، وأن الخلية كعنصر مادي هي أساس كائن معقد ، وأن الإنسان شأنه شأن كل الكائنات الحية هو نتيجة من نتائج تطور المادة الحية "
ساد هذا الاعتقاد في القرن التاسع عشر عند الغرب وهو القرن الذي عاش في ظلاله ومناخه تيارات فكرية كبرى
ثالثا : الفلسفة الألمانية في القرن التاسع عشر وبالذات فلسفة هيغل المثالية ، وفلسفة فيورباخ ( ت 1872) المادية .
رابعا : تاريخ الفلسفة بأكمله حيث قرأه ماركس واستوعب قوالبه ، ووقف عند الأفكار التي يستمد منها الشواهد على صحة آرائه الفلسفية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، والذي أساس هذا التاريخ الفلسفي في نظره على المادية الجدلية ، والمادية التاريخية .
المادية التاريخية : هي مصطلح أطلقه أنجلز على نظرية ماركس ، والتي تنص على أن الوقائع الاقتصادية هي الأصل التي تتولد عنه كل الظواهر ، أو بعبارة أخرى كل الحوادث والوقائع التاريخية والاجتماعية فالذي يحرك الإنسان في حياته عبر تاريخه هو العامل الاقتصادي المادي وهذا العامل هو الأساس ، فلا أثر لبقية العوامل الروحية والعقدية والفكرية
المادية الجدلية : هي نظرة فلسفية قامت على وجهة نظر في العالم على اعتبار أن الكون وحدة لا تتجزأ ومصادره المادة المتحركة المتطورة إلى أعلى وهي في خلال تطورها تمر بمستويات من التعقيد ، حيث يؤدي التراكم الكمي إلى تغير كيفي .
والمادية الجدلية تقوم على قوانين ثلاث ، وهذه القوانين تتحكم في عملية التغير والتطور . وهي :
1 – قانون تحول التغيرات الكمية إلى تغييرات كيفية ، مثل الماء وتعرضه إلى تغير كمي هو زيادة الحرارة يحدث عند نقطة حاسمة ، تغيير كيفي هو تحول الماء إلى بخار .
2 - قانون وحدة وصراع الأضداد ، ويفترض هذا القانون وجود التناقضات في الطبيعة .
3 – قانون نفي النفي أو سلب السلب ، وهو القانون الذي يحكم التطور في العالم فالإقطاع تنفيه الرأسمالية ، والرأسمالية تنفيها الاشتراكية ، وينشأ الجديد بناء على نفيس النفي أو على سلب السلب فهذا هو الأساس الذي زعم ماركس على ضوئه يتحقق التغير للمجتمع في صورة حضارية متطورة غايتها سعادة الإنسان .
وما يمكن أن نقوله في الأخير أن الفلسفة الماركسية :
أولا : نتاج غربي أوربي جاء علاجا لأوضاع سائدة هناك وكانت محددة في فترة زمنية بعينها وقد أثبت قصوره وفشله عند التطبيق الواقعي ، مما ظهرت التنقيحات والتعديلات لهذا النتاج الفلسفي .
ثانيا : هي فلسفة مادية في اعتقادها أن العقل صورة من صور الماد ية ، والفكر عندهم مجرد مظهر من مظاهر المادة وأسمى الأفكار وأعلاها كفكرة الألوهية لا تعد فكرة واقعية ، لأنه لا يوجد لها مقابل في عالم المادة ، وهم لا يغفلونها فحسب ، بل يقولون أنها غير موجودة أصلا فالموجودات هي انعكاسات مادية فقط ، ويرون أن الأديان خرافة وأنها أفيون الشعوب .
ثالثا : الماركسيون يهاجمون الفلسفات السابقة ، ويرون أنها نوع من التآمر الفكري الموجه ضد مصالح الطبقة العاملة . في حين أن فلسفتهم فلسفة تغير اجتماعي واقتصادي وسياسي ومنها قوانين التطور التاريخي فالمادة وحدها والصراع الاقتصادي، هما اللذان يوجهان الفكر، ويضعان حركة التطور والتغير، وحركة التاريخ.
ملاحظة : أنكر هؤلاء وجود مبادئ أخلاقية كلية ، فالأخلاق عندهم دائما ، أخلاق طبقة معينة ، وقد قدم الأستاذ د ، توفيق الطويل : دعوة يثبت فيها خطر فلسفتين لأنها متشابهتين في التنظير وهما الفلسفة الأمريكية البرجماتية ، والفلسفة الماركسية ، فلسفة الكتلة الشرقية ، فعوامل التشابه بين هاتين الفلسفتين قائمة ، ولابد من النظر في أسسهما ، وقراءة هذا الفكر الفلسفي بالنسبة للفكر العربي قراءة واعية . ( )
الوضعية الكلاسيكية ، والوضعية المنطقية :
الوضعية الكلاسيكية رائدها أوجست كونت المتوفى ( 1857 ) تؤول بعدم الاعتراف بواقع غير الواقع المحسوس ، والذي يخضع للملاحظة والتجربة ، وفي رأيها أن العلوم الجزئية القائمة على الملاحظة والتي تتبنى بالدراسة الواقع المحسوس ، أنها قطعت مجالات بحث الفلسفة القديمة ولم يعد اتصال بين الفلسفة والعلم بعد الانفصال عنه ، وإن بقي للفلسفة دور مع العلوم ف‘ن دورها بسيط لا يتجاوز النتائج التي تصل إليها هذه العلوم الجزئية ، والربط بينهما هذه الوضعية لم تعترف بغير المحسوس ، فهي ترفض الميتافيزيقا الكلاسيكية .
يزعم أصحاب هذه الوضعية ، أنهم معنيون بالكشف عن مجهول الوجود ومعرفة مكنوناته وأسراره الخفية ، ومعرفة حقيقة الموجودات ، وكنه الأشياء وفهم النفس البشرية ، وإدراك خباياها ، وقد صرح كونت أن الميتافيزيقا لم يعد لها موضوع ، وهي تمثل في تاريخ الفلسفة مرحلة تاريخية في تطور الفكر الإنساني . ويقسم كونت مراحل الفكر الإنساني إلى ثلاثة مراحل هي :
المرحلة اللاهوتية ، وهي المرحلة الأولى التي مر بها الفكر الإنساني في دورته التاريخية ، وما يميز العقل في هذه المرحلة هو توغله في البحث عن كنه الحقائق من كائنات مادية جامدة ’حية ، لمعرفة أصلها ومصيرها محاولا إرجاع كل طائفة أو مجموعة من الظواهر إلى مبدأ ميتافيزيقي غيبي ، ولكن هذا المبدأ مفارق للطبيعة ، وهذه المرحلة عنده تنقسم بدورها إلى ثلاث مراحل :
أولا : عبادة الأشياء المادية لذاتها
ثانيا : أن الآلهة متعددة وهي أكثر الدرجات الثلاث لتمييز الحالة اللاهوتية لأن في هذه المرحلة يخلع العقل ، ما كان قد خلعه ، على الأشياء المادية ، من قدرة وحياة ، ويشبه إلى قوى غير منظورة تؤلف عالما علويا مفارقة للعالم الحسي .
ثالثا ، هي الحالة التي جمع فيها العقل الآلهة المتعددة في إله واحد مفارقة ، وهي مرحلة التوحيد .
المرحلة الميتافيزيقية ، أنها المرحلة التي استمر العقل الإنساني فيها ، في البحث عن طبائع الأشياء وأصلها ومصيرها لكنه استبدل بالعلل المفارقة عللا ذاتية مباطنة للأشياء ، ونسج الخيال الإنساني معاني مجردة ، يفسر بها الأشياء كالعلة والقوة ، والجوهر ، والغاية ،
المرحلة الوضعية : هي مرحلة من مراحل تطور الفكر الإنساني ، تدرك بعد تجاوز العقل المرحلة الميتافيزيقية ، بإدراكه أنه ليس في الإمكان ، التوصل إلى معارف مطلقة فا بتعد البحث عن مبدأ العالم وغايته ، ، وعن البحث عن العلل البعيدة للأشياء ، وراح هذه المرة يستخدم الملاحظة والاستدلال معا قاصدا الكشف عن قوانين الظواهر ، أي البحث عن علاقاتها الثابتة بين الأشياء ، وتفسير الظواهر يبعضها البعض عن طريق العلاقات القاـمة فيما بينها .
إن الفلسفة الوضعية ترفض الفلسفة التقليدية القديمة ، وترى أ،ها مرحلة في تطور العقل البشري ، والعقل تجاوز هذه المرحلة ، وهي لا تقر بالدين لاعتبار أنه غير علمي ولا يخضع للملاحظة والتجربة ، وأنه فضلا عن ذلك يمثل مرحلة بدائية للعقل البشري ، وهذا العقل تطور وتقدم وتجاوز هذه المرحلة الطفولة البدائية ، ولهذا المذهب أنصار كثيرون
هذا وظهرت في ثلث القرن العشرين جماعة مولعة بالمنطق العلمي الرياضي أطلق عليهم فلاسفة الوضعية المنطقية يسلمون بما جاء به الوضعيون ويتنكرون للفلسفة التقليدية ، بل يرفضونها ، وقالوا أن الدين مرحلة تمثل طفولة العقل الإنساني وبدائيته وقد انتهت والفلسفة ما هي إلا مجرد للبحث هدفه التحليل المنطقي للغة التي يستخدمها الإنسان في حياته اليومية ، أو يستخدمها العلماء في مباحثهم العلمية رغبة في إزالة اللبس والغموض الذي يعتري الأفكار وبيان عناصرها حتى تبدوا واضحة وجلية متميزة ، والفيلسوف ، فتجنشتاين " 1951 ، عرف الفلسفة بقوله " إنها مجرد توضيح للأفكار توضيحا منطقيا " بمعنى أن الفلسفة مجرد تحليل منطقي للغة ، وهي لا تعني مطلقا البحث في حقيقة الوجود أو طبيعة المعرفة . إضافة إلى ذلك أنهم يرون أن لا موجود إلا المحسوس ، لا فكر ولا تفكير ، وكل ما هنالك ألفاظ ، وكل لفظ لا يشير إلى شيء محسوس يمكن التثبت منه بالتجربة لا يحمل معنى
الفلسفة الوجودية :
إذا كانت الفلسفة الماركسية هدفها الكشف عن قوانين تغيير المادة ، فان الفلسفة الوجودية هي منهج يصف أبعاد التجربة الذاتية الحيوية في خضم الوجود أي الوجود الشخصي الذاتي فلئن كانت الفلسفة التقليدية تهتم بالبحث في الوجود المطلق ، والتعرف على علله البعيدة ومبادئه القصوى ، وكانت تضحي بالشخص الفرد في سبيل الجماعة ، فالفلسفة الوجودية المعاصرة بالخصوص التي يمثلها مارتن هيجر وكيركجارد ،
وجان بول سارتر انحصر اهتمامها في الوجود الإنساني الواقعي المفرد
فالفيلسوف (كيركجارد) الوجودي المعاصر إن الوجود المطلق أو الوجود الفلسفي بمعناه الأرسطي ليس موضوعا للفلسفة ومن مبادئ الوجودية المعاصرة :
1- الوجود الواقعي الإنساني الشخصي (الفرد) يسبق الماهية وهم بهذا النحو الفلسفي جعلوا الفلسفي تمشي على رأسها، لأن ماهية الفلسفة التقليدية تسبق الوجود الفعلي.
2- الفلسفة ليست بحثا في المعاني المجردة ، وإنما هي بحث في المعاني الشخصية بمعنى أنها لا تبحث في المبادئ والغايات والماهيات ،بل في الذوات المتعينة .
فالحرية أو الموت ،أو الصدق ،أو الأمانة أو الفضيلة...الخ . من حيث أنها معاني مجردة فهذه لا تعتبر عند الوجوديين مشاكل فلسفية حقيقية ، فالمشاكل الحقيقية عندهم هي ،حريتي أنا وأمانتي أنا ،وموتي أنا، وفضيلتي أنا...الخ.
فأفرطت الوجودية في التركيز على الفردية الشخصية المتعينة وعلى حرية الفرد، فهي رد فعل ضد الماركسية التي اعتنت بالجماعة ، فالتركيز على المتعين الفردي في نظر الوجودية يؤدي إلى كراهة الآخرين ، والنفور منهم على اعتبار أنهم الجحيم بعينه .
وتوضيح ما سبق أن الماهية في الفلسفة الكلاسيكية وخاصة الأرسطية ، هي الصفات الجوهرية المشتركة التي تميز وتفصل أفراد نوع ما عن بقية الأنواع الأخرى مثلا نحدد ماهية الإنسان بالحيوانية والنطق فما يجعل الإنسان إنسانا ، هو كونه حيوانا ناطقا ، وأكثر الفلسفة الأرسطية أسبقية الماهية عن الوجود .
لكن الوجوديون قالوا الإنسان يوجد أولا ، ثم تتكون ماهيته بعد وجود بالفعل وثارت الوجودية على الفلسفة التقليدية وثورة مؤسسها كيركجارد (ت1855م) ضد كل الفلسفة النظرية ، وعلى الخصوص فلسفة هيغل(ت1831)
أهم أعلام هذه الفلسفة الوجودية كيركجارد- كارل ياسبرز ،جابريل مارسل مارتن هيدجر، جان بول سارتر .
هذا المذهب الفلسفي عرف تطور وغلا في تطوره فتحول إلى مذهب الحادي على يدي جان بول سارتر ،وهيدجر،وصوغ أنصار هذا المذهب في أشكال وصور أدبية متنوعة كالمسرحية والقصة والرواية مما ساعد ويسر قراءته وانتشاره.
هذا وأن أصحاب هذا الاتجاه ركزوا على أمراض النفس الإنسانية وكان تركيزهم يحمل مغالاة ومبالغة لا نكاد تجد حديثهم عن القلق و العبث واليأس ...الخ حديثا طويلا ومفصلا مما يبعث على التشاؤم وكذلك حديثهم عن ظاهرة الموت ...الخ .
فكان هذا المذهب قد أثار مشكلة أخلاقية شرسة تمثلت في قلب القيم الأخلاقية و العقائد الايمانية بل أدى إلى تغييرها وإلغائها وذلك بدعوى الحرية الشخصية التامة وهي فوق كل الدعاوي الأخلاقية من زجر ونهي وضابط وتقليد ، لان في حقيقة أمرها بمنظور الوجوديين تقييد لحرية الشخص أو الفرد.
يقول الدكتور توفيق الطويل << وللمواقف السالفة خطرها في فلسفة الوجوديين ، فإن معاناة الواقع واختباره تقضي بالإنسان لا محالة إلى الضيق والقلق والحيرة ، لأن الإنسان متى تبين موقفه من العالم ، وعرف أن وجود منته لا محالة إلى الموت ، أدركه القلق وتولاه اليأس ، ومن هنا انصرفت تأملات الوجوديين عامة إلى البحث والضيق واليأس والإخفاق و العدم والموت هو الشيء الوحيد الذي يستطيع الإنسان أن يكون على يقين من أنه ختام كل حياة ، وهو التعبير عن النقص الطبيعي الذي يعتوره ويعوقه عن تحقيق إمكاناته ، ومن هنا كان تفكيره المتواصل فيه ،ومنه انتهى إلى أن حياته فراغ وعبث وعدم >>
تعقيب :
إن هذا المذهب يتضمن في جوهره عن أغاليط لا تسلم بها فطرة العقل الإنساني ومع ذلك ،فان العقل الغربي خادع هذه الفطرة بترهاته وأبعاده عن الحق فتاه وزاغ ، وضل،وتخبط ، بأقوال التي قال بها وهي أقرب إلى الحفريات منها إلى الأفكار المعقولة
وحتى ممثلي هذا المذهب لم يتفقوا فيما بينهم فمن قال أن الوجود يسبق الماهية،ومن قال أن الوجود مساو للماهية أو هو الماهية بعينه ،ومن قال الوجود لا يحتاج إلى الماهية .
تطبيقات في مادة التيارات الفكرية
تطبيقات على الإرسال الأول :
أسئلة تحصيلية :
س 1 ما هي الخلافات السياسية حول الإمامة
س2 – عرف علم الكلام وما هو موضوعه ؟
س3 – أذكر تعريف من تعاريف علم الكلام
س3 أذكر الثقافات الأجنبية التي ساهمت في وجود علم الكلام
س4- ما مناهج علم الكلام .
س5- هل التصوف علم عند أهل الصوفية والتصوف

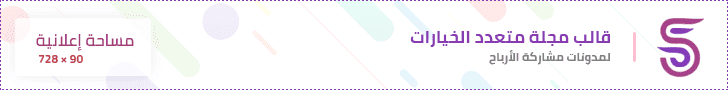
إرسال تعليق