د.يوسف بكّار
(1)
فإنّها لقديمة علاقة محمد مهدي الجواهري بمصر، إذ بدأت في الربع الأول من القرن العشرين من خلال مجلتي «الهلال» و «المقتطف»؛ فسبقت، بهذا، مصرياتُه الثقافيّة مصرياتِه السياسيّة. ولقد قال، وهو يطأ أرض الكنانة العام 1992 بعد انقطاع واحدٍ وعشرين عاماً عنها، قادماً من «براغ» ملبيّاً دعوة مجلة «الهلال» للمشاركة في احتفاليتها المئوية: «أنا سعيد بأن آتي من أجل (الهلال) الذي كتبت فيه في العشرينيّات. وكان هذا شرفاً لي أنْ أكتب ضمن الصّفوة من كبار المفكرين العرب، وآتي اليوم لأردّ الدّيْن ل (الهلال) الذي تربيّنا على ما يضمّه من ثقافة وفكر مستنير».
من الطريف اللافت أنه دعا العام 1925، وهو في ميعة الصِّبا، إلى أن تؤلَّف «محكمة» من الأدباء تحاسب أهل الأدب والسلطة السياسيّة. وقد ندب لها أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، وبعث إليهما في القاهرة الدعوة الشعريّة الآتية لينظرا فيها:
لكما الخَيار إذا الرّجال تنافسوا
أو حرّروا دعوى بلا مِصْداقِ
أن تقتلا أو تُحرقا مُتشاعراً
أو تَقْطعا يدَ شاعرٍ سرّاق
هل تحكمان اليوم حكماً عادلاً
خُلواً من الإرهاب والإشفاق
في شاعرٍ لزم البيوت وأخفقت
منه المآرب أيّما إخفاق؟
لكما شكا ظلمَ العراق، وذِلّةٌ
أن يشتكي ظلمَ العراقِ عراقي».
والتفت الجواهري إلى مصر ولسانيها الناطقين، أيضاً، العام 1931 حين قدمت بعثة الجامعة المصريّة إلى العراق، إذ حيّاها بقصيدة «إلى البعثة المصريّة» التي مطلعها:
«رُسل الثقافة من مُضَرْ
وجه العراق بكم سَفَرْ».
واهتبلها فرصةً لمسامرة شعريّة مع البعثة هدفَ من ورائها أن يوازن موازنة هزليّة جديّة تقرّ بفضل مصر الأدبي، وتوازن بين وضع الشاعر وعيشه في البلدين آنذاك متخذاً من شوقي وحافظ نموذجاً بأسلوب تلقائي مباشر يشفّ عن سمات شعره في بداياته الإبداعيّة، وعن تطلّعاته الاجتماعيّة:
«وإذا أردتمْ أن أُسا
مركُمْ، فقد لذّ السَّمرْ
عن نهضةٍ في مهدها
ما إنْ لها عنكمْ مَفَرّْ
لولاكمُ ما كان للش
عراء فينا من أَثَرْ
قُبر الأديب الألمعيّ
هنا وفي (مِصْرَ) انتشرْ
الله يجزي مَنْ أَفا
دَ ومن أعان ومن نَشَرْ
إنّي أُسائِلُكمْ وأع
لم بالجواب المنتظر:
هل تقبلون بأن يُقا
ل: أديبُ مصرَ قد افتقر؟!
أو أنّ (شوقي) من حرا
جةِ عيشه كالمُحْتضَرْ؟
أو أن (حافظَ) قد هوى
فتجاوبون: إلى سَقَرْ
حاشا، فتلك خطيئةٌ
وجريمة لا تُغْتفر
(شوقي) يعيش كما يلي
قُ بمن تفكّر أو شَعَرْ
وَسَطَ القصور العامرا
تِ وبين فائحة الزَّهَر
برعاية الوطن الأعزّ
وَغيْرة الملك الأبَر
وتحوط (إبراهيمَ) عا
طِفَةُ الأمير من الصِّغَر
أمّا هنا فالشعر شيْ
ءٌ للتملّح يُدَخّر
وعلى السواءِ أغاب شا
عرنا المجوِّد أم حَضَر!
سَقَطُ المتاعِ وجُوده
عند الضرورة يُدّكَر
في كلّ زاويةٍ أدي
بٌ بالخمول قد استتر
وقريحةٌ حسدوا عليْ
ها ما تجودُ فلم تُثَرْ».
وتلا هذه القصيدة مباشرة قصيدته «حافظ إبراهيم» التي نظمها في وفاة حافظ، ونُشرت في 22 آب 1932، ثم قصيدته «أحمد شوقي» التي أنشدها في الحفل التأبينيّ الذي أقامته الدائرة العربيّة في المدرسة الأميركيّة ببغداد في 11 تشرين الثاني 1932.
وفي العام 1936 نشر الجواهري قصيدته «المازنيّ وداغِر» التي أنشدها في الحفلة التي أقامها «رَفائيل بطيّ» صاحب صحيفة «البلاد» العراقيّة لإبراهيم عبد القادر المازنيّ وأسعد خليل داغِر اللبناني، والتي بدأها بقوله:
«رَفَائيل.. دارُك قد أشرقتْ
بأسعدَ داغِرَ والمازني
بفَذٍّ يُناضل عن أُمَةٍ
وفَذٍ لآدابها حاضنِ».
وأشاد فيها بالمازني، وردّ على ما قاله في نفسه:
«انظر إلى وجهي القبيح الشئيم
تَحْمَدْ على وجهك ربَّ الفنونِ
تعْلمْ بأن الله ما صاغني
كذاك إلاّ رغبةً في المجون».
ردّ بقوله على وزن قصيدة المازني ورويّها:
«على حينِ قد وضَحَ المازني
وضُوح السماوات للكاهنِ
نظرتُ بعينيك إذْ يَشْرُدانِ
ووجهكَ ذي الدَّعَةِ الآمنِ
فأنكرتُ قولك: ما صاغني
قبيحاً سوى عَبَثِ الماجن
وطالعتُ آثارَك النّاطقاتِ
بما فيك من جوهرٍ كامن
وظاهرَ لفْظٍ رقيق الرُّواء
لطيفٍ يدُلُّ على الباطن».
ونظم العام 1936، كذلك، قصيدته «سرْ في جهادك» إثر فوز حزب الوفد المصري بالانتخابات وتوليه السلطة، وإلغاء حكومة الوفد المعاهدةَ المصريّة البريطانية. وهي ممّا عارض فيه مبكّراً همزيّة شوقي النبويّة.
وتوّج الجواهري عرى آصرته بمصر بتعرفه، شخصيّاً، على طه حسين بدمشق العام 1944 في مهرجان «ذكرى أبي العلاء»، حيث نظم قصيدته «أُحيّيك طه»، وألقاها في المأدبة التي أقامها طه حسين للوفود المشاركة، وبدأها:
«أُحيّيكَ طه لا أُطيل بِكَ السَّجْعا
كفى السَّجْعُ فخراً محضُ اسمك إذْ تُدْعى
أُحيّيك فذّاً في دمشقَ وقبْلَها
ببغدادَ قد حَيّيْتُ أفذاذكم جَمْعا».
ونهض طه حسين، بعد فراغ الجواهري من إلقاء القصيدة، وتحدث عنه وعنها مفتتحاً كلامه بالحديث النبوي «إنّ من البيان لسحرا، وإنّ من الشعر لحكمة».
قد تكون هذه الصّلة هي التي حملت الجواهري على أنْ يفكّر في الهجرة إلى مصر العام 1950 منتهزاً الدعوة الخاصّة التي وُجّهت إليه، خارج نطاق الوفد العراقيّ الرسميّ، لحضور المؤتمر الثقافي لجامعة الدول العربيّة بالإسكندريّة حيث ألقى قصيدته «إلى الشعب المصري» في الحفلة التي أقامها طه حسين، أيضاً، للوفود المشاركة. مطلع القصيدة التي بناها على قصيدة لشاعره الأثير البحتري وزناً وقافية، وعلى رائيّة عمر ابن أبي ربيعة المعروفة، هو:
«يا مصرُ تستبقُ الدُّهور وتَعْثُرُ
والنيل يزخرُ والمِسلَّةُ تُزْهِرُ».
وفيها:
«أنا ضيفُ مصرَ، وضيفُ طه ضيفُها
ما بعد ذلك للمُفَاخِر مَفْخَرُ
أنا ضيفُ مصرَ، فلن أُثقِّل فوقَها
ظِلّي بمألُكةٍ تُعاب وتُنْكَر».
فأمّا قصيدة البحتري فمشهورة، هي التي مدح بها المتوكّل ووصف خروجه يوم عيد الفطر، ومطلعها:
«أُخفي هوىً لكَ في الضلوع وأُظْهِرُ
وأُلام في كَمَدٍ عليك وأُعْذَرُ».
أما قصيدة عمر فمشهورة كذلك، ومطلعها:
«أمن آل نُعْمٍ أنتَ غادٍ فَمُبْكِرُ
غداةَ غدٍ أم رائحٌ فمُهَجِّرُ؟!».
وبعد أن فرغ الجواهري من إلقاء قصيدته ارتجل طه حسين خطاباً نوّه فيه بالشاعر وشعره، وبالشعب العراقي. بيد أن القصيدة سدّت باب العودة في وجه صاحبها إلى العراق، لأنه فضح فيها سوءات الحكم وممارساته فيه آنذاك، وهو ما حدا بالحكومة المصريّة، بمبادرة من طه حسين، أن ترحّب بالجواهري ضيفاً عليها، وتتكفّل به وبتعليم أبنائه، وإن لم تطل إقامته بمصر، التي عاد إليها ثانية العام 1951 بعد أن ضيّقت الحكومة العراقية الخناق عليه لنشره العام 1950 قصيدته «عبد الحميد كرامي» التي ألقاها في حفل تأبين عبد الحميد كرامي ببيروت، فكان لها صدى بالغٌ في لبنان والعراق ثمّ مصر، ومطلعها:
«باقٍ -وأعمارُ الطُّغاة قِصارُ-
من سِفْر مجدك عاطرٌ موّارُ».
ولنشره العام 1951 قصيدته المدويّة «تنويمة الجياع»:
«نامي جياعَ الشّعبِ نامي
حَرَسْتكِ آلهة الطّعام
نامي فإنْ لم تشْبعي
من يَقَظةٍ فمن المنام».
غير أنّه كاد يُمنع من دخول مصر هذه المرّة، لولا تدخل طه حسين بالسماح له بدخولها، لأسباب قد يكون أحدها لوحاتٍ حملها معه تمثّل شعارات للسلام العالمي الذي كان محظوراً، حينئذٍ، في مصر والوطن العربي، وكانت أُهديت له في دمشق التي جاء منها مباشرة إلى القاهرة.
ونظم، في خلال إقامته الثانية، قصيدته «الدّم الغالي» بمناسبة هبوب المقاومة المصريّة الشعبيّة المسلّحة على الاحتلال العسكري البريطاني المتمثّل بقواعده العسكريّة في السويس والإسماعيليّة:
«خلّي الدّمَ الغالي يسيلُ
إن المُسيلَ هو القتيلُ».
بيد أن مقامه في مصر لم يطل، هذه المرّة، أكثر من ستة أشهر، وإن أبدى في خلالها إعجابه الشديد بالقاهرة والشعب المصري «الجميل والكريم والصامد، والذي كان، وهو ما صوّره الأقدمون وما يزال حتّى نهاية هذا القرن (العشرين)، لا تصرفه همومه ولا أثقال الحياة وأهوالها ولا حتّى ما اختلفت عليه أنظمة الحكم من حسن وأحسن ومن سيئ وأسوأ، يلطّف من ذلك كلّه بحكم الفطرة وجمال الطبيعة وعمق الإحساس، أن يلطّف من كل هذا بحبّ الحياة، وأن يهدم بكلّ ما استطاع من أسوارها بضربات المرح والسّهر والسّمر والنكتة المازحة والجلسة الناعمة والجنس الناعم. وإلى جانب هذا كلّه، وبحكم عناصر القوة والقدرة على التكيّف، فهو مَن هو حين تحين الوثبة وحين تحين الثورة، وحين يُطرح على المحكّ قدرة الشعوب على الدّفاع عن نفسها وكرامتها وتفجرها وانتفاضاتها».
لكن، ما سرّ ذلك التغيّر المفاجئ وترك مصر على الرّغم من إلحاح طه حسين عليه بالبقاء ولو لاجئاً سياسيّاً؟ قد يكون ثمّة غير سبب، يتصدّرها ما أحسّ به من مضايقات أسرّ بها إلى طه حسين وحدَه أولاً، ثم أعلنها في ذكرياته.
وقد يكون منها أنّه لم يجد في مصر صدىً واهتماماً بما كان يصبو إليه من تمجيدٍ بكفاحه الوطنيّ، واعترافٍ بعبقريته الشعريّة؛ لا سيما أن عينه كانت على «إمارة الشعر» بعد شوقي. فقد كان بعث بمختارات من شعره إلى اللجنة التي تألفت بالقاهرة برئاسة طه حسين لتقليد إمارة الشعر إلى من يستحقّها من الشعراء، وقد وثّق أحمد حسن الزيّات هذا. وإن قيل إن عدم ترشيحه أميراً للشعراء «لم يحزّ في نفسه، ولم يُثرْ شجونه أو حتّى يأسه من بلوغ مثل هذه المرتبة، لأنه كان في ذلك الوقت في طريقه إلى ارتقاء سُلّم المجد الأدبي، وتبوأ عرش إمارة الشعر باعتراف الجميع، ومن دون مُنافسة».
لكن الجواهري نظم بدمشق في أواخر العام 1956 قصيدته «بور سعيد» تضامناً مع مصر، ومطلعها:
«يا مَعْدِنَ الخِسّةِ مَنْ تُقاتلُ
وفَوْق مَنْ تَسَاقط القنابلُ؟».
وفيها، مثلاً:
«كنانة اللهِ.. اسلمي، إنّ المُنى
دونكِ لغْوٌ، والحياة باطل
كنانة الله.. سيجلو عَاصِفٌ
ويَمّحي ضُرٌّ، ويُثْنى واغِل
كنانة الله.. اسلمي لأُمّةٍ
أنتِ لها الغايةُ والوسائل
كنانة الله.. وللّه يدٌ
تَلْوي يَد الطّاغوت إذْ تُصاول».
ثمّ زار القاهرة العام 1971 من منفاه ب «براغ» بدعوة من لجنة الاحتفال بالذكرى الأولى لوفاة جمال عبد الناصر، وألقى في الاحتفال قصيدته «ذكرى عبد الناصر» التي مطلعها:
«أَكْبَرْتُ يومك أن يكون رثاءَ
الخالدون عَهِدْتُهمْ أَحياءَ».
وزارها العام 1992 للمشاركة في احتفال مجلة «الهلال» بمرور مائة عام على صدورها، ونظم قصيدته «هلال الفكر» ذات المطلع:
«يا هلالَ الفكر في العيد السعيدِ
هكذا ظلّ مضيئاً ألفَ عيدِ».
وهي ليست في ديوانه.
(2)
على الرّغم من أن قصيدة الجواهري في رثاء حافظ أقدم بقليل من قصيدته في رثاء شوقي طبقاً لتاريخ وفاتيهما، فإنّني أبدأ بما بينه وبين شوقي، لأن الجواهري ذكر حافظاً غير مرّة في القصيدة التي رثى فيها أحمد شوقي.
كان الجواهري يَعُدّ أحمد شوقي أحد الأفذاذ القلائل، إذ قال: «في البلدان العربيّة كانت هناك قلّة من الأفذاذ: شوقي في مصر، بدوي الجبل في سوريا، الأخطل الصغير في لبنان».
لقد كان شوقي، إذاً، حقيقاً بأن يرثيه الجواهري، في قصيدته «أحمد شوقي» التي استهلها قائلاً:
«طوى الموتُ ربَّ القوافي الغُررْ
وأصبح (شوقي) رهينَ الحُفَرْ
وأُلقيَ ذاك التراثُ العظيم
لِثِقْلِ الترابِ وضغط الحجرْ».
اللافت أن القصيدة مؤسسة وزناً (المتقارب) وقافية على قصيدة (أبو الهول) لشوقي، ومعارضة لها، هي التي مطلعها:
«أبا الهول طال عليك العُصُرْ
وبُلِّغْتَ في الأرض أقصى العُمُرْ».
ولم تسلمِ الجواهريّة من أصداء الشوقيّة ونسماتها، ومن أن يتناصّ الجواهري مع أشياء منها تناصّاً موازياً، كأن يقول شوقي:
«أبا الهول، ماذا وراء البقا
ءِ -إذا ما تطاول- غيرُ الضَّجَرْ؟!».
فيقول الجواهري:
«ولكنْ يريد الفتى أن يدومَ
ولو دام ساد عليه الضَّجَرْ!».
وأن يقول شوقي:
«أبا الهول، ما أنتَ في المعضلا
تِ؟ لقد ضلّتِ السُّبْلُ فيك الفِكَرْ
تحيّرتِ البَّدْو ماذا تكو
نُ، وضلّتْ بوادي الظُّنون الحَضَرْ
فكنتَ لهم صورةَ العُنْفوا
نِ، وكنتَ مثالَ الحِجى والبصَرْ».
فيقول الجواهري:
«تحيّرتْ في عيشه الشاعرينَ
أتحلو خُلاصَتُها أم تَمَر؟
فقد جار شوقي على نفسه
وقد يقتُلُ المرءَ جَوْر الفِكَرْ
على أنّه لم يعِشْ خالداً
خلود الجديدينِ لو لم يَجُر!».
وأن يقول شوقي:
«أبا الهول أنتَ نديمُ الزّما
نِ نجِيُّ الأوانِ سميرُ العُصُر
بسَطْتَ ذراعيك من آدمٍ
وولّيْتَ وجْهكَ شَطْر الزُّمَر».
فيقول الجواهري:
«وما كنتَ من زمنٍ واحدٍ
ولكنْ نِتاجُ قرونٍ عُقُر».
ليست المعارضات بغريبة على الجواهري لا سيّما في المرحلة الأولى من حياته في الشعر. فها هو ذا نفسه يعترف بما يسمّيه غيرُه «المعسكر التدريبي» بابتداعه فكرة «الحلبة الشعريّة» ليتدرب فيها مع أساتذة الشعر مصطفياً إحدى أشهر قصائدهم للمنازلة، لكن دون تحدٍّ. يقول: «فقد خُلقت وَلِعاً بجمع شوارد الأدباء؛ وقد كنت اخترت خُطّة لسلوكي في عالم الأدب، تلك أنّي ما رأيت مجرَّ قلمٍ لأديب كبير إلاّ أجهدتُ كلّ طاقة لأن أكون منه بحيث يرى نفسه. فإن وقع في نفوس أعلام الأدب ورجال الشعر موقع الرّضا فكما توحيه نخوتهم الأدبية، وإلاّ فإنّ لي من هذه الجرأة بمنافسة كبار الأدباء ومعارضتهم ما يوجب عليّ عقابُ سخطهم».
القصيدة في مجملها، وإن تكن في الرّثاء، نأى الجواهري فيها عمّا شاع في فنّ الرّثاء من بكاء وندب وعويل وهذه سمة تجديديّة، فجاء أقرب إلى مفهوم الناقد القديم قدامة بن جعفر للرّثاء أنّه مدح بصيغة الماضي، وأنّه «ليس بين المرثيّة والمدحة فصل إلاّ أن يُذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك، مثل: «كان» و «توّلى» و «قضى نحبه»، وما أشبه ذلك. وهذا ليس يزيد في المعنى ولا ينقص منه، لأن تأبين الميْت إنّما هو بمثل ما كان يُمدح في حياته».
لم يفُت الجواهري، بدءاً، أَنَ يجمع بين شوقي وحافظ بإشارته إلى حفل تكريم شوقي في مصر بحضور وفود من الوطن العربي، ومبايعة حافظ، باسمها جميعاً، له بإمارة الشعر العام 1927:
«أميرَ القوافي قد أتيت مبايعاً
وهذي وفود الشّرق قد بايعتْ معي».
فماذا قال فيهما؟ قال مخاطباً «شوقي» خطاباً مزداناً بالصور الشعريّة البيانيّة المنسوجة من أنماط التشبيه كالبليغ مثلاً، والمطعّمة بشيءٍ من التناصّ القرآني «من كلّ فجٍّ زُمَر»، والمصوغة بلغة عاطفيّة مكلّلة بالألفاظ القديمة المأنوسة المحمّلة بالدلالات والاستدعاءات التاريخيّة: «عكاظ الشعر»، و «صمصامة عمرو بن معد يكرب»، و «أبلق السمؤال»، قال:
«(عكاظٌ) من الشعر يحتلّه
ويرعاه (حافظٌ) حتّى ازدهرْ
تلوذُ الوفود بساحتيكما
وتأتيه من كلّ فجٍّ زُمَرْ
وأنتَ كصمصامةٍ مُنْتَضىً
و (حافظٌ) كالأبلقِ المثْتَهِر
تمشّى بإثرك في شعره
ومات وأَعْقَبْته بالأثرْ
عزاءُ الكنانةِ أنّ القريضَ
تأمَرَّ دهراً بها ثمّ فَرْ
بنجمين كانت تباهي السماءَ
وما في السّما من نجومٍ كُثُرْ
بشوقي وحافظَ كانت متى
تُنازِلْ بمعركةٍ تنتصِرْ».
وكرّس الجواهري جُلّ القصيدة تكريساً نقديّاً عامّاً لشعر شوقي، مّا يؤكد أنه كان متتبعاً له بشغف، وذا خُبْر عميق بديوانه ومكنونات شعره وسماته الفنيّة التي يفارق أسلوبه فيها أساليب الزّخرفة البديعيّة الشكليّة التي كانت طاغية آنذاك، وشوقي عنده «شكسبير أُمّته». ها هو ذا يقول بإيجاز يغني عن التفصيل النقدي الذي لا يحتمله الشعر الشطريّ المحكوم بالوزن والقافية:
«تتبّعْتُ آثار شوقي، وقد
وقفتمْ على مَنْ يقُص الأثَرْ
لقد فات بالسَّبْق كلّ الجيا
دِ في الشعر هذا الجواد الأَغَرّ
تَرَسّلَ لم يرتبكْ خَطْوُه
عناءً، ولا نال منه البَهَرْ
(شكسبير) أُمّته لم يُعِبْ
ه بالِعيّ داءٌ، ولا بالحَصَرْ
كأنّ عيونَ القوافي الحسا
نِ من قَبْلُ كانت له تُدَّخَر
وإن أَصْدُقَنَّ فشوقي له
عيون من الشّعر فيها حَوَرْ
تعَرّضَه من طِلاء البيانِ
ومِنْ زِبْرج اللّفظ درْبٌ خَطِرْ
ولو خاف مثل سِواه العُبُورَ
لخابَ وزلّ، ولكنْ عَبَرْ
تمشّى لمصطلحات البدي
ع مندسّةً في البيانِ النَّخِرْ
فأفرغها من رهيب الشّذاةِ
قوالبَ مرصوصةً كالزُّبَر
ولاءَم بين أفانينها
وبين أَفانينِ ما يَبْتَكِرْ
فجاءت كأنْ لم تَنَلْها يدٌ
خِلافَ يد الماهر المقتدِر
يُذلّلّ من شاردات القري
ضِ ما لو سواه ابتغاه كَفَرْ».
ويتابع معرّجاً على بعض موضوعات شعر شوقي، فيقول بما هو أقرب إلى النثر:
«ويستنزل الشّعْرَ عَذْب الرُّواءِ
كصوْبِ الغمامةِ إذْ ينحدر
يميّزه عن سواه الذّكاء
وطولُ الأَناةِ، وبُعْد النَّظر
ولم يَتخبّثْ بهُجْر الكلام
ولم يتصيّدْ بماءٍ عَكِرْ
وديوان شوقي بما فيه من
صُنوفِ البداعة روْضٌ نَضِرْ
فبيتٌ يكاد من الارتيا
حِ واللّطف من رِقّة يُعْتَصرْ
وبيتٌ يكاد من المُلْهِبا
تِ يَقْدح من جانبيه الشّرَرْ
وبيتٌ ترى مصرَ أسيانةً
تُناغي به مَجْدها المُنْدثِر
ففي مَصْرعٍ يومُها المبتلى
وفي مصرعٍ أَمسُها المُزْدَهِرْ».
بيد أن المرثيّة لم تُعْجب أحد المقرّبين من الجواهري ودارسيه أيضاً. وقد ركّز على مستهلها، فقال: «أيّ احتجاج في الأعماق؟ وأيّ رفضٍ في اللاوعي؟ لقد طواه، وأخذه أسيراً، وألقاه في الحفر، وضغط عليه بأحمال التراب، وأثقل على صدره بالحجر. لقد اعتصره وكسّر عظامه، ولم يُبْق منه بقيّة». ويذكر أنّه سأل الجواهري مرّة العام 1975: «ماذا فعلت بأمير الشعراء؟ قال: وماذا كان عليّ أن أقول؟ فردَّدْت عليه مقاطع من رثائيته في الرُّصافي، فابتسم (بعد تفكير قصير)!».
الغريب أن هذا الفهم، الذي تصادِر عليه مواقف الجواهري ما سلف منها وما هو آت، من شوقي، هو الذي حمله على أن يستنتج «إنه (الجواهري) –قطعاً- لا يحمل مشاعر وديّة نحو أحمد شوقي، لخلافٍ في النشأة والموقف السياسيّ والطبقيّ والنظرة إلى الحياة».
ليس ثمّة شكّ في أن تتبع الجواهري لديوان شوقي ومدارسة شعره كان لهما انعكاساتهما على شعره هو معارضةً وتضميناً وتأثراً وتناصيّة بوجوهٍ متفاوتة تتبدّى أحياناً وتتخفّى حيناً تخفيّاً لا يزيغ عن العارف بشِعاب شعره ومضايقه.
فمن التأثر الجليّ ما يتردد في قصيدة «سلام على أرض الرُّصافة» (1923)، وهي من شعر المرحلة الأُولى، وقريبة العهد بسينيّة شوقي التي عارض فيها البحتري الأثير جدّاً -بعد المتنبي- عند الجواهري الذي كان يصحب معه ديوانه في رحلاته القصيرة والطويلة. ففي حين حنّ شوقي في منفاه الأندلسيّ إلى مصره، فقال:
«اختلافُ النهار والليل يُنْسي
اذكرا لي الصِّبا وأيامَ أُنسي
صُوّرتْ من تصورات ومَسِّ
وصِفا لي مُلاوةً من شبابٍ
بهما في الدّموع سيري وأُرسي
نفسيَ مِرْجَلٌ، وقلبي شراعٌ
نازعتني إليه في الخلد نفسي
وطني لو شُغلتُ بالخُلد عنه
وهفا بالفؤاد في سلسبيلٍ
ظمأُ للسّواد من (عيْن شمس)».
تلهّف الجواهري، وهو في داخل العراق، إلى بغداد:
«لياليَ بغدادٍ سبتْني وبَرْدُها
إذا ما تصابى ذو الهوى لرُبى نجْدِ
بلادٌ استعذبتُ بها ماءَ شبيبتي
هوىً ولبستُ العِزَّ بُرْداً على بُرْدِ
وصلْتُ بها عُمْر الشّباب وشرْخَهُ
بذكرٍ على قُرْبٍ وشوْقٍ على بُعْد
سلامٌ على دار الرُّصافة إنّها
مَراحُ ذوي الشكوى وسلوى ذوي الوجْد
هواؤكِ أم نَشْرٌ من المسك نافحٌ
وأرضُكِ يا بغدادُ أَم جَنّةُ الخُلْد؟!».
وبالعودة إلى قصيدة «سر في جهادك» الهمزيّة نجد أنها معارضة مبكّرة لهمزيّة شوقي النبويّة.
القصيدتان من ضرب المعارضات التي تشترك في البحر (الكامل) والقافية (الهمزة)، والتي تنزع الأخرى إلى أن تشارك الأولى في الغرض العام بنحو ما. بيد أن الجواهريّة أطول، فهي تعدّ مئة واثنين وستين بيتاً، في حين أن الشوقيّة مئة وواحد وثلاثون بيتاً، ناهيك بأنهما تدخلان في المعارضات التي يتباعد الشاعران فيهما في مصدر الإلهام، وأن الجواهريّة قد تسلك في قصائد «تناصيّة المعارضة» التي تتخذ سبيل الموازاة الذي يوصل في النهاية إلى نقطة التقاءٍ ما.
إنّما أذهب هذا المذهب لما في الجواهريّة -وإن تكن معارضة- من تناصيّةٍ خفيّة مع الشوقيّة التي افتتحها شوقي بقوله:
«وُلد الهدى فالكائناتُ ضياء
وفم الزّمان تبسّمٌ وثناءُ
الرُّوح والملأ الملائكُ حوله
للدّين والدّنيا به بُشراء».
أمّا الجواهري فقال في مفتتح قصيدته:
«سرْ في جهادك.. يَحْتضِنْك لواءُ
نثرتْ عليه قلوبَها الشهداءُ
ضوّى به عَلَقُ النجيعَ كأنّه
قَبَسٌ يُنارُ به الدُّجى ويُضاء».
كما أن في ثناياها إشعاعاتٍ أخرى، كقول الجواهري:
«إن الجهاد صحيفةٌ مخضوبةٌ
جَمَدتْ عليها للشعوب دماء
هوتِ العروش على مَدَبّ سطورها
وتصاغرتْ لحروفها الكُبراء».
فهو يتعالق مع قول شوقي:
«الحقّ عالي الرُّكنِ فيه مظفّرٌ
في المُلْك لا يعلو عليه لواء
ذُعرتْ عروش الظالمينَ فزُلْزلتْ
وعَلَتْ على تيجانهم أصداء».
وفي حين قال شوقي:
«نُظِمتْ أسامي الرُّسْل فهي صحيفةٌ
في اللّوح واسم محمدٍ طُغَراءُ».
قال الجواهري:
«ورسالةٌ خُلِق البليغُ سريرةً
لأدائها لا القالةُ البُلَغاء».
وقول الجواهري:
«سرْ في جهادك تَمْشِ خلفك أُمّةٌ
هي بالطموح منيعةٌ عصماء
شَرَفٌ يَمُدُّ الحقّ أنّ غريمها
شاكي السلاح وأنّها عَزْلاء!».
فيه قبسات من قول شوقي:
«وإذا مشيْتَ إلى العدا فغضَنْفَرٌ
وإذا جَرَيْت فإنَك النَّكْباء
وتمُدُّ حِلْمك للسّفيه مُدارياً
حتّى يضيق بِعرْضك السُّفهاء
والرأي لم يُنْضَ المهنّد دونه
كالسيف لم تُضْرب به الآراء».
وفي حين اكتفى شوقي بالبيت الآتي موجِزاً باقتدار قدْراً من لُباب الرسالة المحمديّة:
«أنصفتَ أهل الفقر من أهل الغنى
فالكلّ في حقّ الحياة سواء».
توسّع الجواهري في موضوعة التحول هذه، فقال:
«سبحان آلاء الشعوب فإنّها
لَتُقَلِّبُ الأيامَ كيف تشاء
والله في همم الرّجال وإنْ رمى
رُجَمَ الظُّنون وشعْوذ الجُهلاء
المحكمو أسرَ الشعوب تبدّلتْ
دولٌ بهم فإذا هُمُ الأُسراء
وإذا العبيد النائمون على العصا
ناهونَ في أوطانهمْ أُمراءُ
وإذا بحكْم الأخرقينَ كما انبرتْ
حمقاءُ تنقض غزْلَها خَرْقاء».
(1)
فإنّها لقديمة علاقة محمد مهدي الجواهري بمصر، إذ بدأت في الربع الأول من القرن العشرين من خلال مجلتي «الهلال» و «المقتطف»؛ فسبقت، بهذا، مصرياتُه الثقافيّة مصرياتِه السياسيّة. ولقد قال، وهو يطأ أرض الكنانة العام 1992 بعد انقطاع واحدٍ وعشرين عاماً عنها، قادماً من «براغ» ملبيّاً دعوة مجلة «الهلال» للمشاركة في احتفاليتها المئوية: «أنا سعيد بأن آتي من أجل (الهلال) الذي كتبت فيه في العشرينيّات. وكان هذا شرفاً لي أنْ أكتب ضمن الصّفوة من كبار المفكرين العرب، وآتي اليوم لأردّ الدّيْن ل (الهلال) الذي تربيّنا على ما يضمّه من ثقافة وفكر مستنير».
من الطريف اللافت أنه دعا العام 1925، وهو في ميعة الصِّبا، إلى أن تؤلَّف «محكمة» من الأدباء تحاسب أهل الأدب والسلطة السياسيّة. وقد ندب لها أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، وبعث إليهما في القاهرة الدعوة الشعريّة الآتية لينظرا فيها:
لكما الخَيار إذا الرّجال تنافسوا
أو حرّروا دعوى بلا مِصْداقِ
أن تقتلا أو تُحرقا مُتشاعراً
أو تَقْطعا يدَ شاعرٍ سرّاق
هل تحكمان اليوم حكماً عادلاً
خُلواً من الإرهاب والإشفاق
في شاعرٍ لزم البيوت وأخفقت
منه المآرب أيّما إخفاق؟
لكما شكا ظلمَ العراق، وذِلّةٌ
أن يشتكي ظلمَ العراقِ عراقي».
والتفت الجواهري إلى مصر ولسانيها الناطقين، أيضاً، العام 1931 حين قدمت بعثة الجامعة المصريّة إلى العراق، إذ حيّاها بقصيدة «إلى البعثة المصريّة» التي مطلعها:
«رُسل الثقافة من مُضَرْ
وجه العراق بكم سَفَرْ».
واهتبلها فرصةً لمسامرة شعريّة مع البعثة هدفَ من ورائها أن يوازن موازنة هزليّة جديّة تقرّ بفضل مصر الأدبي، وتوازن بين وضع الشاعر وعيشه في البلدين آنذاك متخذاً من شوقي وحافظ نموذجاً بأسلوب تلقائي مباشر يشفّ عن سمات شعره في بداياته الإبداعيّة، وعن تطلّعاته الاجتماعيّة:
«وإذا أردتمْ أن أُسا
مركُمْ، فقد لذّ السَّمرْ
عن نهضةٍ في مهدها
ما إنْ لها عنكمْ مَفَرّْ
لولاكمُ ما كان للش
عراء فينا من أَثَرْ
قُبر الأديب الألمعيّ
هنا وفي (مِصْرَ) انتشرْ
الله يجزي مَنْ أَفا
دَ ومن أعان ومن نَشَرْ
إنّي أُسائِلُكمْ وأع
لم بالجواب المنتظر:
هل تقبلون بأن يُقا
ل: أديبُ مصرَ قد افتقر؟!
أو أنّ (شوقي) من حرا
جةِ عيشه كالمُحْتضَرْ؟
أو أن (حافظَ) قد هوى
فتجاوبون: إلى سَقَرْ
حاشا، فتلك خطيئةٌ
وجريمة لا تُغْتفر
(شوقي) يعيش كما يلي
قُ بمن تفكّر أو شَعَرْ
وَسَطَ القصور العامرا
تِ وبين فائحة الزَّهَر
برعاية الوطن الأعزّ
وَغيْرة الملك الأبَر
وتحوط (إبراهيمَ) عا
طِفَةُ الأمير من الصِّغَر
أمّا هنا فالشعر شيْ
ءٌ للتملّح يُدَخّر
وعلى السواءِ أغاب شا
عرنا المجوِّد أم حَضَر!
سَقَطُ المتاعِ وجُوده
عند الضرورة يُدّكَر
في كلّ زاويةٍ أدي
بٌ بالخمول قد استتر
وقريحةٌ حسدوا عليْ
ها ما تجودُ فلم تُثَرْ».
وتلا هذه القصيدة مباشرة قصيدته «حافظ إبراهيم» التي نظمها في وفاة حافظ، ونُشرت في 22 آب 1932، ثم قصيدته «أحمد شوقي» التي أنشدها في الحفل التأبينيّ الذي أقامته الدائرة العربيّة في المدرسة الأميركيّة ببغداد في 11 تشرين الثاني 1932.
وفي العام 1936 نشر الجواهري قصيدته «المازنيّ وداغِر» التي أنشدها في الحفلة التي أقامها «رَفائيل بطيّ» صاحب صحيفة «البلاد» العراقيّة لإبراهيم عبد القادر المازنيّ وأسعد خليل داغِر اللبناني، والتي بدأها بقوله:
«رَفَائيل.. دارُك قد أشرقتْ
بأسعدَ داغِرَ والمازني
بفَذٍّ يُناضل عن أُمَةٍ
وفَذٍ لآدابها حاضنِ».
وأشاد فيها بالمازني، وردّ على ما قاله في نفسه:
«انظر إلى وجهي القبيح الشئيم
تَحْمَدْ على وجهك ربَّ الفنونِ
تعْلمْ بأن الله ما صاغني
كذاك إلاّ رغبةً في المجون».
ردّ بقوله على وزن قصيدة المازني ورويّها:
«على حينِ قد وضَحَ المازني
وضُوح السماوات للكاهنِ
نظرتُ بعينيك إذْ يَشْرُدانِ
ووجهكَ ذي الدَّعَةِ الآمنِ
فأنكرتُ قولك: ما صاغني
قبيحاً سوى عَبَثِ الماجن
وطالعتُ آثارَك النّاطقاتِ
بما فيك من جوهرٍ كامن
وظاهرَ لفْظٍ رقيق الرُّواء
لطيفٍ يدُلُّ على الباطن».
ونظم العام 1936، كذلك، قصيدته «سرْ في جهادك» إثر فوز حزب الوفد المصري بالانتخابات وتوليه السلطة، وإلغاء حكومة الوفد المعاهدةَ المصريّة البريطانية. وهي ممّا عارض فيه مبكّراً همزيّة شوقي النبويّة.
وتوّج الجواهري عرى آصرته بمصر بتعرفه، شخصيّاً، على طه حسين بدمشق العام 1944 في مهرجان «ذكرى أبي العلاء»، حيث نظم قصيدته «أُحيّيك طه»، وألقاها في المأدبة التي أقامها طه حسين للوفود المشاركة، وبدأها:
«أُحيّيكَ طه لا أُطيل بِكَ السَّجْعا
كفى السَّجْعُ فخراً محضُ اسمك إذْ تُدْعى
أُحيّيك فذّاً في دمشقَ وقبْلَها
ببغدادَ قد حَيّيْتُ أفذاذكم جَمْعا».
ونهض طه حسين، بعد فراغ الجواهري من إلقاء القصيدة، وتحدث عنه وعنها مفتتحاً كلامه بالحديث النبوي «إنّ من البيان لسحرا، وإنّ من الشعر لحكمة».
قد تكون هذه الصّلة هي التي حملت الجواهري على أنْ يفكّر في الهجرة إلى مصر العام 1950 منتهزاً الدعوة الخاصّة التي وُجّهت إليه، خارج نطاق الوفد العراقيّ الرسميّ، لحضور المؤتمر الثقافي لجامعة الدول العربيّة بالإسكندريّة حيث ألقى قصيدته «إلى الشعب المصري» في الحفلة التي أقامها طه حسين، أيضاً، للوفود المشاركة. مطلع القصيدة التي بناها على قصيدة لشاعره الأثير البحتري وزناً وقافية، وعلى رائيّة عمر ابن أبي ربيعة المعروفة، هو:
«يا مصرُ تستبقُ الدُّهور وتَعْثُرُ
والنيل يزخرُ والمِسلَّةُ تُزْهِرُ».
وفيها:
«أنا ضيفُ مصرَ، وضيفُ طه ضيفُها
ما بعد ذلك للمُفَاخِر مَفْخَرُ
أنا ضيفُ مصرَ، فلن أُثقِّل فوقَها
ظِلّي بمألُكةٍ تُعاب وتُنْكَر».
فأمّا قصيدة البحتري فمشهورة، هي التي مدح بها المتوكّل ووصف خروجه يوم عيد الفطر، ومطلعها:
«أُخفي هوىً لكَ في الضلوع وأُظْهِرُ
وأُلام في كَمَدٍ عليك وأُعْذَرُ».
أما قصيدة عمر فمشهورة كذلك، ومطلعها:
«أمن آل نُعْمٍ أنتَ غادٍ فَمُبْكِرُ
غداةَ غدٍ أم رائحٌ فمُهَجِّرُ؟!».
وبعد أن فرغ الجواهري من إلقاء قصيدته ارتجل طه حسين خطاباً نوّه فيه بالشاعر وشعره، وبالشعب العراقي. بيد أن القصيدة سدّت باب العودة في وجه صاحبها إلى العراق، لأنه فضح فيها سوءات الحكم وممارساته فيه آنذاك، وهو ما حدا بالحكومة المصريّة، بمبادرة من طه حسين، أن ترحّب بالجواهري ضيفاً عليها، وتتكفّل به وبتعليم أبنائه، وإن لم تطل إقامته بمصر، التي عاد إليها ثانية العام 1951 بعد أن ضيّقت الحكومة العراقية الخناق عليه لنشره العام 1950 قصيدته «عبد الحميد كرامي» التي ألقاها في حفل تأبين عبد الحميد كرامي ببيروت، فكان لها صدى بالغٌ في لبنان والعراق ثمّ مصر، ومطلعها:
«باقٍ -وأعمارُ الطُّغاة قِصارُ-
من سِفْر مجدك عاطرٌ موّارُ».
ولنشره العام 1951 قصيدته المدويّة «تنويمة الجياع»:
«نامي جياعَ الشّعبِ نامي
حَرَسْتكِ آلهة الطّعام
نامي فإنْ لم تشْبعي
من يَقَظةٍ فمن المنام».
غير أنّه كاد يُمنع من دخول مصر هذه المرّة، لولا تدخل طه حسين بالسماح له بدخولها، لأسباب قد يكون أحدها لوحاتٍ حملها معه تمثّل شعارات للسلام العالمي الذي كان محظوراً، حينئذٍ، في مصر والوطن العربي، وكانت أُهديت له في دمشق التي جاء منها مباشرة إلى القاهرة.
ونظم، في خلال إقامته الثانية، قصيدته «الدّم الغالي» بمناسبة هبوب المقاومة المصريّة الشعبيّة المسلّحة على الاحتلال العسكري البريطاني المتمثّل بقواعده العسكريّة في السويس والإسماعيليّة:
«خلّي الدّمَ الغالي يسيلُ
إن المُسيلَ هو القتيلُ».
بيد أن مقامه في مصر لم يطل، هذه المرّة، أكثر من ستة أشهر، وإن أبدى في خلالها إعجابه الشديد بالقاهرة والشعب المصري «الجميل والكريم والصامد، والذي كان، وهو ما صوّره الأقدمون وما يزال حتّى نهاية هذا القرن (العشرين)، لا تصرفه همومه ولا أثقال الحياة وأهوالها ولا حتّى ما اختلفت عليه أنظمة الحكم من حسن وأحسن ومن سيئ وأسوأ، يلطّف من ذلك كلّه بحكم الفطرة وجمال الطبيعة وعمق الإحساس، أن يلطّف من كل هذا بحبّ الحياة، وأن يهدم بكلّ ما استطاع من أسوارها بضربات المرح والسّهر والسّمر والنكتة المازحة والجلسة الناعمة والجنس الناعم. وإلى جانب هذا كلّه، وبحكم عناصر القوة والقدرة على التكيّف، فهو مَن هو حين تحين الوثبة وحين تحين الثورة، وحين يُطرح على المحكّ قدرة الشعوب على الدّفاع عن نفسها وكرامتها وتفجرها وانتفاضاتها».
لكن، ما سرّ ذلك التغيّر المفاجئ وترك مصر على الرّغم من إلحاح طه حسين عليه بالبقاء ولو لاجئاً سياسيّاً؟ قد يكون ثمّة غير سبب، يتصدّرها ما أحسّ به من مضايقات أسرّ بها إلى طه حسين وحدَه أولاً، ثم أعلنها في ذكرياته.
وقد يكون منها أنّه لم يجد في مصر صدىً واهتماماً بما كان يصبو إليه من تمجيدٍ بكفاحه الوطنيّ، واعترافٍ بعبقريته الشعريّة؛ لا سيما أن عينه كانت على «إمارة الشعر» بعد شوقي. فقد كان بعث بمختارات من شعره إلى اللجنة التي تألفت بالقاهرة برئاسة طه حسين لتقليد إمارة الشعر إلى من يستحقّها من الشعراء، وقد وثّق أحمد حسن الزيّات هذا. وإن قيل إن عدم ترشيحه أميراً للشعراء «لم يحزّ في نفسه، ولم يُثرْ شجونه أو حتّى يأسه من بلوغ مثل هذه المرتبة، لأنه كان في ذلك الوقت في طريقه إلى ارتقاء سُلّم المجد الأدبي، وتبوأ عرش إمارة الشعر باعتراف الجميع، ومن دون مُنافسة».
لكن الجواهري نظم بدمشق في أواخر العام 1956 قصيدته «بور سعيد» تضامناً مع مصر، ومطلعها:
«يا مَعْدِنَ الخِسّةِ مَنْ تُقاتلُ
وفَوْق مَنْ تَسَاقط القنابلُ؟».
وفيها، مثلاً:
«كنانة اللهِ.. اسلمي، إنّ المُنى
دونكِ لغْوٌ، والحياة باطل
كنانة الله.. سيجلو عَاصِفٌ
ويَمّحي ضُرٌّ، ويُثْنى واغِل
كنانة الله.. اسلمي لأُمّةٍ
أنتِ لها الغايةُ والوسائل
كنانة الله.. وللّه يدٌ
تَلْوي يَد الطّاغوت إذْ تُصاول».
ثمّ زار القاهرة العام 1971 من منفاه ب «براغ» بدعوة من لجنة الاحتفال بالذكرى الأولى لوفاة جمال عبد الناصر، وألقى في الاحتفال قصيدته «ذكرى عبد الناصر» التي مطلعها:
«أَكْبَرْتُ يومك أن يكون رثاءَ
الخالدون عَهِدْتُهمْ أَحياءَ».
وزارها العام 1992 للمشاركة في احتفال مجلة «الهلال» بمرور مائة عام على صدورها، ونظم قصيدته «هلال الفكر» ذات المطلع:
«يا هلالَ الفكر في العيد السعيدِ
هكذا ظلّ مضيئاً ألفَ عيدِ».
وهي ليست في ديوانه.
(2)
على الرّغم من أن قصيدة الجواهري في رثاء حافظ أقدم بقليل من قصيدته في رثاء شوقي طبقاً لتاريخ وفاتيهما، فإنّني أبدأ بما بينه وبين شوقي، لأن الجواهري ذكر حافظاً غير مرّة في القصيدة التي رثى فيها أحمد شوقي.
كان الجواهري يَعُدّ أحمد شوقي أحد الأفذاذ القلائل، إذ قال: «في البلدان العربيّة كانت هناك قلّة من الأفذاذ: شوقي في مصر، بدوي الجبل في سوريا، الأخطل الصغير في لبنان».
لقد كان شوقي، إذاً، حقيقاً بأن يرثيه الجواهري، في قصيدته «أحمد شوقي» التي استهلها قائلاً:
«طوى الموتُ ربَّ القوافي الغُررْ
وأصبح (شوقي) رهينَ الحُفَرْ
وأُلقيَ ذاك التراثُ العظيم
لِثِقْلِ الترابِ وضغط الحجرْ».
اللافت أن القصيدة مؤسسة وزناً (المتقارب) وقافية على قصيدة (أبو الهول) لشوقي، ومعارضة لها، هي التي مطلعها:
«أبا الهول طال عليك العُصُرْ
وبُلِّغْتَ في الأرض أقصى العُمُرْ».
ولم تسلمِ الجواهريّة من أصداء الشوقيّة ونسماتها، ومن أن يتناصّ الجواهري مع أشياء منها تناصّاً موازياً، كأن يقول شوقي:
«أبا الهول، ماذا وراء البقا
ءِ -إذا ما تطاول- غيرُ الضَّجَرْ؟!».
فيقول الجواهري:
«ولكنْ يريد الفتى أن يدومَ
ولو دام ساد عليه الضَّجَرْ!».
وأن يقول شوقي:
«أبا الهول، ما أنتَ في المعضلا
تِ؟ لقد ضلّتِ السُّبْلُ فيك الفِكَرْ
تحيّرتِ البَّدْو ماذا تكو
نُ، وضلّتْ بوادي الظُّنون الحَضَرْ
فكنتَ لهم صورةَ العُنْفوا
نِ، وكنتَ مثالَ الحِجى والبصَرْ».
فيقول الجواهري:
«تحيّرتْ في عيشه الشاعرينَ
أتحلو خُلاصَتُها أم تَمَر؟
فقد جار شوقي على نفسه
وقد يقتُلُ المرءَ جَوْر الفِكَرْ
على أنّه لم يعِشْ خالداً
خلود الجديدينِ لو لم يَجُر!».
وأن يقول شوقي:
«أبا الهول أنتَ نديمُ الزّما
نِ نجِيُّ الأوانِ سميرُ العُصُر
بسَطْتَ ذراعيك من آدمٍ
وولّيْتَ وجْهكَ شَطْر الزُّمَر».
فيقول الجواهري:
«وما كنتَ من زمنٍ واحدٍ
ولكنْ نِتاجُ قرونٍ عُقُر».
ليست المعارضات بغريبة على الجواهري لا سيّما في المرحلة الأولى من حياته في الشعر. فها هو ذا نفسه يعترف بما يسمّيه غيرُه «المعسكر التدريبي» بابتداعه فكرة «الحلبة الشعريّة» ليتدرب فيها مع أساتذة الشعر مصطفياً إحدى أشهر قصائدهم للمنازلة، لكن دون تحدٍّ. يقول: «فقد خُلقت وَلِعاً بجمع شوارد الأدباء؛ وقد كنت اخترت خُطّة لسلوكي في عالم الأدب، تلك أنّي ما رأيت مجرَّ قلمٍ لأديب كبير إلاّ أجهدتُ كلّ طاقة لأن أكون منه بحيث يرى نفسه. فإن وقع في نفوس أعلام الأدب ورجال الشعر موقع الرّضا فكما توحيه نخوتهم الأدبية، وإلاّ فإنّ لي من هذه الجرأة بمنافسة كبار الأدباء ومعارضتهم ما يوجب عليّ عقابُ سخطهم».
القصيدة في مجملها، وإن تكن في الرّثاء، نأى الجواهري فيها عمّا شاع في فنّ الرّثاء من بكاء وندب وعويل وهذه سمة تجديديّة، فجاء أقرب إلى مفهوم الناقد القديم قدامة بن جعفر للرّثاء أنّه مدح بصيغة الماضي، وأنّه «ليس بين المرثيّة والمدحة فصل إلاّ أن يُذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك، مثل: «كان» و «توّلى» و «قضى نحبه»، وما أشبه ذلك. وهذا ليس يزيد في المعنى ولا ينقص منه، لأن تأبين الميْت إنّما هو بمثل ما كان يُمدح في حياته».
لم يفُت الجواهري، بدءاً، أَنَ يجمع بين شوقي وحافظ بإشارته إلى حفل تكريم شوقي في مصر بحضور وفود من الوطن العربي، ومبايعة حافظ، باسمها جميعاً، له بإمارة الشعر العام 1927:
«أميرَ القوافي قد أتيت مبايعاً
وهذي وفود الشّرق قد بايعتْ معي».
فماذا قال فيهما؟ قال مخاطباً «شوقي» خطاباً مزداناً بالصور الشعريّة البيانيّة المنسوجة من أنماط التشبيه كالبليغ مثلاً، والمطعّمة بشيءٍ من التناصّ القرآني «من كلّ فجٍّ زُمَر»، والمصوغة بلغة عاطفيّة مكلّلة بالألفاظ القديمة المأنوسة المحمّلة بالدلالات والاستدعاءات التاريخيّة: «عكاظ الشعر»، و «صمصامة عمرو بن معد يكرب»، و «أبلق السمؤال»، قال:
«(عكاظٌ) من الشعر يحتلّه
ويرعاه (حافظٌ) حتّى ازدهرْ
تلوذُ الوفود بساحتيكما
وتأتيه من كلّ فجٍّ زُمَرْ
وأنتَ كصمصامةٍ مُنْتَضىً
و (حافظٌ) كالأبلقِ المثْتَهِر
تمشّى بإثرك في شعره
ومات وأَعْقَبْته بالأثرْ
عزاءُ الكنانةِ أنّ القريضَ
تأمَرَّ دهراً بها ثمّ فَرْ
بنجمين كانت تباهي السماءَ
وما في السّما من نجومٍ كُثُرْ
بشوقي وحافظَ كانت متى
تُنازِلْ بمعركةٍ تنتصِرْ».
وكرّس الجواهري جُلّ القصيدة تكريساً نقديّاً عامّاً لشعر شوقي، مّا يؤكد أنه كان متتبعاً له بشغف، وذا خُبْر عميق بديوانه ومكنونات شعره وسماته الفنيّة التي يفارق أسلوبه فيها أساليب الزّخرفة البديعيّة الشكليّة التي كانت طاغية آنذاك، وشوقي عنده «شكسبير أُمّته». ها هو ذا يقول بإيجاز يغني عن التفصيل النقدي الذي لا يحتمله الشعر الشطريّ المحكوم بالوزن والقافية:
«تتبّعْتُ آثار شوقي، وقد
وقفتمْ على مَنْ يقُص الأثَرْ
لقد فات بالسَّبْق كلّ الجيا
دِ في الشعر هذا الجواد الأَغَرّ
تَرَسّلَ لم يرتبكْ خَطْوُه
عناءً، ولا نال منه البَهَرْ
(شكسبير) أُمّته لم يُعِبْ
ه بالِعيّ داءٌ، ولا بالحَصَرْ
كأنّ عيونَ القوافي الحسا
نِ من قَبْلُ كانت له تُدَّخَر
وإن أَصْدُقَنَّ فشوقي له
عيون من الشّعر فيها حَوَرْ
تعَرّضَه من طِلاء البيانِ
ومِنْ زِبْرج اللّفظ درْبٌ خَطِرْ
ولو خاف مثل سِواه العُبُورَ
لخابَ وزلّ، ولكنْ عَبَرْ
تمشّى لمصطلحات البدي
ع مندسّةً في البيانِ النَّخِرْ
فأفرغها من رهيب الشّذاةِ
قوالبَ مرصوصةً كالزُّبَر
ولاءَم بين أفانينها
وبين أَفانينِ ما يَبْتَكِرْ
فجاءت كأنْ لم تَنَلْها يدٌ
خِلافَ يد الماهر المقتدِر
يُذلّلّ من شاردات القري
ضِ ما لو سواه ابتغاه كَفَرْ».
ويتابع معرّجاً على بعض موضوعات شعر شوقي، فيقول بما هو أقرب إلى النثر:
«ويستنزل الشّعْرَ عَذْب الرُّواءِ
كصوْبِ الغمامةِ إذْ ينحدر
يميّزه عن سواه الذّكاء
وطولُ الأَناةِ، وبُعْد النَّظر
ولم يَتخبّثْ بهُجْر الكلام
ولم يتصيّدْ بماءٍ عَكِرْ
وديوان شوقي بما فيه من
صُنوفِ البداعة روْضٌ نَضِرْ
فبيتٌ يكاد من الارتيا
حِ واللّطف من رِقّة يُعْتَصرْ
وبيتٌ يكاد من المُلْهِبا
تِ يَقْدح من جانبيه الشّرَرْ
وبيتٌ ترى مصرَ أسيانةً
تُناغي به مَجْدها المُنْدثِر
ففي مَصْرعٍ يومُها المبتلى
وفي مصرعٍ أَمسُها المُزْدَهِرْ».
بيد أن المرثيّة لم تُعْجب أحد المقرّبين من الجواهري ودارسيه أيضاً. وقد ركّز على مستهلها، فقال: «أيّ احتجاج في الأعماق؟ وأيّ رفضٍ في اللاوعي؟ لقد طواه، وأخذه أسيراً، وألقاه في الحفر، وضغط عليه بأحمال التراب، وأثقل على صدره بالحجر. لقد اعتصره وكسّر عظامه، ولم يُبْق منه بقيّة». ويذكر أنّه سأل الجواهري مرّة العام 1975: «ماذا فعلت بأمير الشعراء؟ قال: وماذا كان عليّ أن أقول؟ فردَّدْت عليه مقاطع من رثائيته في الرُّصافي، فابتسم (بعد تفكير قصير)!».
الغريب أن هذا الفهم، الذي تصادِر عليه مواقف الجواهري ما سلف منها وما هو آت، من شوقي، هو الذي حمله على أن يستنتج «إنه (الجواهري) –قطعاً- لا يحمل مشاعر وديّة نحو أحمد شوقي، لخلافٍ في النشأة والموقف السياسيّ والطبقيّ والنظرة إلى الحياة».
ليس ثمّة شكّ في أن تتبع الجواهري لديوان شوقي ومدارسة شعره كان لهما انعكاساتهما على شعره هو معارضةً وتضميناً وتأثراً وتناصيّة بوجوهٍ متفاوتة تتبدّى أحياناً وتتخفّى حيناً تخفيّاً لا يزيغ عن العارف بشِعاب شعره ومضايقه.
فمن التأثر الجليّ ما يتردد في قصيدة «سلام على أرض الرُّصافة» (1923)، وهي من شعر المرحلة الأُولى، وقريبة العهد بسينيّة شوقي التي عارض فيها البحتري الأثير جدّاً -بعد المتنبي- عند الجواهري الذي كان يصحب معه ديوانه في رحلاته القصيرة والطويلة. ففي حين حنّ شوقي في منفاه الأندلسيّ إلى مصره، فقال:
«اختلافُ النهار والليل يُنْسي
اذكرا لي الصِّبا وأيامَ أُنسي
صُوّرتْ من تصورات ومَسِّ
وصِفا لي مُلاوةً من شبابٍ
بهما في الدّموع سيري وأُرسي
نفسيَ مِرْجَلٌ، وقلبي شراعٌ
نازعتني إليه في الخلد نفسي
وطني لو شُغلتُ بالخُلد عنه
وهفا بالفؤاد في سلسبيلٍ
ظمأُ للسّواد من (عيْن شمس)».
تلهّف الجواهري، وهو في داخل العراق، إلى بغداد:
«لياليَ بغدادٍ سبتْني وبَرْدُها
إذا ما تصابى ذو الهوى لرُبى نجْدِ
بلادٌ استعذبتُ بها ماءَ شبيبتي
هوىً ولبستُ العِزَّ بُرْداً على بُرْدِ
وصلْتُ بها عُمْر الشّباب وشرْخَهُ
بذكرٍ على قُرْبٍ وشوْقٍ على بُعْد
سلامٌ على دار الرُّصافة إنّها
مَراحُ ذوي الشكوى وسلوى ذوي الوجْد
هواؤكِ أم نَشْرٌ من المسك نافحٌ
وأرضُكِ يا بغدادُ أَم جَنّةُ الخُلْد؟!».
وبالعودة إلى قصيدة «سر في جهادك» الهمزيّة نجد أنها معارضة مبكّرة لهمزيّة شوقي النبويّة.
القصيدتان من ضرب المعارضات التي تشترك في البحر (الكامل) والقافية (الهمزة)، والتي تنزع الأخرى إلى أن تشارك الأولى في الغرض العام بنحو ما. بيد أن الجواهريّة أطول، فهي تعدّ مئة واثنين وستين بيتاً، في حين أن الشوقيّة مئة وواحد وثلاثون بيتاً، ناهيك بأنهما تدخلان في المعارضات التي يتباعد الشاعران فيهما في مصدر الإلهام، وأن الجواهريّة قد تسلك في قصائد «تناصيّة المعارضة» التي تتخذ سبيل الموازاة الذي يوصل في النهاية إلى نقطة التقاءٍ ما.
إنّما أذهب هذا المذهب لما في الجواهريّة -وإن تكن معارضة- من تناصيّةٍ خفيّة مع الشوقيّة التي افتتحها شوقي بقوله:
«وُلد الهدى فالكائناتُ ضياء
وفم الزّمان تبسّمٌ وثناءُ
الرُّوح والملأ الملائكُ حوله
للدّين والدّنيا به بُشراء».
أمّا الجواهري فقال في مفتتح قصيدته:
«سرْ في جهادك.. يَحْتضِنْك لواءُ
نثرتْ عليه قلوبَها الشهداءُ
ضوّى به عَلَقُ النجيعَ كأنّه
قَبَسٌ يُنارُ به الدُّجى ويُضاء».
كما أن في ثناياها إشعاعاتٍ أخرى، كقول الجواهري:
«إن الجهاد صحيفةٌ مخضوبةٌ
جَمَدتْ عليها للشعوب دماء
هوتِ العروش على مَدَبّ سطورها
وتصاغرتْ لحروفها الكُبراء».
فهو يتعالق مع قول شوقي:
«الحقّ عالي الرُّكنِ فيه مظفّرٌ
في المُلْك لا يعلو عليه لواء
ذُعرتْ عروش الظالمينَ فزُلْزلتْ
وعَلَتْ على تيجانهم أصداء».
وفي حين قال شوقي:
«نُظِمتْ أسامي الرُّسْل فهي صحيفةٌ
في اللّوح واسم محمدٍ طُغَراءُ».
قال الجواهري:
«ورسالةٌ خُلِق البليغُ سريرةً
لأدائها لا القالةُ البُلَغاء».
وقول الجواهري:
«سرْ في جهادك تَمْشِ خلفك أُمّةٌ
هي بالطموح منيعةٌ عصماء
شَرَفٌ يَمُدُّ الحقّ أنّ غريمها
شاكي السلاح وأنّها عَزْلاء!».
فيه قبسات من قول شوقي:
«وإذا مشيْتَ إلى العدا فغضَنْفَرٌ
وإذا جَرَيْت فإنَك النَّكْباء
وتمُدُّ حِلْمك للسّفيه مُدارياً
حتّى يضيق بِعرْضك السُّفهاء
والرأي لم يُنْضَ المهنّد دونه
كالسيف لم تُضْرب به الآراء».
وفي حين اكتفى شوقي بالبيت الآتي موجِزاً باقتدار قدْراً من لُباب الرسالة المحمديّة:
«أنصفتَ أهل الفقر من أهل الغنى
فالكلّ في حقّ الحياة سواء».
توسّع الجواهري في موضوعة التحول هذه، فقال:
«سبحان آلاء الشعوب فإنّها
لَتُقَلِّبُ الأيامَ كيف تشاء
والله في همم الرّجال وإنْ رمى
رُجَمَ الظُّنون وشعْوذ الجُهلاء
المحكمو أسرَ الشعوب تبدّلتْ
دولٌ بهم فإذا هُمُ الأُسراء
وإذا العبيد النائمون على العصا
ناهونَ في أوطانهمْ أُمراءُ
وإذا بحكْم الأخرقينَ كما انبرتْ
حمقاءُ تنقض غزْلَها خَرْقاء».

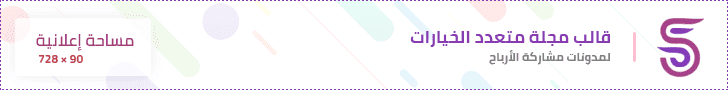
إرسال تعليق