في كتاب جديد للباحث السوري محمد عبده
التحليل النفسي لشخصية نزار قباني
يتمتع بتماسك نفسي وقادر على حشد جهوده لخدمة غرضه
مدفوع بغرائزه الصاخبة ويميل للانطواء والعيش بعيدا
تواق للحصول على الشهرة والثورة والقوة وحب النساء
كان ذكيا في استخدام الألفاظ وخطابه يدخل النفس دون تعقيد
التحليل النفسي لشخصية نزار قباني
بقلم : جهاد فاضل ..
في كتاب حديث صادر عن «منتدى المعارف» في بيروت، يتصدى الباحث السوري سمير عبده لعملية تحليل نفسي لشخصية الشاعر الكبير الراحل نزار قباني. ويبدو أن الباحث ندب نفسه لهكذا دراسات أو تحليلات إذ يقول في مقدمة كتابه: «كان أول كتبنا في هذا الحقل التحليل النفسي لشخصية جمال عبدالناصر في عام 1992، وكتابنا الثاني، التحليل النفسي لشخصية أنور السادات في عام 1996، وقد صدرا في القاهرة، أما كتابنا الثالث الذي صدر في دمشق، فبعنوان «التحليل النفسي لشخصيات سياسية عربية»، في عام 1998، وفيه حللنا شخصيات ميشيل عفلق، أنطون سعادة، اللواء محمد نجيب، الملك فاروق الأول، حسني الزعيم، عبدالكريم قاسم، فارس الخوري، كمال جنبلاط، المشير عبدالحكيم عامر، أكرم الحوراني».
على أن هناك أسماء أخرى بارزة حللها الباحث نفسيًا أيضًا غير التي زكرها أعلاه، إذ يضيف في مقدمة كتاب: "ولم يُسمح لنا بطباعة كتابنا "التحليل النفسي لزعماء وسياسيين عرب" وهو يتضمن تحليلاً لشخصية صدام حسين، ياسر عرفات، الحبيب بورقيبة، الحسن الثاني وطبع في القاهرة في عام 2005".
ولم يقنع الباحث بما حلّل وبمن حلل لأن له كتبًا أخرى في التحليل النفسي يشير إليها في مقدمته هذه: «هذا ما خص الشخصيات السياسية. وهناك كتاب لنا يتضمن التحليل النفسي لجنون غي دوموباسان، وهو أحد أشهر كتاب القصة في العالم، وقد صدر في القاهرة. وهناك كتابنا الآخر، التحليل النفسي لشخصية أم كلثوم.. هذا بالإضافة إلى تحليلات أخرى صدرت بكتب عدة تناولت كثيرًا من أمورنا الحياتية، فكان أن تناولناها بالتحليل مثل «التحليل النفسي» للانتهازية». هذه الكتب وغيرها حاولنا بها أن نلقي الضوء على الحياة النفسية للذين تناولناهم، مخترقين «تابو» الممنوعات في سير هؤلاء الناس».
من كل ذلك يتبين أن الباحث محترف «تحليل نفسي» ولكن المشكلة أن الباحث لا يشير إلى مؤهلاته في التحليل النفسي وفي علم النفس بوجه عام، ومثل هذه الإشارة ضرورية من أجل أن يطمئن القارئ إلى دقة ورصانة أحكام الباحث واستنادها إلى علم ومنهجية، خاصة أن مروحة تحليلاته مروحة واسعة، إذ تشمل سياسيين كما تشمل أدباء وشعراء. فهل تحليلاته تستند إلى علم ومنهج، أم أنها وليدة قراءات وثقافة عامة وانطباعات بالدرجة الأولى؟ يبدو أن تحليلاته تستند إلى مطالعات شخصية لا إلى «مختبر» وأدوات مخبرية، بصرف النظر عن صحتها أو عدم صحتها. ويبقى أن على القارئ أن يظل حذرًا لأن مجال هذا النوع من الدراسات تحوطه صعاب وعثرات وتحديات شتى ليست سهلة حتى على العلماء المتخصصين، فكيف لمن هو غير متخصص أصلًا؟.
على أن الباحث - أي باحث- وإن لم يتخصص أصلًا بعلم النفس، ولم يمارس التحليل النفسي في مختبرات ومعامل متخصصة بالأمراض والانحرافات النفسية، لا يعدم أن يخرج، عند دراسته لسيرة ما، بملاحظات ذات شأن في «شأن» صاحب هذه السيرة، يرشده إليها حدسه واستقراؤه واستبطانه لها، كما ترشده ثقافته العامة وكذلك عودته إلى هذا العلم أو ذاك، وهذا هو الشائع مبدئيًا في بلداننا بوجه عام، ولو أنه غير شائع في بلدان الحضارة حيث التخصص وحيث النأي بالنفس مما ليست النفس مهيأة له في الأساس.
كتاب سمير عبده «التحليل النفسي لشخصية نزار قباني حافل بآراء علماء نفس مرموقين مثل فرويد ويونج فالباحث يعود إليهما كما يعود إلى سواهما من علماء النفس لكي يؤيد وجهات نظره في تحليل شخصية نزار. فلا ينقصه لهذه الجهة مثل هذه العودة إلى الأدبيات المعروفة في علم النفس. وهو يحصر همه، في الكتاب عن نزار، في بسط آرائه حول جانبين في شعر نزار: جانب الشعر العاطفي الذي بدع فيه الشاعر، وجانب الشعر السياسي الذي كان مثار جدل صاخب بين دارسيه ومتلقيه. وقد كان للشاعر موقف من هذا الشعر في السنوات القليلة التي سبقت رحيله إذ أعلن في حوار له مع مجلة الهلال المصرية أنه طلق تمامًا هذا الجانب في شعره وأنه لن يخطّ بعد اليوم بيتًا واحدًا فيه. ونعرض فيما يلي لآراء الباحث في شخصية نزار قباني.
في شخصية نزار يرى الباحث تماسكًا نفسانيًا عميقًا، وقدرة على حشد جهوده كلها، الواعية وغير الواعية، لخدمة غرض واحد، أما كيف يتم ذلك، ولماذا يستطيع بعض الأشخاص أداءه على أحسن وجه. فالأمر لا يزال سرًّا.
صفة أخرى بارزة في أعمال نزار هي القدرة على ملاحظة العلاقة النمطية بين الأشياء.
وهناك من رأى أن الإثارة عند نزار أصبحت هي الغاية، إن لم تكن هي الموضوع كله، مهما تكن النتائج، ولذلك كثر إلحاحه وتكراره لموضوعات بعينها، ما أفقد الشاعر طابع الجدة والطرافة في المبنى والمعنى، والشكل والمضمون. وانعكس هذا على قاموسه الشعري حتى غدت أشعاره تدور في فلك بعينه يبهر القارئ غير المتذوق للشعر عند الوهلة الأولى.
ولكن شئنا أم أبينا، فإن نزار شاعر كبير يمتلك ناصية الشعر وسهولة التعبير وعبقرية التوصيل، أحببناه أم كرهناه، اختلفنا معه أم اتفقنا. كل هذا لا ينفي أنه شاعر كبير.
ولكن كيف ننظر إلى شعر نزار ومدى تطابقه مع شخصيته؟ أهو الشعر الذي يأخذ معيار الفن للفن كما أوجده الشاعر الفرنسي تيوفيل جوتيه، أم أن الشعر تصوير ناطق، بينما الرسم شعر صامت، كما قال الشاعر الغنائي اليوناني سيمونيدس؟.
أعطى نزار للواقعية بعدًا فنيًا، والإبداع عنده كان محاولة مستمرة للبحث عن الجمال، وتبقى أداته إنسانية وليست سحرية، بمعنى أن حدسه فقط هو الذي ينقله من إلى ما هو يمكن له، وليس إعجازه أو طلاسمه.
وإذا كان الأدب العربي منذ عصر النهضة يزخر بأفراد أبطال يودون التهام العالم: فاوست الذي يود التهام كل المعرفة، ودون جوان الذي يود التهام كل النساء، فإن دون كيشوت الذي لا يزال يبحث عن الفضيلة، ويتحرك في عالم من القيم التقليدية، تحول إلى شخصية مأساوية ملهاوية، يقول نزار قباني: إنني لا أدعي أنني نابوليون بونابرت الشعر، لا أدعي أنني فتحت العالم، لكنني أقول بكثير من الغرور وقليل من التواضع أنني جعلت الشعر خبزًا شعبيًا يأكله الجميع، وعملة رائجة يتداولها الجميع، وإنني استطعت أن اخترق بشعري حواجز اللغة كلها، وحواجز البلاغة القديمة، والقوالب الجاهزة، وأسوار القواميس العالية، مخترقًا بذلك جدار الخوف الذي كان يقوم بين الناس والشعر، واكتشفت أن شعر الشاعر لا يعبر إلا عن عشرة بالمائة من فكره، أما التسعون في المائة الباقية فلا تقال إلا نثرًا.
ولكن أين القباني بين العباقرة؟
يقول الباحث إذا كان هناك من عدّ نزار قباني شهيرًا إعلاميًا أكثر من كونه شاعرًا كبيرًا، فإن هذه المقارنة غير صحيحة. لقد شغل الشاعر مناصب دبلوماسية رفيعة، لكنه بقي الشاعر المجيد المخلص لشعره، ما أكسبه رضا جمهوره، يتداول قصائده مثل الفيتامين لمحرماته، مزيحًا كثيرًا من كوابيسه.
ومن دراسة تاريخ حياة القباني نستطيع تبرير سبب نبوغه في ميدان شعري من دون آخر، ونستطيع تفسير طبيعة إنتاجه وهواياته واتجاهاته وفلسفته في الحياة.
ليس لنزار قباني من «أمراض نفسية» بالمعنى الأشد للكلمة، وربما أمكن القول عنها أنها «عرض» نفسي فيما يخص الفتيشية» و«السادومازوخية» والتظاهر بحب الذات. صحيح أنها أمراض نفسية، لكن التعرض الشديد لها يجعلها كذلك، بينما مظاهرها تبدو أحيانًا عند معظمنا في مرحلة من مراحل العمل، لكن نزار بدا دائمًا لمعجبيه الفارس الذي يمتطي حصانًا أبيضَ، ونال عطفًا كبيرًا من قرّائه بعد فقده ولده توفيق وزوجته بلقيس بالشكل المأساوي الذي قتلت به حيث نظم أفضل قصائده.
وإذا كان نزار قباني شبيهًا بالعصابي من حيث ميله إلى الانطواء، أي العيش بعيدًا عن الغير، فهو في الواقع غير بعيد من الإصابة بالعصاب. فهو مدفوع بغرائزه الصاخبة، وتواق إلى الحصول على الشرف والقوة والثروة والشهرة وحب النساء. لكنه لا يملك الوسائل الضرورية للوصول إلى هذه الأهداف، لذلك فهو يقلب للحقيقة ظهر المجن، ويحول رغباته وطاقاته الجنسية (الليبيدو) لخلق رغباته والتعبير عنها في الخيال، إلا أنه لا يجد طريق العودة في النهاية إلى الحقيقة. ويرى لانجفيلد أن العصابية من مستلزمات الإبداع سواء في الشعر أو الأدب أو الفن، فأين نزار قباني منها؟.
إنه يهدف إلى حياة أكثر حرارة في الألم، ويدفع بعواطفه بقوة نحو ذروتها، ويرفض أن يتبلور وأن يعكس على وجوهه كلها حركة الضجة، بل يتمسك بأن يبقى جمرة تلتهم نفسها لكي يقوم من الموت كل يوم، ويجد دائمًا قوى أوفر وتناقضات أكثر عنفًا، إنه لا يود أن يوجه حياته، بل يود أن يحسها ويشعر بها.
حول المرأة يقول سمير عبده إنها كانت شغل نزار الشاغل يتفنن في توصيفاتها ويتخيلها كما يريد له خياله، ويصورها كما يجمح به فكره.
كان ذكيًا جدًا في استخدام الألفاظ البسيطة جدًا في خطابه الشعري الذي يدخل النفس مباشرة من دون أي تعقيدات، مرددًا كلمات عادية يتداولها الناس في الشارع والبيت:
قد نلتقي في نجمة
زرقاء، لا تبعدي
تصوري ماذا يكون العمر
لو لم توجدي!
وبعد الأم التي كانت علاقته بها علاقة فرضية، والأخت التي انتحرت، وذلك في حياته الطفولية، جاء دور الزوجة التي هي زهراء التي أنجبت له من الأبناء توفيق وهدباء. فجع نزار بفقدان ابنه توفيق حين كان لا يزال يدرس الطب إثر جراحة فاشلة في القلب، وقامت هدباء بدور الأم باتقان، ليس فقط بالنسبة لعائلتها، ولكن أيضًا لعمر وزينب، أخويها من أبيها اللذين أنجبهما من بلقيس الراوي.
من خلال تحليل شخصية نزار قباني يكشف النقاب عن العوارض النفسية التي لازمته، أمّ أسرفت في حنانها عليه إلى أن جعلته «فتيشيًا» وأخت انتحرت لعدم تمكنها من اللحاق بحبيبها، وزوجة أحبها حبًا كبيرًا وفجأة تقتل غدرًا، فكان أن أكمل قصائده التي بدأها بـ«طفولة نهد» إلى بلقيس.
وقد بقي شعر الغزل قمة شعره، ذلك أن الصدق المحض ومطاوعة النفس والقدر تتجلى في هذا الشعر الأخير، ومرد ذلك على الأغلب إلى كون التجربة النزارية في الأساس تجربة عاطفية لا تجربة قومية أو وطنية:
حبك يا عميقة العينين
تطرّف
تصوّف
عبادة
حبّك مثل الموت والولادة
صعب بأن يعاد مرتين
بهذه الكلمات يشعر نزار المرأة بتعطشها للحب كما تتعطش السمكة للماء فوق مائدة المطبخ. إن ثلاثة من كلمات الغزل كافية أن تجعلها أسيرة المرء الآتي حديثًا، إنه واثق من ذلك، وسوف تكون رفيقة فاتنة :
إني خيرتك فاختاري
ما بين الموت على صدري
أو فوق دفاتر أشعاري
اختاري الحب أو اللاحب
فجبن أن لا تختاري..
لا توجد منطقة وسطى
ما بين الجنة والنار!
ولكن ما هي «الفتيشية» التي يفسر بها الباحث شخصية نزار؟
يقول إنها من «الفتيش" FETISH وهو الشيء الذي تنسب إليه قوة سحرية أو روح تستطيع أن تحفظ الإنسان الذي يملك هذا الشيء وتقيه من الأخطار وتقضي له الحاجات. وقد استخدم فرويد هذا اللفظ ليعبر عن نوع من الانحراف الجنسي يتميز بحدوث التهيج الجنسي من رؤية جزء من بدن الشخص المحبوب، أو شيء آخر يتعلق به مثل ملابسه أو منديله وكأن ذلك الجزء من البدن، أو ذلك الشيء، أصبح فتيشًا، أي رمزًا للشخص المحبوب.
حاول نزار التعويض في الفتيشة التي لازمته بأن يعوض عنها بالحماسة الشديدة واتباع خطة مستمرة للوصول إلى هدفه عبر رموزه بالنهد، وتسلح برغبة عارمة للنجاح في هذا التعويض عن طريق الشعر.
فعندما تتحرك الرغبة أو الحاجة إلى شيء يصحبها انفعال عاطفي قد يكون سارًا في حالة إشباعها، أو مؤلمًا في حالة الحرمان منها. وبمرور الوقت تصبح العاطفة تلك مصدرًا نفسيًا لدافع جديد يؤثر في سلوك الشخص.
وتكثر النهود في شعره. كان النهد هو الشغل الشاغل في الكثير من قصائده العاطفية:
ما هو المطلوب مني؟
يشهد الله بأني
قد تفرغت لنهديك تمامًا
وتصرفت كفنان بدائي
فأنهكت وأوجعت الرخاما
إنني منذ عصور الرقّ ما نلت إجازة
فأنا أعمل نحاتًا بلا أجر لدى نهديك
منذ كنتُ غلامًا
أحمل الرمل على ظهري
وألقيه ببحر اللانهاية.
إن علاقته بالنهود في غمار سيرته الحياتية تعود حين ذكر تدليل أمه الزائد له، حتى إنه كان يرضع من ثدييها حتى سن الثامنة من العمر:
وجذبت منها الجسم لم تنفر ولم تتكلم
مخمورة مالت علي بقدها المتهدم
ومضت تعللني بهذا الطافر المتكوّم
وتقول في سكر معربدة بأرشق مبسم
يا شاعري! لم ألق في العشرين من لم يفطم!
كانت والدة نزار امرأة وأمًا لا تريد لابنها أن يفارقها أبدًا حتى بعد أن انقضت سنوات طفولته سريعًا وتخرج من كلية الحقوق والتحق بالسلك الدبلوماسي.
كل النساء اللواتي عرفتهن
أحببني وهن صاحيات
وحدها أمي
أحبتني وهي سكرى
والحب الحقيقي هو أن تسكر
ولا تعرف لماذا تسكر
إن خيالات الحب، كما يرى الباحث، تمرّ بعقول الناس جميعًا، إنها تنبع من حاجاتنا اللاشعورية العميقة. وكثيرًا ما تهاجمنا هذه الخيالات فتثير الدهشة في نفوسنا، ولذلك ينبغي ألا تكون استجاباتنا لمثل هذه الخيالات هي الشعور بالذنب، أفضل من ذلك بكثير أن نحاول فهمها.
لماذا مرت هذه الخيالات بعقلنا في هذا الوقت بالذات؟ ولماذا تركزت حول هذه الناحية بالذات؟ ولماذا أخذت هذا الوضع من دون غيره من الأوضاع؟.
من الممكن للخيالات التي ركز عليها القباني أن تنبع من الإحساس بالنقص، ومن المخاوف العامة والقلق، وكثيرًا ما تكون نتيجة الإحساس بالوحدة. وفي هذه الحالة يفسر الحب باعتباره وسيلة من وسائل الاتصال، ورابطة إنسانية وثيقة فشل نزار في تحقيقها على أرض الواقع، فراح ينشدها في خيالات شعره.
إن «فتيشية» نزار بتعلقه بأمه تبدو نوعًا مرضيًا بنظر الباحث، وليس طبيعيًا، على أنه عاشر المرأة وتزوج مرتين وهو ما يستبعد أن تكون والدته قد عقدته من خلال قربها منه، لهذا كان النهد له متنفسًا ليقول ما يقول رمزيًا عما بداخله تجاه والدته، وهو استعمال مرضِيّ في ترديده النهد في معظم قصائده الغزلية.

التحليل النفسي لشخصية نزار قباني
يتمتع بتماسك نفسي وقادر على حشد جهوده لخدمة غرضه
مدفوع بغرائزه الصاخبة ويميل للانطواء والعيش بعيدا
تواق للحصول على الشهرة والثورة والقوة وحب النساء
كان ذكيا في استخدام الألفاظ وخطابه يدخل النفس دون تعقيد
التحليل النفسي لشخصية نزار قباني
بقلم : جهاد فاضل ..
في كتاب حديث صادر عن «منتدى المعارف» في بيروت، يتصدى الباحث السوري سمير عبده لعملية تحليل نفسي لشخصية الشاعر الكبير الراحل نزار قباني. ويبدو أن الباحث ندب نفسه لهكذا دراسات أو تحليلات إذ يقول في مقدمة كتابه: «كان أول كتبنا في هذا الحقل التحليل النفسي لشخصية جمال عبدالناصر في عام 1992، وكتابنا الثاني، التحليل النفسي لشخصية أنور السادات في عام 1996، وقد صدرا في القاهرة، أما كتابنا الثالث الذي صدر في دمشق، فبعنوان «التحليل النفسي لشخصيات سياسية عربية»، في عام 1998، وفيه حللنا شخصيات ميشيل عفلق، أنطون سعادة، اللواء محمد نجيب، الملك فاروق الأول، حسني الزعيم، عبدالكريم قاسم، فارس الخوري، كمال جنبلاط، المشير عبدالحكيم عامر، أكرم الحوراني».
على أن هناك أسماء أخرى بارزة حللها الباحث نفسيًا أيضًا غير التي زكرها أعلاه، إذ يضيف في مقدمة كتاب: "ولم يُسمح لنا بطباعة كتابنا "التحليل النفسي لزعماء وسياسيين عرب" وهو يتضمن تحليلاً لشخصية صدام حسين، ياسر عرفات، الحبيب بورقيبة، الحسن الثاني وطبع في القاهرة في عام 2005".
ولم يقنع الباحث بما حلّل وبمن حلل لأن له كتبًا أخرى في التحليل النفسي يشير إليها في مقدمته هذه: «هذا ما خص الشخصيات السياسية. وهناك كتاب لنا يتضمن التحليل النفسي لجنون غي دوموباسان، وهو أحد أشهر كتاب القصة في العالم، وقد صدر في القاهرة. وهناك كتابنا الآخر، التحليل النفسي لشخصية أم كلثوم.. هذا بالإضافة إلى تحليلات أخرى صدرت بكتب عدة تناولت كثيرًا من أمورنا الحياتية، فكان أن تناولناها بالتحليل مثل «التحليل النفسي» للانتهازية». هذه الكتب وغيرها حاولنا بها أن نلقي الضوء على الحياة النفسية للذين تناولناهم، مخترقين «تابو» الممنوعات في سير هؤلاء الناس».
من كل ذلك يتبين أن الباحث محترف «تحليل نفسي» ولكن المشكلة أن الباحث لا يشير إلى مؤهلاته في التحليل النفسي وفي علم النفس بوجه عام، ومثل هذه الإشارة ضرورية من أجل أن يطمئن القارئ إلى دقة ورصانة أحكام الباحث واستنادها إلى علم ومنهجية، خاصة أن مروحة تحليلاته مروحة واسعة، إذ تشمل سياسيين كما تشمل أدباء وشعراء. فهل تحليلاته تستند إلى علم ومنهج، أم أنها وليدة قراءات وثقافة عامة وانطباعات بالدرجة الأولى؟ يبدو أن تحليلاته تستند إلى مطالعات شخصية لا إلى «مختبر» وأدوات مخبرية، بصرف النظر عن صحتها أو عدم صحتها. ويبقى أن على القارئ أن يظل حذرًا لأن مجال هذا النوع من الدراسات تحوطه صعاب وعثرات وتحديات شتى ليست سهلة حتى على العلماء المتخصصين، فكيف لمن هو غير متخصص أصلًا؟.
على أن الباحث - أي باحث- وإن لم يتخصص أصلًا بعلم النفس، ولم يمارس التحليل النفسي في مختبرات ومعامل متخصصة بالأمراض والانحرافات النفسية، لا يعدم أن يخرج، عند دراسته لسيرة ما، بملاحظات ذات شأن في «شأن» صاحب هذه السيرة، يرشده إليها حدسه واستقراؤه واستبطانه لها، كما ترشده ثقافته العامة وكذلك عودته إلى هذا العلم أو ذاك، وهذا هو الشائع مبدئيًا في بلداننا بوجه عام، ولو أنه غير شائع في بلدان الحضارة حيث التخصص وحيث النأي بالنفس مما ليست النفس مهيأة له في الأساس.
كتاب سمير عبده «التحليل النفسي لشخصية نزار قباني حافل بآراء علماء نفس مرموقين مثل فرويد ويونج فالباحث يعود إليهما كما يعود إلى سواهما من علماء النفس لكي يؤيد وجهات نظره في تحليل شخصية نزار. فلا ينقصه لهذه الجهة مثل هذه العودة إلى الأدبيات المعروفة في علم النفس. وهو يحصر همه، في الكتاب عن نزار، في بسط آرائه حول جانبين في شعر نزار: جانب الشعر العاطفي الذي بدع فيه الشاعر، وجانب الشعر السياسي الذي كان مثار جدل صاخب بين دارسيه ومتلقيه. وقد كان للشاعر موقف من هذا الشعر في السنوات القليلة التي سبقت رحيله إذ أعلن في حوار له مع مجلة الهلال المصرية أنه طلق تمامًا هذا الجانب في شعره وأنه لن يخطّ بعد اليوم بيتًا واحدًا فيه. ونعرض فيما يلي لآراء الباحث في شخصية نزار قباني.
في شخصية نزار يرى الباحث تماسكًا نفسانيًا عميقًا، وقدرة على حشد جهوده كلها، الواعية وغير الواعية، لخدمة غرض واحد، أما كيف يتم ذلك، ولماذا يستطيع بعض الأشخاص أداءه على أحسن وجه. فالأمر لا يزال سرًّا.
صفة أخرى بارزة في أعمال نزار هي القدرة على ملاحظة العلاقة النمطية بين الأشياء.
وهناك من رأى أن الإثارة عند نزار أصبحت هي الغاية، إن لم تكن هي الموضوع كله، مهما تكن النتائج، ولذلك كثر إلحاحه وتكراره لموضوعات بعينها، ما أفقد الشاعر طابع الجدة والطرافة في المبنى والمعنى، والشكل والمضمون. وانعكس هذا على قاموسه الشعري حتى غدت أشعاره تدور في فلك بعينه يبهر القارئ غير المتذوق للشعر عند الوهلة الأولى.
ولكن شئنا أم أبينا، فإن نزار شاعر كبير يمتلك ناصية الشعر وسهولة التعبير وعبقرية التوصيل، أحببناه أم كرهناه، اختلفنا معه أم اتفقنا. كل هذا لا ينفي أنه شاعر كبير.
ولكن كيف ننظر إلى شعر نزار ومدى تطابقه مع شخصيته؟ أهو الشعر الذي يأخذ معيار الفن للفن كما أوجده الشاعر الفرنسي تيوفيل جوتيه، أم أن الشعر تصوير ناطق، بينما الرسم شعر صامت، كما قال الشاعر الغنائي اليوناني سيمونيدس؟.
أعطى نزار للواقعية بعدًا فنيًا، والإبداع عنده كان محاولة مستمرة للبحث عن الجمال، وتبقى أداته إنسانية وليست سحرية، بمعنى أن حدسه فقط هو الذي ينقله من إلى ما هو يمكن له، وليس إعجازه أو طلاسمه.
وإذا كان الأدب العربي منذ عصر النهضة يزخر بأفراد أبطال يودون التهام العالم: فاوست الذي يود التهام كل المعرفة، ودون جوان الذي يود التهام كل النساء، فإن دون كيشوت الذي لا يزال يبحث عن الفضيلة، ويتحرك في عالم من القيم التقليدية، تحول إلى شخصية مأساوية ملهاوية، يقول نزار قباني: إنني لا أدعي أنني نابوليون بونابرت الشعر، لا أدعي أنني فتحت العالم، لكنني أقول بكثير من الغرور وقليل من التواضع أنني جعلت الشعر خبزًا شعبيًا يأكله الجميع، وعملة رائجة يتداولها الجميع، وإنني استطعت أن اخترق بشعري حواجز اللغة كلها، وحواجز البلاغة القديمة، والقوالب الجاهزة، وأسوار القواميس العالية، مخترقًا بذلك جدار الخوف الذي كان يقوم بين الناس والشعر، واكتشفت أن شعر الشاعر لا يعبر إلا عن عشرة بالمائة من فكره، أما التسعون في المائة الباقية فلا تقال إلا نثرًا.
ولكن أين القباني بين العباقرة؟
يقول الباحث إذا كان هناك من عدّ نزار قباني شهيرًا إعلاميًا أكثر من كونه شاعرًا كبيرًا، فإن هذه المقارنة غير صحيحة. لقد شغل الشاعر مناصب دبلوماسية رفيعة، لكنه بقي الشاعر المجيد المخلص لشعره، ما أكسبه رضا جمهوره، يتداول قصائده مثل الفيتامين لمحرماته، مزيحًا كثيرًا من كوابيسه.
ومن دراسة تاريخ حياة القباني نستطيع تبرير سبب نبوغه في ميدان شعري من دون آخر، ونستطيع تفسير طبيعة إنتاجه وهواياته واتجاهاته وفلسفته في الحياة.
ليس لنزار قباني من «أمراض نفسية» بالمعنى الأشد للكلمة، وربما أمكن القول عنها أنها «عرض» نفسي فيما يخص الفتيشية» و«السادومازوخية» والتظاهر بحب الذات. صحيح أنها أمراض نفسية، لكن التعرض الشديد لها يجعلها كذلك، بينما مظاهرها تبدو أحيانًا عند معظمنا في مرحلة من مراحل العمل، لكن نزار بدا دائمًا لمعجبيه الفارس الذي يمتطي حصانًا أبيضَ، ونال عطفًا كبيرًا من قرّائه بعد فقده ولده توفيق وزوجته بلقيس بالشكل المأساوي الذي قتلت به حيث نظم أفضل قصائده.
وإذا كان نزار قباني شبيهًا بالعصابي من حيث ميله إلى الانطواء، أي العيش بعيدًا عن الغير، فهو في الواقع غير بعيد من الإصابة بالعصاب. فهو مدفوع بغرائزه الصاخبة، وتواق إلى الحصول على الشرف والقوة والثروة والشهرة وحب النساء. لكنه لا يملك الوسائل الضرورية للوصول إلى هذه الأهداف، لذلك فهو يقلب للحقيقة ظهر المجن، ويحول رغباته وطاقاته الجنسية (الليبيدو) لخلق رغباته والتعبير عنها في الخيال، إلا أنه لا يجد طريق العودة في النهاية إلى الحقيقة. ويرى لانجفيلد أن العصابية من مستلزمات الإبداع سواء في الشعر أو الأدب أو الفن، فأين نزار قباني منها؟.
إنه يهدف إلى حياة أكثر حرارة في الألم، ويدفع بعواطفه بقوة نحو ذروتها، ويرفض أن يتبلور وأن يعكس على وجوهه كلها حركة الضجة، بل يتمسك بأن يبقى جمرة تلتهم نفسها لكي يقوم من الموت كل يوم، ويجد دائمًا قوى أوفر وتناقضات أكثر عنفًا، إنه لا يود أن يوجه حياته، بل يود أن يحسها ويشعر بها.
حول المرأة يقول سمير عبده إنها كانت شغل نزار الشاغل يتفنن في توصيفاتها ويتخيلها كما يريد له خياله، ويصورها كما يجمح به فكره.
كان ذكيًا جدًا في استخدام الألفاظ البسيطة جدًا في خطابه الشعري الذي يدخل النفس مباشرة من دون أي تعقيدات، مرددًا كلمات عادية يتداولها الناس في الشارع والبيت:
قد نلتقي في نجمة
زرقاء، لا تبعدي
تصوري ماذا يكون العمر
لو لم توجدي!
وبعد الأم التي كانت علاقته بها علاقة فرضية، والأخت التي انتحرت، وذلك في حياته الطفولية، جاء دور الزوجة التي هي زهراء التي أنجبت له من الأبناء توفيق وهدباء. فجع نزار بفقدان ابنه توفيق حين كان لا يزال يدرس الطب إثر جراحة فاشلة في القلب، وقامت هدباء بدور الأم باتقان، ليس فقط بالنسبة لعائلتها، ولكن أيضًا لعمر وزينب، أخويها من أبيها اللذين أنجبهما من بلقيس الراوي.
من خلال تحليل شخصية نزار قباني يكشف النقاب عن العوارض النفسية التي لازمته، أمّ أسرفت في حنانها عليه إلى أن جعلته «فتيشيًا» وأخت انتحرت لعدم تمكنها من اللحاق بحبيبها، وزوجة أحبها حبًا كبيرًا وفجأة تقتل غدرًا، فكان أن أكمل قصائده التي بدأها بـ«طفولة نهد» إلى بلقيس.
وقد بقي شعر الغزل قمة شعره، ذلك أن الصدق المحض ومطاوعة النفس والقدر تتجلى في هذا الشعر الأخير، ومرد ذلك على الأغلب إلى كون التجربة النزارية في الأساس تجربة عاطفية لا تجربة قومية أو وطنية:
حبك يا عميقة العينين
تطرّف
تصوّف
عبادة
حبّك مثل الموت والولادة
صعب بأن يعاد مرتين
بهذه الكلمات يشعر نزار المرأة بتعطشها للحب كما تتعطش السمكة للماء فوق مائدة المطبخ. إن ثلاثة من كلمات الغزل كافية أن تجعلها أسيرة المرء الآتي حديثًا، إنه واثق من ذلك، وسوف تكون رفيقة فاتنة :
إني خيرتك فاختاري
ما بين الموت على صدري
أو فوق دفاتر أشعاري
اختاري الحب أو اللاحب
فجبن أن لا تختاري..
لا توجد منطقة وسطى
ما بين الجنة والنار!
ولكن ما هي «الفتيشية» التي يفسر بها الباحث شخصية نزار؟
يقول إنها من «الفتيش" FETISH وهو الشيء الذي تنسب إليه قوة سحرية أو روح تستطيع أن تحفظ الإنسان الذي يملك هذا الشيء وتقيه من الأخطار وتقضي له الحاجات. وقد استخدم فرويد هذا اللفظ ليعبر عن نوع من الانحراف الجنسي يتميز بحدوث التهيج الجنسي من رؤية جزء من بدن الشخص المحبوب، أو شيء آخر يتعلق به مثل ملابسه أو منديله وكأن ذلك الجزء من البدن، أو ذلك الشيء، أصبح فتيشًا، أي رمزًا للشخص المحبوب.
حاول نزار التعويض في الفتيشة التي لازمته بأن يعوض عنها بالحماسة الشديدة واتباع خطة مستمرة للوصول إلى هدفه عبر رموزه بالنهد، وتسلح برغبة عارمة للنجاح في هذا التعويض عن طريق الشعر.
فعندما تتحرك الرغبة أو الحاجة إلى شيء يصحبها انفعال عاطفي قد يكون سارًا في حالة إشباعها، أو مؤلمًا في حالة الحرمان منها. وبمرور الوقت تصبح العاطفة تلك مصدرًا نفسيًا لدافع جديد يؤثر في سلوك الشخص.
وتكثر النهود في شعره. كان النهد هو الشغل الشاغل في الكثير من قصائده العاطفية:
ما هو المطلوب مني؟
يشهد الله بأني
قد تفرغت لنهديك تمامًا
وتصرفت كفنان بدائي
فأنهكت وأوجعت الرخاما
إنني منذ عصور الرقّ ما نلت إجازة
فأنا أعمل نحاتًا بلا أجر لدى نهديك
منذ كنتُ غلامًا
أحمل الرمل على ظهري
وألقيه ببحر اللانهاية.
إن علاقته بالنهود في غمار سيرته الحياتية تعود حين ذكر تدليل أمه الزائد له، حتى إنه كان يرضع من ثدييها حتى سن الثامنة من العمر:
وجذبت منها الجسم لم تنفر ولم تتكلم
مخمورة مالت علي بقدها المتهدم
ومضت تعللني بهذا الطافر المتكوّم
وتقول في سكر معربدة بأرشق مبسم
يا شاعري! لم ألق في العشرين من لم يفطم!
كانت والدة نزار امرأة وأمًا لا تريد لابنها أن يفارقها أبدًا حتى بعد أن انقضت سنوات طفولته سريعًا وتخرج من كلية الحقوق والتحق بالسلك الدبلوماسي.
كل النساء اللواتي عرفتهن
أحببني وهن صاحيات
وحدها أمي
أحبتني وهي سكرى
والحب الحقيقي هو أن تسكر
ولا تعرف لماذا تسكر
إن خيالات الحب، كما يرى الباحث، تمرّ بعقول الناس جميعًا، إنها تنبع من حاجاتنا اللاشعورية العميقة. وكثيرًا ما تهاجمنا هذه الخيالات فتثير الدهشة في نفوسنا، ولذلك ينبغي ألا تكون استجاباتنا لمثل هذه الخيالات هي الشعور بالذنب، أفضل من ذلك بكثير أن نحاول فهمها.
لماذا مرت هذه الخيالات بعقلنا في هذا الوقت بالذات؟ ولماذا تركزت حول هذه الناحية بالذات؟ ولماذا أخذت هذا الوضع من دون غيره من الأوضاع؟.
من الممكن للخيالات التي ركز عليها القباني أن تنبع من الإحساس بالنقص، ومن المخاوف العامة والقلق، وكثيرًا ما تكون نتيجة الإحساس بالوحدة. وفي هذه الحالة يفسر الحب باعتباره وسيلة من وسائل الاتصال، ورابطة إنسانية وثيقة فشل نزار في تحقيقها على أرض الواقع، فراح ينشدها في خيالات شعره.
إن «فتيشية» نزار بتعلقه بأمه تبدو نوعًا مرضيًا بنظر الباحث، وليس طبيعيًا، على أنه عاشر المرأة وتزوج مرتين وهو ما يستبعد أن تكون والدته قد عقدته من خلال قربها منه، لهذا كان النهد له متنفسًا ليقول ما يقول رمزيًا عما بداخله تجاه والدته، وهو استعمال مرضِيّ في ترديده النهد في معظم قصائده الغزلية.


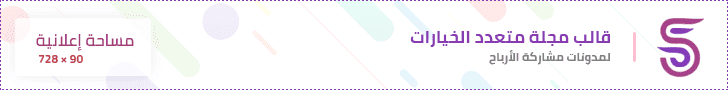
إرسال تعليق