المساجلة : أن تصنع مثل صنيع صاحبك من جري ٍ أو سقي ، وأصله من السَّجْل وهو ( الدلو ) فيها ماء قلَّ أو كثر ، ولا يقال لها وهي فارغة ( سَجْـل )
قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب :
من يساجلني يساجلُ ماجدأ * * * يملأ الدلو إلى عَقْدِ الكَرَبْ
* حكاية المثل :
قال أبو سفيان يوم أحد بعدما وقعت الهزيمة على المسلمين : اعلُ هُبل ! اعلُ هُبل ! ، فقال عمر : يا رسول الله ألا أجيبه ؟! قال : بلى يا عمر ، قال عمر : الله أعلى و أجلَّ ، فقال أبو سفيان : يا ابن الخطاب ..إنه يوم الصّمت يوماً بيوم بدر ، وإن الأيام دُول ، وإن الحرب سِجال ، فقال عمر : ولا سَواء ، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ، فقال أبو سفيان : إنكم لتزعمون ذلك ، لقد خِبنا إذَنْ وخسرنا .
مجمع الأمثال : للميداني ( ج1 / 236 )

فالسجال حسب القاموس اللغوي من المساجلة ،
والمُساجَلة: يعني المُفاخَرة بأن يَصْنَع مثلَ صَنِيعه في جَرْيٍ أَو سقي وأصله من السَّجْل، وهو الدلو فيها ماء قلَّ أو كثر - ولا يقال لها وهي فارغة: سَجْل.
وقال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب:
مَنْ يُساجِلْني يُسَــــاجِلْ ماجِــداً، يَمْــلأُ الدَّلْوَ إِلـــى عَقــْدِ الكَـرَب
أصل المُسَاجَلة أن يَسْتَقِيَ ساقيان فيُخْرج كُل واحد منهما في سَجْله مثل ما يُخْرج الآخر، فأيّهما نَكَل فقد غُلِبَ، فضربته العرب مثلاً للمفاخرة، فإِذا قيل فلان يُساجِل فلاناً، فمعناه أنه يُخْرِج من الشَّرَف مثل ما يُخرِجه الآخرُ، فأيهما نَكَل فقد غُلِب.
وقال أبو سُفيان يوم أُحد بعدما وقعت الهزيمة على المسلمين: أعْلُ هَبَلُ، أعْلُ هُبَلُ! فقال عمر: يا رسول الله ألا أجيبه؟ قال: بلى يا عُمر. قال عمر: الله أعلى وأجَلُّ! فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب، إنه يوم الصَّمْت، يوماً بيوم بدر، وإن الأيام دُوَل، وإن الحرب سجال. فقال عمر: ولا سَوَاء، قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار.
فقال أبو سفيان: إنكم لتزعمون ذلك، لقد خِبْنا إذن وخَسِرْنا!
وفي حديث أبي سفيان أن هِرقل سأله عن الحرب بينه وبين النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال له: الحَرْب بيننا سِجَالٌ؛ معناه إنا نُدَالُ عليه مَرَّة ويُدَالُ علينا أخرى، قال: وأصله أن المُسْتَقِيَين بسَجْلَين من البئر يكون لكل واحد منهما سَجْلٌ أي دَلوٌ ملأى ماء.
السَّجْلُ: الدَّلْو الضَّخْمَة المملوءةُ ماءً، مُذَكَّر، وقيل: هو مِلْؤُها، وقيل: إذا كان فيه ماء قَلَّ أو كَثُر، والجمع سِجالٌ وسُجُول، ولا يقال لها فارغة سَجْلٌ ولكن دَلْو؛ وقيل: لا يقال له وهو فارغ سَجْلٌ ولا ذَنُوب؛ قال الشاعر:
السَّجْلُ والنُّطْفَـــــة والذَّنُـــوب، حَتــَّى تَــرَى مَرْكُوَّهـــــــا يَثُــوب
وأنشد ابن الأعرابي:
أُرَجِــّي نائــلاً مــن سَــــيْبِ رَبٍّ، لــه نُعْمَـــى وذَمَّتُـــــه سِــــجَالُ
قال: والذَّمَّة البئر القليلة الماء.
والسَّجْل: الدَّلْو المَلأى، والمعنى قَلِيله كثير، وأسْجَله: أعطاه سَجْلاً أو سَجْلَين، وقالوا: الحروب سِجَالٌ أي سَجْلٌ منها على هؤلاء وآخر على هؤلاء..
وقال ابن الرومي:
قُلْ لأيـــوبَ والكـــلامُ ســــجالُ والجــوابات ذاتَ يـــــومٍ تُــدالُ
اسكتوا بعدَهـا فلا تذكـروا الشْـ شُــؤم حيـــاً فأنتُــــمُ الآجـــــالُ
وانسَجل الماءُ انسجالاً إِذا انْصَبَّ؛ وأسْجلْت الحوض: مَلأْته، وأَسْجَل الرجلُ: كثُر خيرُه.
وأَسْجَلَ الناسَ: ترَكَهم، وأَسْجَلَ لهم الأَمرَ: أطلقه لهم؛ والسَّجِيلُ: الصُّلْب الشديد.
وفي التنزيل العزيز: «ترْمِيهم بحِجارة من سِجِّيل»، وقيل: هو حجر من طين، مُعَرَّب دَخِيل، قال الله تعالى: «كَلاَّ إِن كتاب الفُجَّار لَفِي سِجِّينٍ وما أدراك ما سِجِّينٌ كتابٌ مَرْقومٌ»؛ وسِجِّيل في معنى سِجِّين، المعنى أنها حجارة مما كَتَب الله تعالى أنه يُعَذبهم بها؛ وقيل في حجارة من سِجِّيل إنها حجارة من طين طُبِخَتْ بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم لقوله عز وجل: لنُرْسِل عليهم حجارة من طين.
الأخطل:
حيِّ المنازِلَ بَينَ السّفْحِ والرُّحَــبِ لمْ يَبْقَ غَيرُ وُشــومِ النّارِ والحطبِ
وعقرٍ خالـــــداتٍ حـــولَ قُبتهــا وطامسٍ حبشي اللونِ ذي طببِ
وغيرُ نؤيٍ قديمِِ الأثـــرِ، ذي ثلــمٍ ومستكينٍ أميمٍ الرَّأسِ مســــتلب
تعتادُها كلُّ مثلاةٍ وما فقـــــدت عَرْفاءُ مِنْ مُورِها مجنونَــةُ الأدبِ
ومظلمِ تعملُ الشــــكوى حواملــــُهْ مستفرغٍ من سجالِ العينِ منشطبِ
-كما أن السجال بمعنى الجدال والمناظرة، وهذا هو الجاري لدى الكتاب في مقالاتهم وأبحاثهم، ومن هذا ما يقول آخر: اشتد "السجال" بين الأطراف كافة، وهذا شيء فاش كثير.
أقول: و "السجال" بهذا الاستعمال وهذه الدلالة شيء جديد مستوحى من معنى السجال في الأصل.
السجال": جمع سجْل بمعنى الدلو الممتلئة ماءً، ولا يكن سجل إلا وهو ممتلئ ماءً، قال لبيد: يُحيلُون السجال على السجال.
وفي حديث أبي سفيان: أن هرقل سأله عن الحرب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: الحرب "سجال" معناه: إنّا نُدَال عليه، ويُدال علينا أخرى.
أقول: وقوله: "الحرب سجال" على التشبيه، أي هي كالسجل يتناوب فيها المستقيان من البئر، وهي كما في الأصل جمع "سَجْلُ" وليس فيها شيء مما درج عليه المعاصرون الذين حولوا الكلمة في استعمالهم إلى "مصدر" وكأنه في استعمالهم مصدر لـ "ساجل" مثل: سابق ومصدره "سباق" و "مسابقة".
أقول أيضاً : إن الأقدمين ذهبوا في دلالة "السجال" وهي جمع إلى معنى المبادلة والمعاقبة فأخذوا من السَّجْل وهو الاسم، المساجلة ولم يحولوا السجال إلى مصدر نحو: السباق والمسابقة، والصراع والمصارعة، وغيرهما كثير جدا.
وأريد أن أقول: إن مصدر "فاعل" هو المفاعلة والفعال، وهذا لا يعني أن كل فعل على هذا يأتي منه هاتان الصيغتان فكثيراً ما اكتفي في العربية بأحدهما وهجر الآخر على قياسيته. ألا ترى أنك تقول: "المباراة" من الفعل "بارى" ولا تقول براء ولم يجر به الاستعمال وتقول: مضاحكة ولا تقول: ضِحَاك، وتقول: ملاعبة ولا تقول : لِعَاب، وتقول: مكاثرة ومكابرة، ولا تقول: كِثَار ولا كبار.
ومن هنا كان على المعاصرين أن يكتفوا بـ "مساجلة" لأن السجال بقيت في العربية جمعاً، ولم ترد مصدراً، وإن كانت قياسية كالمساجلة.
واستعمل الزملكاني صاحب "البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن" في كلامه على الأحرف في فواتح السور كلمة التساجل، ولم يرد هذا المصدر في كتب اللغة، ولكن المؤلف جعله من قبيل التبادل والتناوب ونحوهما، وكان موفقاً فيه، قال:
"إنها كالمهيِّجة لمن يسمعها، والموقظة للهمم الراقدة من البلغاء لطلب التساجل في الأعلام".
والمُساجَلة: يعني المُفاخَرة بأن يَصْنَع مثلَ صَنِيعه في جَرْيٍ أَو سقي وأصله من السَّجْل، وهو الدلو فيها ماء قلَّ أو كثر - ولا يقال لها وهي فارغة: سَجْل.
وقال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب:
مَنْ يُساجِلْني يُسَــــاجِلْ ماجِــداً، يَمْــلأُ الدَّلْوَ إِلـــى عَقــْدِ الكَـرَب
أصل المُسَاجَلة أن يَسْتَقِيَ ساقيان فيُخْرج كُل واحد منهما في سَجْله مثل ما يُخْرج الآخر، فأيّهما نَكَل فقد غُلِبَ، فضربته العرب مثلاً للمفاخرة، فإِذا قيل فلان يُساجِل فلاناً، فمعناه أنه يُخْرِج من الشَّرَف مثل ما يُخرِجه الآخرُ، فأيهما نَكَل فقد غُلِب.
وقال أبو سُفيان يوم أُحد بعدما وقعت الهزيمة على المسلمين: أعْلُ هَبَلُ، أعْلُ هُبَلُ! فقال عمر: يا رسول الله ألا أجيبه؟ قال: بلى يا عُمر. قال عمر: الله أعلى وأجَلُّ! فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب، إنه يوم الصَّمْت، يوماً بيوم بدر، وإن الأيام دُوَل، وإن الحرب سجال. فقال عمر: ولا سَوَاء، قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار.
فقال أبو سفيان: إنكم لتزعمون ذلك، لقد خِبْنا إذن وخَسِرْنا!
وفي حديث أبي سفيان أن هِرقل سأله عن الحرب بينه وبين النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال له: الحَرْب بيننا سِجَالٌ؛ معناه إنا نُدَالُ عليه مَرَّة ويُدَالُ علينا أخرى، قال: وأصله أن المُسْتَقِيَين بسَجْلَين من البئر يكون لكل واحد منهما سَجْلٌ أي دَلوٌ ملأى ماء.
السَّجْلُ: الدَّلْو الضَّخْمَة المملوءةُ ماءً، مُذَكَّر، وقيل: هو مِلْؤُها، وقيل: إذا كان فيه ماء قَلَّ أو كَثُر، والجمع سِجالٌ وسُجُول، ولا يقال لها فارغة سَجْلٌ ولكن دَلْو؛ وقيل: لا يقال له وهو فارغ سَجْلٌ ولا ذَنُوب؛ قال الشاعر:
السَّجْلُ والنُّطْفَـــــة والذَّنُـــوب، حَتــَّى تَــرَى مَرْكُوَّهـــــــا يَثُــوب
وأنشد ابن الأعرابي:
أُرَجِــّي نائــلاً مــن سَــــيْبِ رَبٍّ، لــه نُعْمَـــى وذَمَّتُـــــه سِــــجَالُ
قال: والذَّمَّة البئر القليلة الماء.
والسَّجْل: الدَّلْو المَلأى، والمعنى قَلِيله كثير، وأسْجَله: أعطاه سَجْلاً أو سَجْلَين، وقالوا: الحروب سِجَالٌ أي سَجْلٌ منها على هؤلاء وآخر على هؤلاء..
وقال ابن الرومي:
قُلْ لأيـــوبَ والكـــلامُ ســــجالُ والجــوابات ذاتَ يـــــومٍ تُــدالُ
اسكتوا بعدَهـا فلا تذكـروا الشْـ شُــؤم حيـــاً فأنتُــــمُ الآجـــــالُ
وانسَجل الماءُ انسجالاً إِذا انْصَبَّ؛ وأسْجلْت الحوض: مَلأْته، وأَسْجَل الرجلُ: كثُر خيرُه.
وأَسْجَلَ الناسَ: ترَكَهم، وأَسْجَلَ لهم الأَمرَ: أطلقه لهم؛ والسَّجِيلُ: الصُّلْب الشديد.
وفي التنزيل العزيز: «ترْمِيهم بحِجارة من سِجِّيل»، وقيل: هو حجر من طين، مُعَرَّب دَخِيل، قال الله تعالى: «كَلاَّ إِن كتاب الفُجَّار لَفِي سِجِّينٍ وما أدراك ما سِجِّينٌ كتابٌ مَرْقومٌ»؛ وسِجِّيل في معنى سِجِّين، المعنى أنها حجارة مما كَتَب الله تعالى أنه يُعَذبهم بها؛ وقيل في حجارة من سِجِّيل إنها حجارة من طين طُبِخَتْ بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم لقوله عز وجل: لنُرْسِل عليهم حجارة من طين.
الأخطل:
حيِّ المنازِلَ بَينَ السّفْحِ والرُّحَــبِ لمْ يَبْقَ غَيرُ وُشــومِ النّارِ والحطبِ
وعقرٍ خالـــــداتٍ حـــولَ قُبتهــا وطامسٍ حبشي اللونِ ذي طببِ
وغيرُ نؤيٍ قديمِِ الأثـــرِ، ذي ثلــمٍ ومستكينٍ أميمٍ الرَّأسِ مســــتلب
تعتادُها كلُّ مثلاةٍ وما فقـــــدت عَرْفاءُ مِنْ مُورِها مجنونَــةُ الأدبِ
ومظلمِ تعملُ الشــــكوى حواملــــُهْ مستفرغٍ من سجالِ العينِ منشطبِ
-كما أن السجال بمعنى الجدال والمناظرة، وهذا هو الجاري لدى الكتاب في مقالاتهم وأبحاثهم، ومن هذا ما يقول آخر: اشتد "السجال" بين الأطراف كافة، وهذا شيء فاش كثير.
أقول: و "السجال" بهذا الاستعمال وهذه الدلالة شيء جديد مستوحى من معنى السجال في الأصل.
السجال": جمع سجْل بمعنى الدلو الممتلئة ماءً، ولا يكن سجل إلا وهو ممتلئ ماءً، قال لبيد: يُحيلُون السجال على السجال.
وفي حديث أبي سفيان: أن هرقل سأله عن الحرب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: الحرب "سجال" معناه: إنّا نُدَال عليه، ويُدال علينا أخرى.
أقول: وقوله: "الحرب سجال" على التشبيه، أي هي كالسجل يتناوب فيها المستقيان من البئر، وهي كما في الأصل جمع "سَجْلُ" وليس فيها شيء مما درج عليه المعاصرون الذين حولوا الكلمة في استعمالهم إلى "مصدر" وكأنه في استعمالهم مصدر لـ "ساجل" مثل: سابق ومصدره "سباق" و "مسابقة".
أقول أيضاً : إن الأقدمين ذهبوا في دلالة "السجال" وهي جمع إلى معنى المبادلة والمعاقبة فأخذوا من السَّجْل وهو الاسم، المساجلة ولم يحولوا السجال إلى مصدر نحو: السباق والمسابقة، والصراع والمصارعة، وغيرهما كثير جدا.
وأريد أن أقول: إن مصدر "فاعل" هو المفاعلة والفعال، وهذا لا يعني أن كل فعل على هذا يأتي منه هاتان الصيغتان فكثيراً ما اكتفي في العربية بأحدهما وهجر الآخر على قياسيته. ألا ترى أنك تقول: "المباراة" من الفعل "بارى" ولا تقول براء ولم يجر به الاستعمال وتقول: مضاحكة ولا تقول: ضِحَاك، وتقول: ملاعبة ولا تقول : لِعَاب، وتقول: مكاثرة ومكابرة، ولا تقول: كِثَار ولا كبار.
ومن هنا كان على المعاصرين أن يكتفوا بـ "مساجلة" لأن السجال بقيت في العربية جمعاً، ولم ترد مصدراً، وإن كانت قياسية كالمساجلة.
واستعمل الزملكاني صاحب "البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن" في كلامه على الأحرف في فواتح السور كلمة التساجل، ولم يرد هذا المصدر في كتب اللغة، ولكن المؤلف جعله من قبيل التبادل والتناوب ونحوهما، وكان موفقاً فيه، قال:
"إنها كالمهيِّجة لمن يسمعها، والموقظة للهمم الراقدة من البلغاء لطلب التساجل في الأعلام".

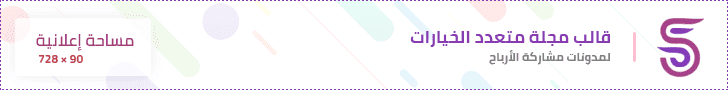
إرسال تعليق