أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي (وُلد نحو 185هـ/ 801م، وتُوفِّي أواخر سنة 252هـ/ 866م)(1) فيلسوف العرب، وأحد صروح حضارة الإسلام. كتب عن منجزاته وإبداعاته كثيرون؛ فهو أشهر من أن نقدّم له ترجمةً مفصّلةً هنا، وهو الرائد في أكثر العلوم الطبيعية التي عرفها عصره، عدّد له صاحب كتاب (الفهرست) ما يزيد على 250 تأليفاً في موضع واحد(2)، وذكر غيرها في مواضع أخرى،
ونكتشف المزيد بين الحين والآخر. ولشهرته المستفيضة ألّفت عنه الكتب والبحوث؛ فنقدّم في آخر مقالنا هذا ملحقاً بالمراجع التي بحثت سيرته وعلمه ومؤلفاته. أما المصادر التراثية التي ترجمت له، فقد وردت مفصّلة في تلك المراجع، ولا نرى حاجةً إلى سردها.
لكن تراث الكندي -والتراث العلمي عامةً- لا يزال في حاجة إلى مزيد من الكشف والدراسة؛ فلا يزال هناك كثير من النصوص التي لم تُكتشف، ولم يتم تحقيقها ونشرها حسب المناهج المعتمدة، أو لم تتم دراستها وعرض فوائدها. وما يُبهر في مؤلفات الكندي ليس عددها فقط، وإنما أن معظم ما فيها جديد بالنسبة إلى عصره، وسبق به الكندي زمانه، وأتى بمبتكرات لم تُعرف قبله، وتحدّث عن موضوعات لم يتطرق إليها من سبقوه، إضافةً إلى طريقة عرض أفكاره بأسلوب فائق التنظيم، حتى صارت أعماله مرجعاً لمن أتى بعده؛ لأنه تفوّق فيها على معاصريه وسابقيه؛ فبعضها في موضوعات لم يسبقه إليها أحد، وبعضها بحوث مفصّلة لم يكتب فيها غيره من سابقيه ومعاصريه إلا مقالات موجزة صغيرة.
تمثّل مقالتنا هذه عرضاً سريعاً لعدد من إبداعاته في مختلف العلوم والمعارف: الجواهر، وإزالة البقع وأهمية ذلك في علم المخطوطات، وصناعة العطور باستخدام الوسائل الكيميائية، والأطعمة المقلّدة، وتوقّع الطقس، والصوتيات واللسانيات، وعلم الجرعات، وصناعة السيوف وعلم المعادن، وتلوث الهواء.
في الجواهر
للكندي في مجال الجواهر خبرة منذ طفولته، قال البيروني: جدّ فيلسوف العرب كان جوهريا خبيراً، اثم إن الرشيد كان شديد الولوع بالجواهر، حريصاً على اقتنائها، وأنه بعث بالصباح الجوهري جدّ الكندي إلى صاحب سرنديب(3) لابتياع جواهر في ناحيته، فأكرمه الملك، ورحّب به، وأراه خزانة جواهره، وهو يقلّبها ويتعجّب من جلالتها، وعظم أجرامها(4)، إلى أن بلغ ياقوتاً أحمر، ولم يكن رأى في خزائن الملوك مثله، فاشتد إعجابه. وقال له الملك: هل لك عهد بمثله؟ قال: لا واللّه، قال: فهل تقدر على تقويمه(5)؛ إذ عجز الكلّ عنه؟ قال: أفعل. وشقّ ذلك على الملك، وقال له: كنت أسترجح عقلك، فكذبت فراستي فيك؛ لادّعائك ما أعجز الكافة. قال الصباح: ما أخطأت فراستك، وإن أردت صدقها فاجمع عندك من ذوي البصر بأمر الجواهر، فجمعهم، واستحضر الصباح ملاءة وبسطها، ودفع أطرافها إلى أربع نفر يمسكونها في الهواء، ثم رمى بالياقوتة فوق الملاءة بأقصى قوته، ولما سقطت على الملاءة قال للملك: قيمتها أن تنصب العين على الأرض إلى أن تعلو إلى حيث بلغت بالرمي، فاستحسن القوم قوله في أعينهم وعين الملك، وأمر فحُشِي فوه بالجوهر الرائق، وخلع عليه، وصرفه بقضاء ما ورد لهب(6).
وكان كتاب الكندي (في الجواهر والأشباه) أهم مصادر كتاب (الجماهر)، يقول البيروني: اولم يقع إليّ من هذا الفنّ غير كتاب أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي في الجواهر والأشباه، قد افترع فيما عذرته، وظهر ذروته؛ كاختراع البدائع في كلّ ما وصلت إليه يده من سائر الفنون؛ فهو إمام المحدثين، وأسوة الباقين. ثم مقالة لنصر بن يعقوب الدينوري الكاتب، عملها بالفارسية لمن لم يهتدِ لغيرها، وهو تابع للكندي في أكثرهاب(7).
طُبع كتاب البيروني مرتين: إحداهما في حيدر آباد عام 1938م، والأخرى في طهران عام 1995م، وعلى الرغم من الجهود التي بُذلت في إخراج الطبعتين إلا أن الكتاب ما زال في حاجة إلى تحقيق منهجي، تتم فيه الاستفادة من جميع مخطوطات الكتاب في العالم، والعناية بشرح الألفاظ شرحاً يتوافق مع معطيات العلوم الحديثة، والتدقيق في الكشافات indices، والعناية بشمولها وإحاطتها بنصوص الكتاب؛ فمثلاً في كشاف الأعلام نجد الكندي مذكوراً في طبعة الهند 54 مرة، وفي طبعة طهران 55 مرة، بينما الجدول الذي أعددناه (ليُنشر مع تحقيقٍ مقبلٍ لمقالة للكندي في المناجم) يوضّح أنه مذكور ثمانين مرة.
تكوّن أقوال الكندي في (الجماهر) كتاباً مستقلاً بذاته، نرى فيه الآراء والأفكار والمعلومات والتجارب التي سبق بها الكندي معاصريه، فكان البيروني أميناً في نقله، واحتفظ بنصوص الكندي منسوبةً إليه. ويمكن تكليف أحد طلاب الدراسات العليا باستخراج هذه النصوص على حدةٍ، وتحقيقها، وشرح مفرداتها، ونشرها محققةً تحقيقاً منهجياً في كتاب مستقلّ.
وقد وصلت إلينا من كتابات الكندي -غير مقتبسات البيروني- ثلاثة نصوص، كلّها تتّسم بالأصالة: النصّ الأول عن اللؤلؤ في آخر كتاب (المجموع اللفيف) للأفطسي، تم نشره محقّقاً على حدةٍ(8)، ثم نُشِر الكتاب كاملاً(9)، والنصّ المنشور وحده جيّد التحقيق، أما تحقيق النص الكامل لكتاب الأفطسي ففيه عدة مآخذ. والنصّ الثاني رسالة (في أنواع الجواهر الثمينة)، التي ذكرها مؤلف (الفهرست) أو ذكر قطعةً منها، وردت ضمن مخطوطتين: إحداهما في القاهرة، والأخرى في كوتا Gotha(10)، وقد تبيّن أن محتويات نصّ هذه القطعة ليست واردة في كتاب (الجماهر) للبيروني؛ لذلك فهذه الرسالة مختلفة عن كتاب (الجواهر والأشباه) الذي يقتبس منه البيروني. يبدأ المؤلف رسالته بتقديم تصنيفات رئيسة وفرعية للجواهر، وهو أمر يدلّ على التفكير المنظم لعالِمنا مؤلّف هذا النص، ثم يقدّم بعدها فقرات قصيرة عن أنواع من الحجارة الكريمة. والنصّ الثالث عن وسائل الاستدلال على وجود منجم فيه معادن ثمينة قبل الحفر وفي أثنائه، وقد قام كاتب هذه السطور بتحقيقه، وهو قيد النشر قريباً بإذن الله. والنصوص الثلاثة مما لم يَرِدْ ضمن النصوص التي نقلها البيروني.
هي رسالة عن إزالة البقع من النسيج والورق، وتكمن أهميتها -في مجال علم المخطوطات- في استعمال وسائل الإزالة لإجراء تصحيحات وتعديلات في الكتاب المخطوط، وهذه الرسالة واحدة من ثلاثة أعمال مبكّرة رائدة في هذا الموضوع لثلاثة مؤلفين متعاصرين، والعَملان الآخران هما: رسالة إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادي (المتوفَّى سنة 298هـ/910م)، وفصل صغير من كتاب (فردوس الحكمة) لعلي بن سهل بن رَبَن الطبري (المتوفَّى سنة 247هـ/ 861م). وقد بيّن تحليل محتويات المؤلَّفات الثلاثة أنها تشترك في خصائص متشابهة من حيث كون وصفاتها مختصرة وسريعة، إلا أن رسالة الكندي تمتاز بحسن التبويب؛ فلا تأتي وصفاتها غير مصنّفة ولا مرتّبة كما عند الطبري وإسحاق. كثير من الوصفات متشابهة في تركيب المواد، لكنها تختلف في ألفاظ النصوص، وهو الأمر الذي يوضّح أنها مؤلّفات مستقلة بعضها عن بعض، ينقل كلّ مؤلف التجارب بأسلوبه الخاص. وترتيب الوصفات في كل تأليف يختلف عن التسلسل في الاثنين الآخرين(12).
الترفّــق فــي العـــطــر أو كيمياء العطر والتصعيدات
هذا أول كتاب يتناول تصنيع العطور بتقديم وصفات ومقادير محدّدة، وخطوات وأساليب كيميائية؛ فقد أثبتت البحوث أن المؤلفات التي قبله كانت رسائل صغيرة تكتفي بذكر العطور الطبيعية غير المركّبة؛ مثل: المسك، والعنبر، والعود، وغيرها، وأوصافها، والأمكنة التي تُجلب منها. أما كتاب الكندي، فيصف بالتفصيل العمليات الكيميائية التي تنتج منها العطور المركّبة(13).
درس الأهواني(14) نصوص هذا الكتاب، فلاحظ أن بعض نصوصه لا يمكن أن يكون الكندي كتبها، ومن ذلك قوله: اوهذه الصفة أخذتها من أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي، وقد رأيتُهُ، وقد عمله وفتقه قداميب(15)(16)، وقوله أيضاً: اصنعة غالية أحمد بن علي، أخذتها عنه بمصرب(17)، ولم يُعرف عن الكندي أنه رحل إلى مصر. وعلّق الأهواني على هذه النصوص قائلاً: اولهذا كلّه نميل إلى الاعتقاد بأن الرسالة ليست للكندي، بل منسوبة إليه، وأن مؤلّفها كان على صلة به، يستشيره، ويستفيد منه.... ويبدو أن بعض تآليف الكندي كانت تصدر من المدرسة باسمه، كالحال في هذه الرسالة. ومن هذا الوجه يصحّ لنا اعتبار كتاب كيمياء العطر من تأليفه، أو من تأليف أحد تلاميذه بعد عرضه على أستاذه وإجازته.
على كلٍّ فإن الفقرات التي أوردناها، والتي تزعزع الثقة في نسبة الرسالة، لا بدّ أنها أُقحمت فيما بعد -إن صحّ أن الرسالة للكندي- أضافها أحد العلماء إلى النسخة التي كان يقتنيها، وجاء النسّاخ فأدمجوا الإضافات في المتن، كما هو معروف عند المشتغلين بإخراج الكتب الخطية وتحقيقهاب(18).
ثم نُشر بحث بعد عشرين عاماً من كتاب الأهواني نجد فيه كلّ النصوص التي ساقها الأهواني وملاحظاته عليها من دون الإشارة إليه مرجعاً على الإطلاق(19).
كيمياء الأطعمة
المزوّرة: طعام لا لحم فيه، يُتَّخذ من البقول فقط، وهو يعدّ خصيصى للمرضى(20). هذا الموضوع مهم في تاريخ الطب العربي، لم يُكتب بعدُ، ولو أن المعلومات عنه متناثرة في الكتب المخطوطة والمطبوعة. وقد ألّف الكندي رسالة افي صنعة أطعمة من غير عناصرهاب(21)، فقال عنه ابن بسام المحتسب: اوقد وجدتُ في الرسالة التي تُعرف بـ(كيمياء الطبيخ)، التي ألّفها يعقوب بن إسحق الكندي، ألواناً تُطبخ من غير لحم، وقلايا كبود من غير كبود، ومخّ من غير مخّ، ونقائق من غير لحم، وعجة من غير بيض، وجوذاب من غير جبن ولا أرز، وحلاوة من غير عسل ولا سكر، وألواناً كثيرة من غير عناصرها، يطول شرحها، وليس يُهتدى إلى دقة صناعتها. وخشيت من تدليس المتعيشين في الأسواق، فأمسكت عن صنعتها؛ خوفاً من التنبيه على عملها؛ رجاءً لثواب الله تعالىب(22). ونلاحظ على ابن بسام هنا أنه يعدُّ كتاب الكندي وسيلةً للغشّ عند الطباخين؛ فهو يتحدث عنه في مكان آخر قائلاً: اوقد أمسكت عن أشياء ليست بمشهورة قد ذكرها صاحب (كيمياء العطر)، كما أمسكت عن أشياء كثيرة قد ذكرها يعقوب بن إسحق الكندي في رسالته المعروفة بـ(كيمياء الطبائخ)، فرحم الله من وقع في يده ذلك الكتاب فمزّقهب(23).
والواقع أن الكتاب كان هدفه هو عمل المزوّرات للمرضى، ولمن يتبعون الحمية؛ فقد ذكره مؤلف (الفهرست) ضمن كتب الكندي الطبية. وليست الخضراوات والنباتات الطبية المذكورة فيه متاحةً دائماً مثل اللحوم، ولا هي دائماً رخيصة الثمن؛ لذلك لا نخشى من إساءة استعمال الطباخين له. والنصّ الذي نشره كاتب هذه السطور(24) هو من تحرير الطبيب ابن جزلة (تُوفِّي سنة 493هـ/ 1100م)، وهو صاحب مؤلّفات مخطوطة ومطبوعة في الطب(25).
وينقل الشيزري(26) كلام ابن بسام حرفياً كما هي عادته، لكن باختصار مخلّ بالمعنى. ويذكر الباحثون في عصرنا أن ابن بسام من أهل القرن السابع الهجري؛ لذلك فهو متأخر عن الشيزري الذي عاش في القرن السادس الهجري، لكن كاتب هذه السطور بيّن في بحث سابق أن ابن بسام عاش قبل الشيزري بقرن ونصف القرن(27)؛ لذلك فكتابه هو الأصل الذي ينقل منه الشيزري وابن الأخوة حرفياً كما قلنا.
هل النص الذي نُشر هو رسالة الكندي الأصلية أو مختصرها؟ بمقارنة موضوعات الرسالة كما جاء ذكرها في نصّ ابن بسام السابق مع موضوعات النصّ المنشور نرى بكلّ وضوح أن النص المنشور لا يحتوي على اقلايا كبود من غير كبود.... ونقائق من غير لحم، وعجة من غير بيضب، والنص المنشور منقول من خط الطبيب ابن جزلة؛ فالاختصار -إذاً- هو من عمل هذا الطبيب.
كان النص الذي نشرناه غير معروف لدى الباحثين(28)؛ فمنهم من اكتفى بأن ينقل من كتاب (الفهرست) للنديم عنوان الرسالة، ويعدّها مفقودةً. وذكرها أحد الرواد في تاريخ الطب، فبيّن الحاجة إلى دراستها أو تحقيقها، قائلاً: اذكر ابن أبي أصيبعة رسالة الكندي بعنوان (في تدبير الأطعمة)، رآها سباط في حلب، ثم اختفت(29). وقد تكون هذه الرسالة هي تلك التي وصلت إلينا بعنوان آخر (كيمياء الأطعمة) في مخطوط محفوظ في طهران(30)... وعلى كلٍّ، فإن مخطوطة طهران لم تُدرس بعد، وبالتالي فنحن لا نعرف ما إذا كانت هذه العناوين تشير إلى رسالة واحدة أو عدة رسائل... وكان ابن جزلة قد أعاد إخراج هذه الرسالة(31). وهذه إشارة ثانية إلى مدى اهتمام ابن جزلة -الطبيب الكبير، والمؤلف الشهير- بأعمال الكندي الطبية التي تعالج موضوعات قلّ أن تطرّق الآخرون إلى العناية بهاب(32). والواقع أن أعمال الكندي غير الطبية أيضاً تعالج موضوعات قلّ أن تطرّق إليها الآخرون كما ترى في هذه القائمة.
اهتم الإنسان منذ القدم بالجو والطرائق الفعالة للتنبّؤ به؛ فنجد التوقعات البسيطة من الظواهر الجوية ومن تشكيلات النجوم المعلّقة في السماء منسوبةً إلى أرسطو وفارو وبليني وفي أساطير القدماء، لكن الوضع الثقافي الخاصّ الذي كانت تعيشه بغداد في منتصف القرن التاسع ساعد على إنتاج ما يمكن أن يُقال عنه: إنه أول المؤلفات الشاملة عن توقّع الجو، ويمكن عدّها مبنيةً على أسس علمية، وهي رسالتان لفيلسوف العرب الكندي.
يمزج الكندي بين ثلاثة تقاليد للتنبّؤ بالجو:
التقاليد الزراعية العربية- الإسلامية التي تعتمد على توقّع الطقس من معرفة منازل القمر وموضعه من الأبراج والنجوم، وكتب التنجيم التي كتبها السابقون للكندي مثل عمر بن فرّخان وما شاء الله اليهودي، والأخذ من مصادر بهلوية وإغريقية، ومنها مؤلفات أرسطو المزيف وبطلميوس. يضع الكندي كلّ هذه المعارف المتباعدة ضمن سياق الفيزياء التي تبنّاها أرسطو، فيبني من ذلك نظرية الجوهر/ الروح الخامسة من كتابي (السماء والعالم) و(الآثار العلوية)؛ فهذان الكتابان لأرسطو يبدأ كلّ منهما بحديث نظري مفصّل، في الأول عن الكون، وفي الثاني عن مراتب العلوم ودور كلّ من المنطق والفكر مقارنةً بالتجربة.
الباحثان اللذان نشرا رسالتي الكندي في هذا المجال يعرضان تاريخ التنبّؤ بالجو من أقدم العصور إلى بدايات العصر الحديث(33)؛ ليضع الكتاب رسالتي الكندي في سياقهما التاريخي، فيناقش الاتجاه العلمي للرسالتين، ومصادرهما، ويقارن محتوياتهما بنصوص كتب أخرى للكندي ألّفها في مجالي الكون والجو. ولأن النصّ العربي الأصلي لرسالتي الكندي لم يُكتشف بعد، أو ضائع، فإن عمل الباحثين في الكتاب يعتمد على الترجمة الحرفية للرسالتين إلى العبرية، إحداهما ترجمها المترجم الذائع الصيت في القرن الثالث عشر قالون بن قالون. واعتمد الباحثان كذلك على نسخة لاتينية مستقلة، يبدو أنها تُرجمت مباشرةً من العربية. وتحمل النسخة اللاتينية العنوان الآتي: De Mutatione Temporum؛ أي: تغيّر الجو، وأُدمجت الرسالتان في هذه النسخة اللاتينية في تأليف واحد. وقام الباحثان بتحقيق النصوص العبرية واللاتينية المذكورة باعتماد كلّ مخطوطاتها المعروفة، وأرفقا معها ترجمة إنجليزية مشروحة لنصّ قالون.
وقد أظهرت دراسة مقارنة أن الكندي لم يكن مجرّد ناقل لآراء الإغريق في مجال بحثه، بل كانت له نظريته وآراؤه المستقلة عن حركة الكواكب وتأثيرها في الطقس(34). وإضافةً إلى هذه النصوص العبرية واللاتينية نشر الباحثان النصوص العربية الآتية للكندي عن الموضوع نفسه:
- الباب الثامن والثلاثون من كتاب الكندي المسمّى (الأربعون باباً): وهو كما نصّ عليه الكندي (مدخل إلى علم النجوم)؛ أي: كتاب تعريفي بالفلك والتنجيم(35). والفصل المنشور هنا عن توقّع الطقس بناءً على مواقع الأبراج والكواكب والنجوم(36).
- رسالة (في أحداث الجو): وسبق أن نشرها كلّ من: روزنتال(37)، ويوسف مسكوني(38)، واعتمد كلّ منهما اعتماداً كبيراً على مخطوطة واحدة مختلفة عن الأخرى، لكنّ الباحثين هنا ينشرانها محقّقةً على أربع نسخ. ويعتمد الموضوع هنا أسلوب الرسالة السابقة نفسه.
- فصلان للكندي، أولهما بعنوان: (في تحويل السنة في الأمطار)، والآخر (في الرياح)، ضمن مجموع في طهران(39).
ونُشِرت هذه الرسائل للكندي ضمن رسائل أخرى(40): رسالة في العلّة التي لها تكون بعض المواضع لا تكاد تمطر، ورسالة في علّة كون الضباب، ورسالة في الثلج والبرد والبرق والصواعق والرعد والزمهرير، ورسالة في العلّة التي لها يبرد أعلى الجو ويسخن ما قرب من الأرض، ورسالة في علّة اللون اللازوردي الذي يُرى في الجو في جهة السماء ويظنّ أنه لون السماء، ورسالة في العلّة الفاعلة للمدّ والجزر.
عـــــلـــم الأصـــــــوات أو الـــصــوتيـات phonetics هــــو فــــرع مــن عـــلـــم اللـــسانــيــات linguistics، وهــما مصطلحان جديدان بدأ استعمالهما في القرن العشرين، لكن اشتغال القدماء بموضوعاتهما قديم؛ فقد اشتغل بها الهنود في تاريخهم القديم، ووردت عبارات متناثرة في مجالها عند اليونان والرومان، لكن أكثر من ألّف وتوسّع في مباحثه، وترك تراثاً وافراً غنياً فيه، هو بلا شكّ علماء العرب في حضارة الإسلام(41).
اشتغل العرب بموضوعات هذا العلم في ثلاثة مجالات: علوم اللغة العربية، والعلوم الطبيعية كالطب والفلسفة الطبيعية والموسيقا، وعلوم القرآن المتعلّقة بتلاوته كالقراءة والتجويد، وبكتابته كالرسم والضبط؛ فمثلاً: أول معجم في اللغة العربية هو معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (تُوفِّي سنة 175هـ/ 791م)، وقد اعتمد وضعه على مخارج الحروف، بل نُسِب إلى الخليل أيضاً كتاب لم يصل إلينا، اسمه (تراكيب الأصوات(42)، وعلم العَروض الذي هو قوانين وزن الشِّعر يعتمد على قياسات صوتية، وانطلقت البحوث اللغوية بعد الخليل إلى مستويات عالية على يدي سيبويه وغيره.
أما في مجال العلوم الطبيعية، فالريادة فيها للكندي بإجماع مؤرّخي العلوم شرقاً وغرباً؛ فرسالته في استخراج المعمّى هي أولى الرسائل التي تمّ تأليفها في مجال التعمية والتشفير(43)؛ إذ تكلّم عن تردّد حروف العربية ودورانها في الكلام، معتمداً على إحصاء صنعه بنفسه، وتقسيمها إلى مصوتة وخرس (صامتة)، وذكر قانوناً لغوياً عاماً يسري على كلّ اللغات، وهو كونُ المصوتات أكثر الحروف تردّداً، ونبّه على اشتمال المصوتة على: المصوتات العظام (وهي حروف المد)، والمصوتات الصغار (وهي الحركات)، ثم بسط الكلام على نسج الكلمة العربية باستفاضة، فأورد ما يقرب من مئة قانون من قوانين ائتلاف الحروف واختلافها أو تنافرها(44).
وللكندي رسالة أخرى ذات مساس بالصوتيات، بل بتطبيقٍ دقيقٍ من تطبيقاتها، وهو ما يُدعى اليوم بـ(أمراض النطق، بالإنجليزية speech disorders، وبالفرنسية troubles de la parole)، وهي رسالة اللثغة، وقد قدّم لها ببيانٍ وافٍ لآلية النطق، وعلاقتها بالحروف، وما تحتاج إليه كل لغة من اللغات السائدة آنذاك من الحروف، ثم تكلّم عن أسباب اللثغة، وما يعرض للسان من التشنّج أو الاسترخاء، ووصف مخارج حروف العربية، وهيئات النطق بها، وصفاً تشريحياً فيزيائياً على نحو يختلف عما عهدناه عند سيبويه ومن أتى بعده، ثم حدّد حروف اللثغة، وسمّى أعراضها، وأنواعها، وختم الكلام بعللها(45)(46)(47).
علم الجرعات posology
من مؤلّفات الكندي الرائدة التي سبق بها عصره في التعمّق والتخصّص وربط العلوم بعضها ببعض رسالته (في معرفة قوى الأدوية المركّبة)؛ ففيها يربط تأثير الدواء المركّب في الجسم البشري بطرائق حسابية، رابطاً العلوم الطبية بالرياضيات؛ إذ يقول: الما رأيتُ الأوائل قد عُنوا بالتكلّم في كل واحد من قوى الأدوية على الانفراد في الحرّ والبرد والرطوبة واليبوسة، وحدّوا في ذلك حدوداً أربعةً، فقالوا: درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة في كلّ واحد من الكيفيات، وأضربوا عن ذكر ذلك في الدواء المركّب، ولم يقولوا: إن هذا الدواء المركّب في درجة كذا وكذا في الحرّ والبرد والرطوبة واليبوسة، وكان ذلك أولى وأحقّ في الدواء المركّبب(48).
النظرية التي يذهب إليها الكندي هي أن درجة قوة الدواء تتناسب هندسياً، وليس خطّياً linear، مع تأثيره في البدن، أما غيره من الأطباء، مثل ابن رشد الذي انتقده انتقاداً جارحاً كما سيأتي، فيرى أن التناسب خطّي، وليس هندسياً. ولتوضيح ذلك نذكر أن تأثير الدواء المفرد (غير المركّب) له أربع درجات فوق درجة المعتدل من ناحية الحرارة والبرودة أو الرطوبة واليبوسة، وهي: الدرجة الأولى، ثم الثانية، فالثالثة، فالرابعة. وقد أعطى ابن القف (تُوفِّي سنة 675هـ/ 1286م) أمثلةً على درجات الحرارة في الدواء(49)؛ فالحارّ في الدرجة الأولى هو الذي من شأنه إذا ورد على البدن المعتدل سخّنه سخونةً طفيفةً كالحنطة، وفي الدرجة الثانية هو الذي إذا ورد على البدن سخّنه سخونةً ظاهرةً من دون أن يبلغ إلى أن يضرّ بأفعاله كالعسل، وفي الدرجة الثالثة هو الذي إذا ورد على البدن المذكور سخّنه سخونةً ظاهرةً ويبلغ إلى أن يضرّ بأفعاله من غير أن يهلك البدن ويفسده كالفلفل، وفي الدرجة الرابعة هو الذي إذا ورد على البدن سخّنه سخونةً تبلغ إلى أن يُهلك البدن ويُفسده كالأفرابيون(50).
يقول ابن القف: إن درجات التأثير محصورة في الحرارة والبرودة، اوأما الرطبة واليابسة، فليس لها ذلك بالذات أصلاًب(51)، وهو واهم في ذلك؛ فابن جزلة (تُوفِّي سنة 493هـ/ 1100م) ينصّ على أن لليبوسة درجات(52)، وكذلك الحال عند ابن بكلارش (عاش في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ أي أنه معاصر لابن جزلة، لكنه أندلسي، بينما ابن جزلة بغدادي)(53). ويذكر ابن البيطار (تُوفِّي سنة 646هـ/ 1248م) درجات اليبوسة والرطوبة في الأدوية المفردة في كتابه (الجامع)، كما يذكر درجات البرودة والحرارة.
ويحدّد ابن القف طريقتين لمعرفة أجزاء كلّ درجة من درجات الحرارة أو البرودة، هما: طريقة الكندي (252هـ/ 871م)، وطريقة ابن رشد (توفِّي سنة 595/ 1198م)(54):
- طريقة الكندي: تكون فيها أجزاء المعتدل متكافئةً؛ أي أن في المعتدل من الحرارة قدر ما فيه من البرودة، وكذلك الكلام على الرطوبة واليبوسة، والحارّ في الدرجة الأولى فيه ضعف ما في درجة المعتدل؛ فيكون فيه جزءان حاران، وفي الدرجة الثانية يكون فيه ضعف ما في الدرجة الأولى، فتكون أجزاء الحرارة أربعة. والحار في الدرجة الثالثة فيه ضعف ما في الدرجة الثانية، والحار في الدرجة الرابعة فيه ضعف ما في الدرجة الثالثة، فيكون من الحار في الدرجة الرابعة 16 جزءاً من الحرارة، وجزء واحد بارد.
- طريقة ابن رشد: ويكون فيها في المعتدل أربعة أجزاء من الكيفيات، والحار في الدرجة الأولى فيه جزءان حاران، وفي الدرجة الثانية ثلاثة أجزاء، وفي الدرجة الثالثة أربعة أجزاء، وفي الدرجة الرابعة خمسة أجزاء.
ويوضّح هذا الجدول الطريقتين(55):
الدرجات ç
|
المعتدل
|
الأولى
|
الثانية
|
الثالثة
|
الرابعة
|
ابن رشد
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
الكندي
|
1
|
2
|
4
|
8
|
16
|
انتقد ابن رشد طريقة الكندي انتقاداً شديداً بألفاظ جارحة؛ مثل قوله: اولجهل الحدث (أي: المبتدئ) من الأطباءب، وقوله: اوهذا كلّه تخبّط، والذي أوقعهم أولاً في هذا التخبّط هو الرجل المعروف بالكنديب، وقوله: اوهذا كلّه هذيان وخرافات، وتكلّم في أشياء ليس لها وجودب(56).
يقول الأهواني: اوعارض الكندي أطباء آخرون، أو معظم الأطباءب(57)، لكنه لم يأتِ بدليل غير نصوص ابن رشد، بينما الذي نراه هو أن ابن القف يعرض الرأيين من دون انحياز إلى أحدهما، بل يصرّح بحياده قائلاً: اوإظهار الحق في ذلك ليس هو للجرائحيب(58). والأطباء الآخرون لا يذكرون شيئاً عن الموضوع.
لكن الذي أظهره البحث الحديث هو أن كلاً من: فبر Weber، وفخنر Fechner، ظهرا في القرن التاسع عشر الميلادي بنظرية التناسب الهندسي بين المؤثر والإحساس؛ أي أن الكندي ظهر صواب رأيه بطريقة تجريبية في عصرنا الحديث على أيدي العالمين الألمانيين(59). ولا تزال نظرية الكندي موضوعاً للدراسات الحديثة؛ ففي عام 1999م قدّمت أطروحة دكتوراه في باريس عن رسالته(60)، مع أن نصّها منشور قبل الأطروحة بستين عاماً، ونصّ ابن رشد تمّت دراسته بالتفصيل في كتاب الأهواني قبل ثلاثين عاماً من الأطروحة. وفي عام 2003م ظهر بحث في لانجرمان حول الموضوع نفسه(61)، وفيه يعترض الباحث الإسرائيلي على ربط نظرية الكندي بنظرية التناسب الهندسي بين المؤثر والإحساس للعالمين الألمانيين السابق ذكرهما، قائلاً بعدم وجود علاقة بين المسألتين.
رسالتاه في السيوف وعلم المعادن Mineralogy
للكندي رسالتان ذكرهما مؤلف (الفهرست) حول السيوف: اكتاب رسالته في أنواع السيوف والحديد، وكتاب رسالته فيما يُطرح على الحديد والسيوف فلا تتثلم ولا تكلّب(62). وهما رسالتان فريدتان في موضوعهما؛ إذ لم نجد أحداً غير الكندي تطرّق إليه في تأليف مستقلّ. وعموماً، فإن المؤلفات التراثية في الصناعات نادرة، وتُعزى ندرتها إلى الأسباب الآتية:
- يجب ألا يغيب عن بالنا أن العصور التي نتحدث عنها كانت مختلفةً عن عصرنا، ومن ضمن هذه الاختلافات غياب المؤسسات العلمية التي تُعنى بالحرف والصناعات؛ فلم تكن هناك كليات تقنية، أو معاهد مهنية، ولا حتى كليات هندسة؛ فالتعليم في هذه المجالات كان يتم بين الحرفيين أنفسهم. والذين ألّفوا من المهندسين في مجال الآلات والصناعات هم من المتعلمين الذين كانوا مشغولين بعلوم أخرى كالفلك والرياضيات، وهؤلاء المتعلمون كانوا متّصلين بالطبقة الحاكمة، بينما كان الصنّاع من الطبقات الشعبية ذات المركز المنخفض؛ لذلك نجد فجوة بين المؤلفين والحرفيين، إلا في حقب زمنية محددة، وفي مدن معينة، مثل القاهرة في عهد المماليك.
- يتبع غياب المؤسسات التعليمية التأثير الاقتصادي لهذا الغياب؛ فالعلماء كانوا يتلقّون الدعم المادي والمرتبات من الحكام والأثرياء، ولم يكن هذا الدعم دائماً أو ثابتاً مثل ثبات الوظائف في عصرنا؛ لذلك لم تكن علوم التقنية متّصلةً على النحو الحالي؛ إذ نجد قروناً تمضي بين ظهور مهندس يؤلّف في الهندسة الميكانيكية مثلاً وآخر يتبعه ويكمل عمله؛ فهناك فترة ثلاثة قرون بين بني موسى والجزري مثلاً، ومرةً أخرى كان عصر المماليك (في القاهرة وبعض مدن الشام) استثناءً لهذه القاعدة؛ إذ كان المؤلفون في الصناعات والآلات متّصلين بالحرفيين من عامة الشعب، وكان التأليف في هذا المجال كثيراً.
- وتبع العامل الاقتصادي تقيّد المؤلفين برغبات مموّلي كتبهم؛ فألّفوا في المجالات التي تناسبهم(63)؛ فمثلاً: رسالتا السيوف اللتان نتحدث عنهما تم تأليفهما للمعتصم العباسي.
- كثير من الصناعات والآلات التي عرفتها عصور الحضارات السابقة، ومنها الحضارة العربية الإسلامية، لم يكن مخترعوها إلا من الحرفيين الماهرين من ذوي العقول المبدعة، لكنهم لم ينالوا حظاً من التعليم المدرسي ليؤلّفوا الكتب عن مخترعاتهم(64)؛ فصنّاع الأسلحة كانوا من الأميين؛ لذلك لم تكن تعنيهم كتب التصنيع والصناعة.
- كان صنّاع الآلات، والحرفيون في الصناعات عامةً، يحبّون الاحتفاظ بسرّ الصناعة داخل أُسرهم، فلا يصرّحون بها إلا لأبنائهم مثلاً، وهذا الأمر شبيه بما هو حاصل الآن في الصناعة الحديثة، مع اختلاف الحجم(65).
- لم تكن هناك وسائل متاحة لقياس كمياتٍ للخصائص الأساسية والتحكم فيها؛ (مثل قياس درجة الحرارة، ونسب التبريد، ودرجة تركيز الشوائب القليلة)؛ لذلك فإن التحكم كان يتم بالإحساس المهني، الذي كان يتولّد من الخبرة العملية بدلاً من الدراسة المنهجية.
- ضياع كثير من المؤلفات التراثية بسبب الكوارث المختلفة (حروب وفتن، وأرضة، وحريق، وغرق، وإهمال).
تقدّم الرسالة الأولى للكندي معلومات فريدة عن تصنيف السيوف حسب مصدرها، وطبيعة الحديد أو الفولاذ الذي صُنعت منه. ويبيّن المسح الشامل لهذه السيوف مجموعةً كبيرةً من المواد المستعملة في صنع النصال أو الأطراف الحادة (الحديد الصلب والرخو، والتركيبات الصفائحية التي تمّ تلحيمها على شكل تشكيلات فنية، وأنواع فولاذ البواتق)، وهي ضمن عدد مدهش من المصادر في غرب آسيا وجنوبها وفي أوروبا. وتشمل هذه المصادر اليمن وسريلانكا، اللتين لا نعدّهما في عصرنا الحاضر من مصدّري الكميات الكبيرة والأنواع الجيدة من الفولاذ.
ومن المفاجآت التي تظهرها نصوص الكتاب أن المعالجة بتفاوت الحرارة على أطراف النصال باستعمال الطين المقاوم للصهر (وهي التقنية التي زعم اليابانيون أنه لم يعرفها غيرهم في التاريخ) كانت معروفة جيداً عند حدّادي العصر العباسي، وظلّت طريقة المعالجة هذه مستعملةً في إيران وتركيا لعمل صلابة نصال الفولاذ البلوري المسمّى الدمشقي إلى القرن التاسع عشر الميلادي(66).
أما الرسالة الأخرى، التي عنوانها: (فيما يُطرح على الحديد والسيوف فلا تتثلم ولا تكلّ، فهي تدور حول العمليات الكيميائية عند صهر الحديد لجعل الفولاذ الناتج من ذلك أقوى ما يمكن، ويتطلّب تحقيقها الإحاطة بأساليب الكيمياء الصناعية ومصطلحاتها في التراث العربي.
وكلتا الرسالتين في حاجة إلى تحقيق جديد؛ فالرسالة الأولى بقيت منها ثلاث نسخ في العالم، وقد نُشرت بتحقيق عبدالرحمن زكي عام 1952م اعتماداً على نسختي: ليدن (هولندا)، وإسطنبول(67)، لكن ذلك تم بدمج نصوص مخطوطتي ليدن وإسطنبول، واختيار قراءات النصوص التي يراها المحقّق مناسبةً؛ لذلك فإن المحقّق أخرج نصاً جديداً لا يمثّل نصّ مخطوطة ليدن، ولا نصّ مخطوطة إسطنبول، وأصول التحقيق تتطلّب اختيار نسخة واحدة تعدّ النسخة الأم، ثم مقارنة النصوص، وإبداء التسويغ عند تفضيل لفظة أو عبارة على الأخرى. وتمّ نشر الرسالة نفسها مع ترجمة إنجليزية ودراسة عن عمليات تصنيع المعادن عند العرب(68)، وقد اعتمد المحقّق والمترجم هويلاند على مخطوطة ليدن لتكون أساسية لترجمته، لكنه يقارن نصّها بنشرة زكي ومخطوطة إسطنبول، لكنه لم يستعمل مخطوطة تورين؛ لأنه علم بها عند طبع كتابه؛ لذلك فالنص في حاجة إلى تحقيق جديد.
أما الرسالة الثانية، فقد نُشرت في بغداد عام 1962م اعتماداً على نسخة واحدة، مع أن نسخها كثيرة في العالم، وهي طبعة خالية من شرح الكلمات ومتطلبات التحقيق الأخرى. وقد تحدث هويلاند مطوّلاً عن نصّ الرسالة الثانية هذه، وأن هذا النصّ موجود في مخطوطتين: إحداهما في تورين بإيطاليا، والأخرى في مكتبة جستر بيتي في دبلن (إيرلندا)، ولم يتطرق إلى طبعة بغداد إطلاقاً.
تلوّث الهواء
كان من جملة ما اهتم به العلماء العرب والمسلمون في عصر التقدّم العلمي لحضارة بلاد الإسلام تأثير التلوث في صحة البشر، وكونه سبباً في إحداث الأمراض والأوبئة؛ فنجد في تراثنا العلمي أن موضوع حماية البيئة تم بحثه في نوعين رئيسين من المؤلفات، ينقسم كلّ واحد منهما إلى فروع أصغر، وهما: كتب التشريعات الفقهية التي من ضمنها كتب الحِسْبة وكتب فقه البنيان، والكتب العلمية التي منها كتب الطب(69). ومرةً أخرى نجد عالمنا الكندي رائداً في هذا المجال؛ فمن مؤلفاته: رسالة في إيضاح العلة في السمائم القاتلة السمائية، وهو على القول المطلق: الوباء، ورسالة في الأدوية المشفية من الروائح المؤذية، ورسالة في الأبخرة المصلحة للجو من الأوباء(70). وكلها مفقودة، لكن التميمي (تُوفِّي نحو سنة 390هـ/ 1000م) يقتبس من الرسالة الأخيرة في سبع صفحات(71)، واقتباساته هي وصفات لأنواع من البخور الطارد للملوثات والحشرات الضارة، يقول التميمي: اوهذه صفات دخن استخرجتها من رسالة ليعقوب بن إسحاق الكندي إلى أحمد بن المعتصم في أعمال الأبخرة المصلحة لفساد الهواءب(72)، ويقول في موضعٍ آخر: اوهذا نعت دخنة مركّبة من ثمانية أخلاط من مركّبات الكندي، ذكر أنها دافعة لضرر فساد الهواء الذي فساده بالعفن الشديد الحرافة والحدة؛ فإنها منقذة من أمراض الوباءب(73).
ويظهر من اقتباسات التميمي سعة معارف الكندي في مختلف العلوم، وخبرته في استعمال علوم مختلفة في آنٍ واحد، كما مرّ بنا في حالة الرياضيات والصيدلة؛ فهو هنا يختار أوقاتاً يكون فيها الهواء نشطاً؛ لينتشر البخور في المكان ليعطي تأثيراً أفضل. يقول التميمي: اقال الكندي: يُبخّر من هذه الدخنة عند طلوع الشمس، ووقت زوالها، وعند غروبها، وعند انتصاف الليل، وذلك لأجل حركة الهواء وسيلانه في هذه الأربعة أوقات؛ لكون الشمس في أربعة مراكز، وذلك أن حركة الهواء وسيلانه مما يعين على نجاح الدخن، ونفاذ فعلهاب(74). ثم يقول التميمي: اوذكر الكندي التدخين بالعنبر الشحري(75) بسيطاً ليس معه غيره، وأمر أن يُدخّن به في هذه الأوقات الأربعة التي ذكرها في الدخنة المتقدمةب(76).
لطف الله قاري
الطائف - السعودية
الطائف - السعودية
الهوامش والمراجع
(1) حقّق محمد عبدالهادي أبو ريدة سنة وفاة الكندي، وناقش الآراء التي تقترح تواريخ أخرى. انظر: محمد عبدالهادي أبو ريدة، رسائل الكندي الفلسفية، القاهرة: دار الفكر العربي، جزءان، 1950-1953م، ص5، 6.
(2) ذكر ابن أبي أصيبعة وغيره أكثر، لكن الأفضل هو الاعتماد على المراجع الحديثة التي تضيف عناوين مخطوطات تم اكتشافها ولم ترد في المصادر التراثية، وتبيّن أمكنة تلك المخطوطات، وما طُبع منها، مع ذكر أمكنة طباعتها وتواريخها، ويجد القارئ قائمةً بهذه المراجع الحديثة عن الكندي في آخر هذا المقال.
(3) هي التي عُرفت باسم (سيلان)، وتسمى الآن (سريلانكا).
(4) أي: أحجامها.
(5) أي: تقدير قيمته.
(6) (الجماهر) للبيروني، ص62، 63 من طبعة حيدر آباد (دائرة المعارف العثمانية، 1938م)، ص137 من طبعة طهران (دفتر ميراث مكتوب، 1995م).
(7) (الجماهر) للبيروني، ص31، 32 من طبعة حيدر آباد، ص103 من طبعة طهران.
(8) نُشر بتحقيق عبدالله الغنيم، في مجلة أو دورية (العرب)، السنة 36 (2001م)، الصفحات 146-154، ثم 216-224، ثم في كتابه (بحوث ومطالعات في التراث الجغرافي العربي)، الكويت، 2006م.
(9) بتحقيق يحيى وهيب الجبوري، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2005م.
(10) منجية عرفة منسية، «حول رسالة الكندي في الجواهر والأشباه»، ضمن كتاب (ثقافة العلم عند العرب قديماً وحاضراً.. فعاليات الملتقى التونسي- السوري، 2007م)، (تونس: المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكمة)، 2008م، الصفحات 127-176.
(11) محمد عيسى صالحية، «رسالة في قلع الآثار من الثياب وغيرها ليعقوب بن إسحاق الكندي، ت 260هـ»، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد 30 (1986م)، ج1، ص83-111، وانظر: ص92، 93. وأعاد نشر التحقيق مع الدراسة في كتابه (بحوث ومقالات في الحضارة العربية الإسلامية)، الكويت: مؤسسة دار الكتب، وبيروت: دار التقدّم العربي، 1988م، ص241-265.
(12) لطف الله قاري، “مؤلفات قلع الآثار في التراث”،
The 8th Islamic Manuscript Conference, The Islamic Manuscript Association, 9-11 July 2012, Camridge, UK.
وتم نشر البحث في المجلد السادس (2015م) من دورية Journal of Islamic Manuscripts.
(13) عن المؤلفات المبكرة للعطور انظر: مقدمة تحقيق كتاب (طيب العروس وريحان النفوس) للتميمي، تحقيق: لطف الله قاري، القاهرة: الهيئة العامة لدار الكتب، 2014م.
(14) أحمد فؤاد الأهواني (1908- 1970م): أستاذ الفلسفة وعلم النفس، ومؤرّخ العلوم.
(15) Garbers, Karl: Buch über die Chemie der Parfüms und die Distillationen, Leipzig : Deutsche Morgenlandische Gesellschaft
1948, الفقرة 33، ص 18 من النص العربي.
(16) يعقوب بن إسحاق الكندي، مخطوط كتاب الترفّق بالعطر (هكذا طُبع عنوان الكتاب)، تحقيق: سيف المريخي، قطر: وزارة الثقافة، 2010م، الفقرة 33، ص55. ونحن نستشهد بالطبعتين معاً؛ لأننا نجد في طبعة قطر كثيراً من التصحيف.
(17) ص20 طبعة ألمانيا، ص70 طبعة قطر.
(18) أحمد فؤاد الأهواني، الكندي فيلسوف العرب، سلسلة (أعلام العرب)، القاهرة: وزارة الثقافة، 1964م، ص221، 222.
(19) جابر الشكري، “كتاب كيمياء العطر والتصعيدات المنسوب للكندي”، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد 36، ج1، 1985م، الصفحات 113-150.
(20) رينهارت دوزي، تكملة المعاجم العربية، تعريب: محمد سليم النعيمي وجمال الخياط، بغداد: وزارة الثقافة والإعلام العراقية، 11 جزءاً، 1978-2002م، مادة (زور)، ج5، ص383، 384.
(21) محمد بن إسحاق النديم، الفهرست، تحقيق: A. Muller, J.Roediger, G.Flugel، طبع ليبسك عام 1871م، نُشر بالتصوير في بيروت وبغداد، 1964م، ص259. وطبع بتحقيق رضا تجدد، الطبعة الثانية، 1973م، طبع على نفقة شركة البترول الإيرانية بمطبعة مروى للأفست بطهران, ص318. وبتحقيق أيمن فؤاد سيد، لندن: مؤسسة الفرقان، 2009م، ج2، ص190.
(22) ابن بسام المحتسب، “نهاية الرتبة في طلب الحسبة»، تحقيق: حسام الدين السامرائي، مطبعة المعارف ببغداد، 1968م، وأعيد طبعه ضمن مجموعة مكوّنة من ثلاثة كتب في الحسبة بعنوان: (في التراث الاقتصادي الإسلامي) من دون ترخيص بعد حذف اسم الناشر الأصلي في بيروت عام 1990م، ص45، 46 طبعة بغداد، ص350، 351 طبعة بيروت.
(23) ابن بسام، المصدر السابق، ص92 طبعة بغداد، ص386 طبعة بيروت.
(24) لطف الله قاري، “مختصر كيمياء الأطعمة للكندي”، مجلة عالم المخطوطات والنوادر، المجلد 14، العدد الأول، المحرم- جمادى الآخرة 1430هـ/ يناير- يونيو 2009م، ص209-234، وأعيد نشره في كتاب (نصوص نادرة من التراث العلمي)، القاهرة: مكتبة الإمام البخاري، 2012م.
(25) ترجمته في الأعلام للزركلي (بيروت: دار العلم للملايين، 1980م)، ج8، ص161، 162. وانظر أيضاً: زهير حميدان، أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية، دمشق: وزارة الثقافة، 1995م، ج2، ص522-529.
(26) عبدالرحمن بن نصر الشيزري، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق: السيد الباز العريني، القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1946م، ثم طبعات مصوّرة من دون ترخيص بعد حذف اسم الناشر الأصلي في بيروت وغيرها، ص34، 35، 47.
(27) لطف الله قاري، “حول كتابي الشيزري وابن بسام: من منهما سبق الآخر؟”، مجلة عالم الكتب، المجلد 29، العددان 3 و4 (ذو القعدة- ذو الحجة 1428- المحرم- صفر 1429هـ، ديسمبر 2007- مارس 2008م)، ص361-366. وأعيد طبع البحث في كتاب (نصوص نادرة من التراث العلمي) للمؤلف، القاهرة: مكتبة الإمام البخاري، 2012م.
(28) فيما عدا ذكرها في القوائم الفهرسية (الببليوجرافية) عند كلّ من: أولمان، وسزكين. كتاب أولمان يأتي ذكره في حاشية آتية.
(29) يقصد الفهرس الذي نشره الأب بولس سباط عن مخطوطات المكتبات الخاصة في حلب في مطلع القرن العشرين، وكلها لم تعُد موجودةً، لا هي ولا مخطوطاتها، إلى درجة أن بعض الأصدقاء الحلبيين شكّك في وجود تلك المكتبات أصلاً بعد أن سأل مطوّلاً عن أصحابها من الأسر الحلبية التي ينتمون إليها.
(30) يقصد نسخة طهران الخطية من النص المنشور.
(31) ينقل كلامه هذا من أولمان:Ullmann, Manfred; Die Medizin im Islam, Leiden: Brill, 1970, s. 315.
(32) نشأت حمارنة، آراء ودراسات في تاريخ الطب العربي، دمشق: وزارة الصحة، 2004م، ج2، ص124.
(33) Bos, Gerrit and Charles Burnett. Scientific Weather Forecasting in the Middle Ages: The Writings of Al-Kindi: studies, editions, and translations of the Arabic, Hebrew, and Latin texts, London: Kegan Paul, 2000.
(34) Scofield, Bruce, A History and Test of Planetary Weather Forecasting, Doctoral Dissertation, University of Massachusetts, Amherst, 2010.
(35) يبدأ نصّ الكتاب بهذه العبارة: «كتاب يعقوب أبو (الصواب ابن) إسحاق الكندي إلى بعض إخوانه في مدخل إلى علم النجوم، وهو الكتاب المسمى: الأربعون باباً». وقد بقي من الأصل العربي نسخة واحدة في المكتبة الخالدية بالقدس. انظر: نظمي الجعبة، فهرس مخطوطات المكتبة الخالدية بالقدس، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 2006م، ص 806. وقد نُشرت عن الكتاب الدراسة الآتية اعتماداً على المخطوطة العربية الوحيدة وعلى ترجمتين لاتينيتين للكتاب:Burnett, Charles: Al-Kindī on Judicial Astrology: ‘the Forty Chapters’, Arabic Sciences and Philosophy, Volume 3, Issue 01, March 1993, pp 77-117. ثم نُشر الكتاب كاملاً بالإنجليزية فقط: Dykes, Benjamin: The Forty Chapters of al-Kindi, Minneapolis: The Cazimi Press, 2012.
(36) لا يعتمد الكندي هنا على التنجيم الخرافي، وإنما يتحدث عن مواقع الأبراج لكلّ فصل؛ فهذه المعلومات يتداولها المزارعون عن المواسم وعلاماتها النجمية.
(37) Rosenthal, Franz. “From Arabic Books and Manuscripts VI Istanbul Materials For Al-Kindi and As-Sarahsi.” In Journal of the American Oriental Society, vol. 76 , no. 1, pp. 27-31. American Oriental Society, 1956.
(38) الكندي، رسالة في حوادث الجو، تحقيق: يوسف يعقوب مسكوني، بغداد: مطبعة شفيق، 1965م.
(39) Bos and Burnett, op cit., pp. 423-428.
(40) أبو ريدة، المرجع السابق.
(41) محمد حسان الطيّان، علم الأصوات عند العرب، محاضرة أُلقيت في دورة (من روائع البيان القرآني) لمديري معاهد الأسد ومشرفاته في جامع العثمان بدمشق يوم 27 يوليو عام 2008م.
(42) الطيّان، المرجع السابق.
(43) محمد مراياتي، ومحمد حسان الطيّان، ويحيى مير علم، علم التعمية واستخراج المعمّى عند العرب، ج1-2، دمشق: مجمع اللغة العربية بدمشق، 1987-1997م.
(44) الطيّان، المرجع السابق.
(45) الطيّان، المرجع السابق. وقد درس رسالتي الكندي باحثون آخرون، نذكر هنا عيّنة من بحوثهم: فخري الدباغ، «اللثغة عند الكندي وفي ضوء العلم الحديث»، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد 31 (1980م)، الجزء 3، الصفحات 86-103؛ ويحيى مير علم، إسهامات علماء التعمية في اللسانيات العربية، محاضرة على هامش الاحتفال بإصدار سلسلة الترجمة الإنكليزية لكتاب (علم التعمية واستخراج المعمّى عند العرب) وتكريم المؤلّفين، الرياض، 2003م؛ ومصطفى حسين مزعل، «علم الأصوات عند الكندي في رسالتيه: اللثغة واستخراج المُعمَّى”، مجلة كلية التربية الأساسية (الجامعة المستنصرية ببغداد)، العدد 66 (2010م)، الصفحات 89-127؛ وأحمد غرس الله، “الجهود اللغوية للكندي في رسالتي اللثغة وحلّ المعمى في ضوء علم اللغة الحديث”، بحث بالجزائر لم يتسنَّ الاطلاع على مكان نشره وتفاصيل محتوياته.
(46) Celentano, Giuseppe: Due scritti medici di al-Kindî, Istituto Orientale di Napoli, Supplemento n.18 agli ANNALI, vol. 39 (1979), fasc. 1.
(47) محمد حسان الطيّان، “رسالة يعقوب الكندي في اللثغة”، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد 60 (1985م)، ج3، الصفحات 515- 532.
(48) يعقوب بن إسحاق الكندي، “في معرفة قوى الأدوية المركّبة”، نُشر النصّ بترجمة ودراسة بالفرنسية في بيروت عام 1938م في المرجع الآتي، ص1، 2:Gauthier, Léon; Antécédents gréco-arabes de la psychophysique, Beyrouth : Imprimerie Catholique, 1938.
(49) أبو الفرج بن يعقوب ابن القف، العمدة في صناعة الجراحة، ج1 (لم يصدر الجزء الثاني)، تحقيق: سامي حمارنة، عمّان: الجامعة الأردنية، 1994م، ص352. والطبعة الكاملة للكتاب، حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، 1356هـ/ 1937م، ج1، ص208.
(50) فربيون أو اليتوع: جنس من النباتات البرية والتزيينية من فصيلة الفربيونات، تبلغ أنواعه نحو 1600 نوع، والمقصود هنا هو النبات الذي له أسماء أخرى، أشهرها اللبانة المغربية والعنجد، واسمه العلميEuphorbia resinifera، وبالإنجليزية Euporbium gum plant. إدوار غالب، الموسوعة في علوم الطبيعة، بيروت: دار المشرق، 1989م، مادة (عنجد)، رقم 19164، ومادة (فربيون)، رقم 20557؛ وإبراهيم بن مراد، المصطلح الأعجمي في كتب الطب والصيدلة العربية، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1985م، مادة (فربيون)، رقم 1362.
(51) ابن القف، المصدر والصفحة السابقان.
(52) يحيى بن عيسى ابن جزلة، منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان، تحقيق: محمود مهدي بدوي، القاهرة: معهد المخطوطات العربية، 2010م، ص95.
(53) يونس بن إسحاق ابن بكلارش، “المستعيني في الأدوية المفردة»، نقلاً عن محمد العربي الخطابي، الأغذية والأدوية عند مؤلفي الغرب الإسلامي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1990م، ص307، 308.
(54) عبدالناصر كعدان؛ وياسر الخضر، “آلية تأثير الدواء في التراث الطبي في بلاد الشام: ابن القف وابن النفيس أنموذجاً”، بحث منشور في موقع الجمعية الدولية لتاريخ الطب الإسلامي www.ishim.net.
(55) الأهواني، كتابه عن الكندي، مصدر سابق، وقد تمّ تصحيح الجدول اعتماداً على نصّ ابن القف.
(56) ابن رشد، الكليات في الطب، تحقيق: محمد عابد الجابري وآخرين، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1999م، ص462، 463.
(57) الأهواني، المرجع السابق، ص231.
(58) ابن القف، المصدر السابق، صفحة 353 من طبعة عمّان.
(59) الأهواني، المرجع السابق، ص236. وهو ينقل نقلاً غير مباشر عن جوتييه Gauthier، الذي نشر رسالة الكندي في قوى الأدوية المفردة (سبق ذكرها) ودرسها. ولعدم اطّلاع الأهواني على تلك الرسالة المنشورة في بيروت عام 1938م نجده يقول في صفحة 231: «ورسالة الكندي عن الأدوية المركّبة مفقودة في اللغة العربية».
(60) Stephan, Nouha: Mathematique et pharmacologie dans l’oeuvre pharmaceutique du medecin-philosophe arabe al-Kindi; sous la dir. de Roshdi Rashed, 1999.
(61) Langermann, Y. Tzvi: “Another Andalusian Revolt? Ibn Rushd’s Critique of al-Kindi’s Pharmacological Computus”, in J. P. Hogendijk, A. I. Sabra; The Enterprise of Science in Islam: New Perspectives, (Cambridge: The MIT MIT - Massachusetts Institute of Technology Press, 2003), pp. 351-372.
(62) كتاب (الفهرست) للنديم، المصدر السابق، طبعة مؤسسة الفرقان في لندن بتحقيق: أيمن فؤاد سيد، 2009م، ج2، ص193.
(63) ALVI, M.A.and Abdul Rahman, Fat’ hullah SHIRAZI, A 16th Century Indian Scientist., Indian National Sciences Academy, New Delhi, 1968 ,PP.1-2.
(64) قدّم كاتب هذه السطور كثيراً من الأمثلة عن الآلات التي نجد وصفها في كتب التراث ولا نعلم مخترعيها، مع أن اختراعها تمّ في زمن قريب من تأليف الكتاب الذي يصفها. انظر: “الآلات الميكانيكية في تراثنا العلمي ومكانة الرسالة القدسية”، مجلة تاريخ العلوم العربية، نشر: جامعة حلب، المجلد 11، ص29-90. وأعدتُ نشره في كتابي (الإنجازات العلمية للعرب والمسلمين في القرون المتأخرة)، نشر: دار الفيصل بالرياض، والدار العربية للموسوعات ببيروت، 1427هـ/ 2006م.
(65) ونجد كذلك كثيراً من الأمثلة في بحث (الآلات الميكانيكية) السابق ذكره، ولم نجد داعياً إلى الإطالة هنا بتلك الأمثلة.
(66) Philip Tom, Book Review: Medieval Islamic Swords & Swordmaking, www.vikingsword.com, 10 November 2006.
(67) عبدالرحمن زكي، «السيوف وأجناسها: رسالة يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف العرب»، مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية، المجلد 14، العدد الثاني، 1952م، الصفحات: 1-36.
(68) Hoyland, Robert G. and Brian Gilmour: Medieval Islamic Swords & Swordmaking: Kindi’s Treatise “On Swords and Their Kinds” (edition, translation, and commentary), Oxford: The E. J. W. Gibb Memorial Trust, 2006.
(69) لطف الله قاري، «رسالتان في الجغرافيا الطبية وتأثير البيئة مع دراسة عن تراثنا العلمي حول الموضوع»، سلسلة (رسائل جغرافية)، العدد 305، رمضان 1426هـ/ أكتوبر 2005م، الجمعية الجغرافية الكويتية وقسم الجغرافيا في جامعة الكويت.
(70) ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق: عامر النجار، نشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 4 أجزاء، وجزءان للفهارس، 2001-2004م، ترجمة الكندي.
(71) محمد بن أحمد التميمي، مادة البقاء بإصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الوباء، تحرير: يحيى شعار، القاهرة: معهد المخطوطات العربية، 1999م، ص177-183.
(72) المصدر السابق، ص177.
(73) المصدر السابق، ص182.
(74) المصدر السابق، ص183.
(75) بلاد الشحر: هي منطقة الساحل الجنوبي للجزيرة العربية، اشتملت على سواحل حضرموت والمهرة وظفار. وحضرموت والمهرة من محافظات شرق دولة اليمن بعد الوحدة عام 1990م، وظفار هي المحافظة الغربية لدولة عُمان، وإليها ينسب العنبر الشحري واللبان الشحري.
(76) المصدر السابق، ص183.
مراجع عن الكندي
مراجع عن الكندي
تركيزنا هنا في المراجع التي قدّمت أوفى المعلومات عن الكندي ومؤلفاته، وتجاوزنا عن ذكر المصادر التراثية التي ترجمت له، مثل: الفهرست، وابن أبي أصيبعة؛ لأنها مذكورة بالتفصيل ضمن هذه المراجع، وترتيب المراجع هنا حسب تاريخ صدورها:
- محمد عبدالهادي أبو ريدة، رسائل الكندي الفلسفية، القاهرة: دار الفكر العربي، 1950-1953م، جزءان.
- عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، دمشق: الناشر هو المؤلف، 1957-1961م، ج13، ص244، 245.
- رتشرد يوسف مكارثي، التصانيف المنسوبة إلى فيلسوف العرب، بحث بمناسبة احتفالات بغداد والكندي، بغداد: وزارة الإرشاد، مطبعة العاني، 1962م.
- محمد كاظم الطريحي، الكندي فيلسوف العرب الأول: حياته، سيرته، آراؤه، وفلسفته، رسالته في دفع الأحزان، بغداد: مكتبة المعارف، 1962م.
- كوركيس عواد، يعقوب بن إسحاق الكندي: حياته وآثاره، سلسلة الثقافة الشعبية، رقم 50، بغداد: دار مطبعة التقدّم، 1962م.
- إسماعيل حقي الإزميرلي، فيلسوف العرب يعقوب بن إسحاق الكندي، نقله من اللغة التركية: عباس العزاوي، بغداد: مطبعة أسعد، 1963م.
- أحمد فؤاد الأهواني، الكندي فيلسوف العرب، سلسلة أعلام العرب، القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، 1964م.
- خير الدين الزركلي، الأعلام، التحرير الثالث، بيروت: دار العلم للملايين، 1980م، ج8، ص195.
- محمد عيسى صالحية، «رسالة في قلع الآثار من الثياب وغيرها ليعقوب بن إسحاق الكندي، ت260هـ»، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد30، 1986م، ج1، ص83-111، وأعاد نشر التحقيق مع الدراسة في كتابه: بحوث ومقالات في الحضارة العربية الإسلامية، الكويت: مؤسسة دار الكتب، وبيروت: دار التقدم العربي، 1988م، ص241-265. ويتضمن بحثه قائمةً بكتب الكندي المطبوعة.
- زهير حميدان، أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية، دمشق: وزارة الثقافة، 1995م، ج2، ص536-561.
- Rescher, Nicholas: Al-Kindī: an annotated bibliography, Pittsburgh: University of Pittsburg Press, 1964.
- J Jolivet, R Rashed: «al-Kindi», in Dictionary of Scientific Biography (New York 1970-1990). Vol. 15 (Suppl.) pp. 261-266.
- J Jolivet, R Rashed: «al-Kindi», in Encyclopedia of Islam (2nd edition), Leiden: Brill, 1962-2002, vol. 5, pp. 122-123.
- Felix Klein-Frank (2001) “Al-Kindi”. In Oliver Leaman & Hossein Nasr. “History of Islamic Philosophy”. London: Routledge.
- Peter Adamson (2005) ‘Al-Kindi’. In Peter Adamson & Richard C. Taylor (eds). “The Cambridge Companion to Arabic Philosophy”. Cambridge: Cambridge University Press.
- Peter Adamson (2006) Al-Kindi, New York: Oxford University Press.

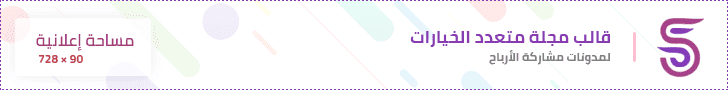
إرسال تعليق