قدّم على عزت بيجوفيتش الإسلام للعالم الغربي في كتابه "الإسلام بين الشرق والغرب" على أنه نظرة عالمية وطريقة للحياة تعلو على كل البدائل الفكرية والروحية وحتى الفلسفية والسياسية .
في المقدمة يحاول بيجوفيتش الإجابة على سؤال، ما هو موقف الإسلام من التصادم الأيدولوجي في العالم الحديث، موضحًا وجود ثلاث وجهات نظر متكاملة عن العالم يمكن إرجاع جميع الأيدولوجيات والفلسفات والتعاليم العقائدية منذ أقدم العصور إلى اليوم، نهائيًا إليها، وهي :
النظرة الدينية؛ يقصد مفهوم مصطلح الدين الأوروبي، أي تلك النظرة للدين باعتباره علاقة شخصية بين العبد وربه متمثلة في عقائد وشعارات يؤديها الفرد.
النظرة المادية؛ التي ترتكز فلسفتها على الوجود الطبيعي المادي .
النظرة الإسلامية؛ وتعني الوجود المتزامن للروح والمادة معًا، وعندها تظهر الصيغة السامية للإنسان، باعتبار أن هذه الازدواجية هي ألصق المشاعر بالإنسان لأنها دليله لفهم الحياة الواقعية .
النظرة المادية؛ التي ترتكز فلسفتها على الوجود الطبيعي المادي .
النظرة الإسلامية؛ وتعني الوجود المتزامن للروح والمادة معًا، وعندها تظهر الصيغة السامية للإنسان، باعتبار أن هذه الازدواجية هي ألصق المشاعر بالإنسان لأنها دليله لفهم الحياة الواقعية .
يتناول بيجوفيتش موقع الإسلام في إطار الفكر العالمي .بدأها من دحض نظرية اختلاف الرأسمالية والماركسية، لاعتقاده أنهما نموذجان لفكرة واحدة تقوم على جانب واحد من الحياة، تنكر أشياء وترفضها فكرًا ولا تستطيع التخلي عنها في أرض الواقع؛ مثلًا رفضت الماركسية الأسرة والدولة، ومن الناحية العملية احتفظت بهاتين المؤسستين.
يقسم القسم الأول من الكتاب إلى ستة فصول، دارت جميعها على إثبات معنى الإنسان كمدخل رئيس للفهم العام، فبإثبات أن الإنسان كائن مزدوج التكوين (روحي-مادي) نستطيع شرح وفهم الكثير من مفاهيم الحياة .
يحمل الفصل الأول عنوان الخلق والتطور، وفيه تفكيك تحليلي لنظرية التطور الدارونية التي تركز على النمو المادي للحياة من البدائية وصولًا لأعلى مراتبها؛ الإنسان.
دحض بيجوفيتش النظرية بمقارنة السلوك الاعتقادي للإنسان البدائي بأعلى المراتب الحيوانية ليصل لعدم وجود أدنى مشترك بينها في الروابط الإدراكية للوعي وليس الذكاء التنظيمي السلوكي أو حتى المشاعر، مستندًا إلى صورة الإنسان الموجودة في مخيلة الثقافة والفنون الإنسانية القديمة، وذلك بعكس رسومات مايكل أنجلو التي تعكس تشبث الإنسان بشئ آخر خارج عالمه المادي. في ذات الفصل عقد مقارنات بين سلوك الإنسان والحيوان؛ مثال تمرد الإنسان ونوعية اللعب المختار له والذي فيه بُعد روحي وليس احتياج بيولوجي كما هو الحال في الحيوان، والحاجة الى التجميل وغيرها.
بحث أيضًا في مفهوم الحياة التي أوجدت شكلًا منتظمًا ملايين المرات خلال بلايين السنين، حيث لا يمكن تفسيرها بواسطة علم الطبيعة أو الكيمياء؛ فداروين لم يجعل الإنسان حيوانًا ولكنه ربطه أكثر بأصله الحيواني وعليه تم بناء العالم المادي في شكل المجتمع الإنساني كقطيع في شكل متحضر، وإن الحضارة هي يقظة الإنسان التي تنطلق مصحوبة بالانعدام الروحي .
من النقطة السابقة ندخل إلى الفصل الثاني الذي بين فيه مفهوم الحضارة والثقافة؛ فالثقافة هي تأثير الدين على الإنسان وتأثير الإنسان على الإنسان، وهي تُنور العقل وتحتاج إلى تأمل لا تعلّم، بعكس الحضارة التي هي عبارة عن تأثير العقل على الطبيعة، وتتعلق باستمرارية التقدم للعلوم والتقنية. الثقافة تعكس الجانب الروحي للإنسان في إنتاجها وفي الهروب إليها وذلك بحب الناس عمومًا وتعلقهم بصورة الإنسان الموجود في الأدب والشعر والفن والمشاعر المنبعثة عبر الزمن من دوستوفيسكي وتولستوي. في ختام الفصل يؤكد أن نقد الحضارة ليس بهدف الرفض وإنما تحطيم الأسطورة المحيطة بها من أجل المزيد من الأنسنة في هذا العالم.
تركز الفصل الثالث حول الفن وعلاقته بالعلم، أي العالم المادي، وعلاقته بالدِّين أي الجانب الروحي؛ حيث أن الفن بالضرورة ليس عملًا كميًا يسعى لاستخدام القوانين بعد اكتشافها كما هي نظرة نيوتن وأينشتاين، وإنما هو انعكاس للنظام الكوني الكبير برؤية كيفية، لذا كان الفن دائمًا هو الأقرب للإنسان الجواني لأنه يعكس شخصية الفنان الفردية في تناغم مع عالمه والذي يؤكد العلماء تفرده بالتركيب، فأصغر جزيئات الماء تحمل بصمتها الخاصة المختلفة عن شبيهاتها في الظاهر، كما هو حال اللوحات الأصلية والمزيفة التي لا يكون الفرق بينها في كمية الألوان والأبعاد وإنما في اللمسة الشخصية للفنان. يؤكد بيجوفيتش أن ركود الفن دليل على إلحاد الدولة، وضرب حصار ستالين للفنون كمثال.
أبدع بيجوفيتش في استعراض الداخل الشخصي لبعض السرد الموجود في روايات عالمية شهيرة وكيف أن انعكاس الشخصية ليست مطابقة للوجه الإنساني وإنما هي الرغبة المنعكسة على الوجه. كما أن المتلقي العادي للفن يكون منصفًا أكثر من الناقد لأنه يتناوله بحس ذوقي لا بحس علمي. ختامًا يربط النقاط بأن الفن في بحثه عمّا هو إنساني هو بحث عن الله .
في الفصل الرابع تناول بيجوفيتش الأخلاق، وفيه قال أن المنظومات الأخلاقية لا يمكن تولدها من العقل المادي لكونه عاجز عن إصدار حِكَم قِيمية عندما تكون القضية استحسان أو استهجان أخلاقي؛ فالجريمة عقليًا هي عبارة عن دوافع وأفكار، ومشاعريًا توصف بأنها شر أخلاقي، كما أن التضحية بالنفس من أجل الغير تكون ضد المصلحة الشخصية؛ لكنها مصلحة أخلاقية مطلقة.
في العالم المادي تقوم الأخلاق على مبدأ القوة أو المصلحة النفعية؛ ففي نموذج المصالح الجماعية عند النحل كمثال نجده غير أخلاقي في تعامله مع العاجز عن العمل الذي يتخلص منه بقسوة، أما الإنسان فإنه يحترم الصغير والمحتاج ويُنشئ دارًا للعجزة.
الثقافة والتاريخ هي محور الفصل الخامس، وفيه بعكس المفهوم المادي للتاريخ، الذي يصوره كالخط المستقيم باستثناء بعض الانتكاسات المؤقتة؛ فالمفهوم الثقافي للتاريخ والحاضر يكون العنصر الثابت الراسخ فيه هو الإنسان.
الفصل الأخير يتحدث عن الدراما والطوبيا، وفيه أن آلية الطوبيا كاملة لكنها غير إنسانية، لأن النظام والتماثل هما العنصران الأساسيان، أما الواقع فيشير إلى أن الدراما هي الأصل الإنساني لأن الحرية جوهرها والحريّة هي الإنسان، وطموحات الإنسان للحياة بمجتمع لا تنبع من وجوده الحقيقي وإنما من الضرورة .
خلاصة الجزء الأول؛ نصل إلى أن الإنسان مخلوق فريد وخاص ولكي تكتمل هذه الخصوصية لابد من الإيمان بالجزء الثاني من مكوناته وهو الروح وعندها لابد من الإيمان بوجود الله، لأن هذه هي اللحظة الفارقة في كون الإنسان إنسانًا.
القسم الثاني من الكتاب هو الإسلام: الوحدة ثنائية القطب
يعتقد بيجوفيتش أنك كي تفهم الإسلام فهمًا كاملاً؛ فلابد أن تكون لك معرفة بتاريخ المسيحية واليهودية .
الإسلام دين الإنسان؛ فكما جاء الإنسان بجانبين؛ روحي ومادي، جاء الإسلام دينيًا دنيويًا. في الإسلام تتجسد وحدة الروح والجسد في فكرة الأمة، وهي الوحدة بين الاتجاه الروحي والنظام الاجتماعي، فكما تخدم الشعائر التعبدية الروح، يمكن للنظام الاجتماعي بدوره أن يخدم المثل العليا للدين والأخلاق؛ فهو لا يحاول أن يجعل الناس ملائكة ولا عبيدًا لأجسادهم، وإنما يعمل على تهذيب غرائز الجسد بإعطائها بُعدًا وجدانيًا .
يرى بيجوفيتش أن الإسلام أصبح يحمل اسمه عندما انتقل من الغار إلى الواقع في مكة وبعدها إلى الاكتمال التأسيسي في المدينة؛ أي عندما أصبح منهجًا ومبدأ لتنظيم الكون أكثر منه حلاً جاهزًا .
يسرد الكاتب عددًا من الأمثلة لتوضيح ثنائية الإسلام التي جعلت منه منهجًا حياتيًا فطريًا متكاملًا؛ فمثلاً في أركان الإسلام نجد الثنائية الروحية والبعد الاجتماعي الأخلاقي في عدم تقبل المجاهرة بالمعاصي، بالإضافة إلى البعد الاجتماعي التكافلي، كما نجد ذات الثنائية في التاريخ الإسلامي وذلك بخلود أسماء مثلت شخصيات قوية وأفكار كبرى ومُثل عليا وكان هذا دليل على الوعي الإنساني بالقيمة الأخلاقية إلى جانب التقدم المادي .
أفرد بيجوفيتش مساحة لتوضيح النظام القانوني باعتباره مصلحة إنسانية وكيفية تحقيقها في الإسلام وذلك باحترام الحرية الشخصية ومن بعدها الأثر الأخلاقي في الحفاظ على المجتمع المسلم.
في ختام الكتاب تكلم عن الواقع وعن بعد المسلمين عن الفكرة الصحيحة وركز على كون الإسلام دين يستحيل تطبيقه تطبيقًا صحيحًا في مجتمع متخلف؛ ففي اللحظة التي يتم فيها التطبيق الحقيقي للإسلام في مجتمع ما يكون قد انتقل إلى قمة الحضارة الإنسانية .
أرجعنا بيجوفيتش إلى الفكرة النهائية العليا للإسلام وهي التسليم بالقدر، وهو لحظة تنقدح فيها شرارة وعي باطني من قوة نفسية مشبعة بالإيمان، مستعدة لمواجهة كل ما يأتي به الوجود ممثلاً في الأقدار الحتمية والسنن الكونية، مستسلمة لها نهايةً بعد بذل كل الجهد المتاح من غير خنوع ولا عجز .

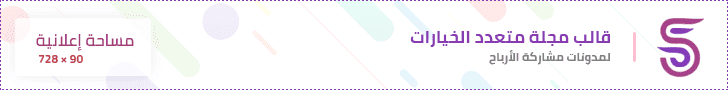

إرسال تعليق